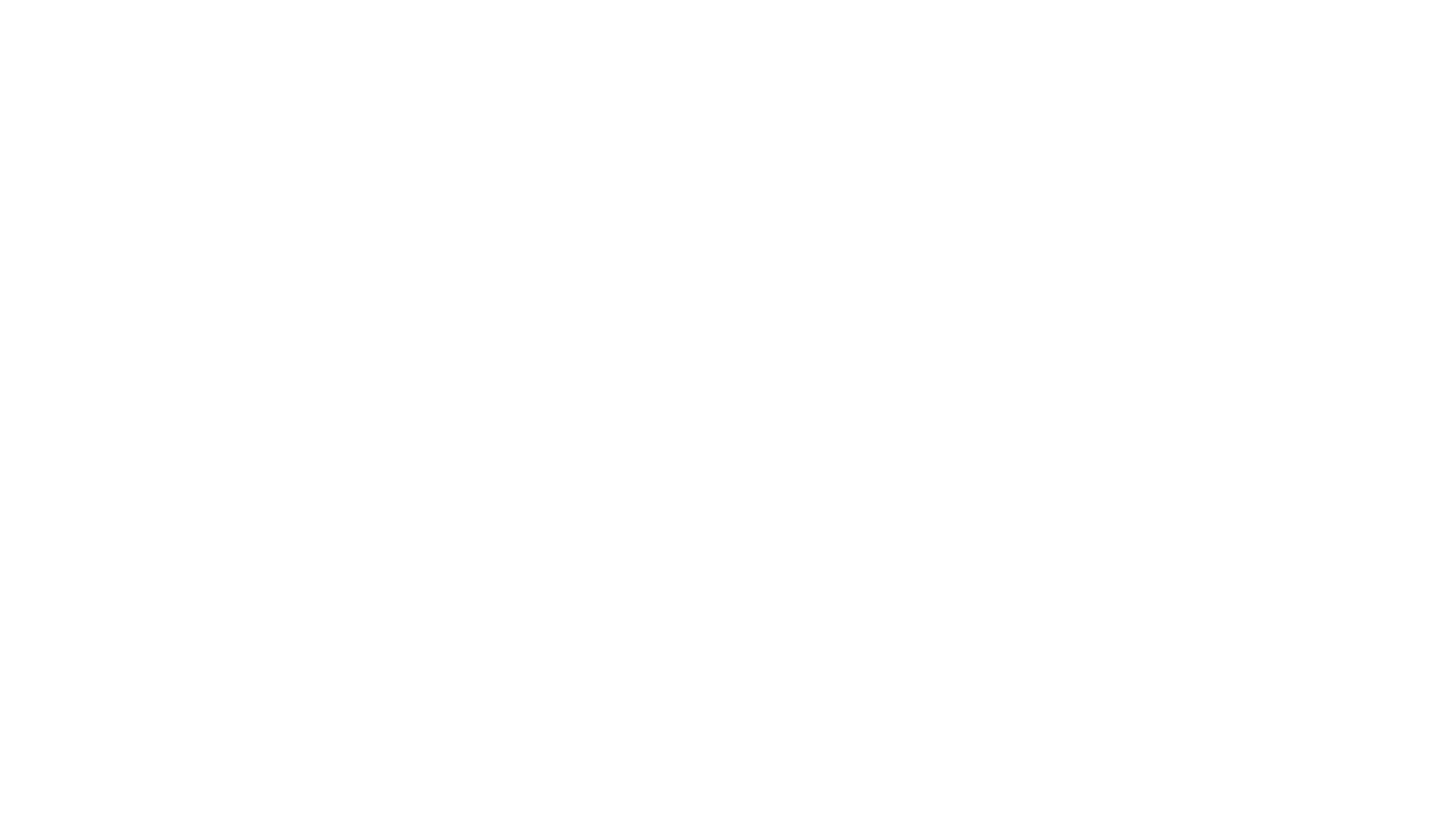طفلتي الصغيرة التي لما تزل غضة العمر تحب الطبيعة وتعشق الطيور والحيوان. اشتريت لها – عندما رغبت – زوجا من أسماك الزينة ذوي لون برتقالي يميل إلى الحمرة الدافقة بالحياة، يسبحان في إناء زجاجي شفاف قد غطى الماء ثلثيه، يغوصان حينا إلى أعماق الماء القريبة، أو يحطان حينا على الحصى البهيج المتعدد الألوان، يمطان من فيهما قليلا بحثا عن غذاء بين تلك الحصيات.
أحبت ابنتي أنيستيها حبا جما، واعتادت أن تقف والإناء بين يديها، تديم النظر إلى حركة الحياة في إنائها الصغير. ولم تنس يوما أن تذكر أحدنا: أمها أو أنا قبل أن تغادر البيت إلى مدرستها صباحا بهاتين الأنيستين وبطعامهما اليومي وتجديد ماء الحياة لهما.
ذات صباح اكتشفت أن واحدة من السمكتين الصغيرتين ليس بها حراك. فحسبت أنها تدقق البحث بين الحصيات عن الطعام. ولكن خاب ظني من أسف، إذ قد أصابها الموت بدائه. وظننت أن هذا موقف جديد ومنظر فريد يهم ابنتي أن تراه. فناديتها، وأنا أغيّر الماء للصغيرة الوحيدة الباقية، وقد نحيت الأخري التي فارقتها الحياة جانبا. وجاءت ابنتي مهرولة وهي لم تدر ماذا أخبي لها. ورأت الواقع بعينيها، فوجمت لحظة، وجمد بصرها على السمكة الصغيرة الساكنة. ثم سرعان ما ألقت الاتهام علي قائلة:
– أنت قتلتها !
فقلت لها:
- لا والله. لقد وجدتها هكذا ..
ولم تعقب ابنتي بشيء، ولكنها غادرت المكان ودخلت حجرتها وأوصدت الباب خلفها. وهذا هو دأبها إذا كانت غضبي. فقلت في نفسي: إنها دقائق وسوف أصحبها إلى المدرسة، وكعادتنا في الطريق نتحادث حديثا وديا وسأجلي لها الأمر على قدر فهمها.
دخلت حجرتها ظانا أنني سأجدها على الأرض جالسة، تداعب دمياتها أو تلعب بما لديها من لعب، كما كنت أجدها دوما تفعل ذلك وهي تقضي الوقت قبيل موعد المدرسة. بيد أنني وجدتها وقد دفنت رأسها بين راحتيها الصغيرتين وانحنت على سريرها غارقة في بكاء حار، ليس كبكاء الأطفال من أترابها، أو كبكائها هي عندما تريد أن ترغمنا على أن نقضي لها حاجة أو نلبي لها مطلبا. وإنما هو بكاء كبكاء الكبار الذين قد احترقت قلوبهم بألم مر. وحاولت أن أهدئ من روعها وأخفف من بكائها، إلا أنني لم أفلح. فهي لا تبكي من أجل نوال شيء، فينتهي البكاء بوعد مني، وإن كان غير صادق أحيانا، ولكنها تنتحب لأنها حزينة حقا أن واحدة من أنيستيها قد فارقتها. وأسديت لها وعدا بأنني سأشتري لها أخرى أكبر وأجمل ذات ألوان زاهية. ويبدو أن إغرائي لم يجد له صدى. لكنها ارتمت إلى صدري وقد خنقها النشيج.
هكذا أدركت ابنتي معنى الموت. لقد شاهدته بعينيها وقد سلب سمكتها الصغيرة الحراك. فلم تعد تسبح أو تغوص أو تطفو أو تداعب شقيقتها الأخرى. وبعد أن كانت صغيرتها تعيش في الماء في إنائها الأبيض الجميل. أصبحت لا يناسبها هذا الإناء ولا هذا الماء. وإنما مكانها الأن – كما أخبرت ابنتي – أن نلفها في كيس صغير ونلقيها في صندوق النفايات، إذ إنها سوف تزكم أنوفنا برائحة كريهة لو بقيت مع شقيقتها الأخرى جنبا إلى جنب في الماء.
هكذا عرفت طفلتي مصيبة الموت عندما فارقتها سمكتها الصغيرة، ولذلك بكت ولذلك كان بكاؤها حارا، فهو بكاء حزن وأسى، وليس بكاء من أجل مطلب.
لقد أتت تجربتك مع الموت يابنيتي جد مبكرة ! ومن قبل كان لأبيك تجربة أخرى معه. رآه بيد أنه لم يدركه، وأدركته أنت رغم أنه كان يكبرك بأربع سنوات عندما سعى إلى بيتهم سعي لص يتحسس الخطر خوف أن يفضحه ضوء أو عين.
كان أبوك طفلا طريا قلبه ككل الأطفال في سنه، يروح ويغدو في بيتهم أو خارجه مع أنداده. وفي ذلك اليوم كان أبوك يلعب في البيت، فهو في عطلة الصيف بعد أن انتهي من دروس السنة الرابعة الابتدائية ذلك العام. وكان جد سعيد بالعطلة بعد أن مر العام الدراسي ومر معه درس قاس لم يعرفه من قبل. ذلك أنه قد غاب بعد موعد المدرسة عن البيت مدة لم يذكر إن كانت طويلة حقا أو قصيرة، لكنها كانت طويلة في عرف أبيه. وعاد أبوك إلى البيت طفلا لا يدري ماذا سيجد في انتظاره. وتلقاه جدك، سأله، وتكلم إليه قليلا، لكنه لم ينتظر منه ردا. وعاجلة بضرب قاس على ظهره بعصا سوداء مازال كرهها – كلما رأى مثلها – كمين قلبه.
كان أبوك في ذلك اليوم إذن سعيدا لأنه يلعب في البيت، ولن يضطر إلى الذهاب إلى المدرسة فيغريه أترابه باللعب فيغيب عن البيت فيلتهب ظهره بلسعات العصا المقيتة مرة أخري.
وطرقت الباب زائرة. كانت سيدة سمراء ضخمة الجسد ملفوفة في لباس أسود متلفعة بخمار أسود كذلك. وتحدثت إلى جدتك حديثا سريعا، وفي عينيها قلق، بل أسى لاح منهما كلما نظرت إلى جدتك وهي تكلمها. وجرت جدتك على إثر الحديث إلى الدور العلوي، وجرجت ثوبا من ثيابها، وجرجرت في يدها الأخري ذراع أبيك. واستسلم أبوك ليدها. وأحس بقلبه مرارة شديدة، وامتلكه خوف رهيب.
هناك في مستشفى المدينة الكبير ذي الرائحة المقيتة إلى نفس أبيك: رائحة الدواء والدم والقطن والمرض، رقد أبوه على سرير صغير، وقد شدت ذراعه إلى حلقة مدلاة.
كان صامتا، كان ساكنا، كان طيبا، تلوح على وجهة سيماء أبوة حنون. فتح عينية مرة واحدة ونظر إلى جدتك ولمح أباك وإخوته ثم أغلقهما. ولم يجده أبوك قد فتحهما بعد تلك المرة أو بعد ذلك اليوم أبدا.
حملتنا سيارة إلى البيت. وعاد أبوك إلى بيتهم. امتلأ البيت واكتظ بنسوة الحارة. كلهن يلبسن لونا واحدا هو السواد. وكلهن قد اكتسين وجوها جامدة. جلس أبوك على عتبة البيت، لا يلعب، ولكنه منكس الرأس، ولا يدري لماذا. ورفع رأسه مرة فوجد جارتهم تنظر إليه نظرة لم يدر معناها إلا عندما اقترب من العشرين.
وكما اكتظ البيت بالنسوة اكتظت أرجاؤه بالبكاء والصراخ والعويل والنشيج. واختلطت جميعا لتنشئ إيقاعا رتيبا كئيبا. ودخل رجال وخرج رجال. وجاء جدك إلى البيت. جاء هذه المرة هادئا كعادته، لكنة لم يفتح الباب بنفسه، بل فتحه رجال آخرون. ولم يأت كعادته بمفرده، بل سبقة رجال، وأعلن قدومه بكاء. جاء ولكنه لم يكن يترجل أو يركب سيارته، بل كان محمولا، وكان مستسلما لمن حملوه، هادئا، مسبل العينين. ولم يصعد إلى حجرته في الدور العلوي. فهو لم يعد يريد أن يصعد، بل لم يعد يريد شيئا. أرادوا له أن يمكث في الدور الأرضي فمكث. لم ينبس بكلمة ولم يشر بحركة. ولم يجلس كعادته على واحدة من تلك الأرائك الموجودة في الدور الأرضي. بل نام على منضدة طويلة.
أهكذا أنت متعب؟ لم يخلع ملابسه بل نام فيها، ولكن كيف يخلعها وهو قد أرهقه التعب، فتترك رجالا يأخذون بساعده ويخلعون عنه ملابسه.
وأحس أبوك يابنيتي بيد غليظة تشده خارج الحجرة حيث يرقد جدك ممددا، هادئا، ساكنا، وديعا. وتألم أبوك؟ فلو كان جدك متيقظا، لو لم يكن متعبا، لما شدته تلك اليد الغليظة وجذبته إلى الخارج مثل هذا الشد والجذب. لو لم يكن جدك متعبا نائما لكان أبوك الآن في حضنه وإلى صدره مرتميا.
لا أريدك يا أبي أن تنام طويلا، أو أن تكون متعبا. أريد أن أضع راحتي الصغيرة في كفك الدافئ . . . لا تنم يا أبي طويلا. قم بالله عليك ورد عني هؤلإء الرجال الغلاظ الشداد. قم بالله عليك، لا تكن هادئا . . . انهرني بصوتك فأنا أريده أن يرن في أذني، اضربني حتى بعصاك فأنا أحب يدك وهي ترفعها، لا أحبها ساكنة إلى جوار جنبك . . . قم يا أبي وادفع عني . . .
ولم يقم جدك ! ألم يسمع؟ لعله سمع لكنة متعب، ومرت ساعة أو نحوها. وفجأة تغير الإيقاع الرتيب. وعلا النواح، وغصت الحلوق بحشرجة، وهبت النسوة. وخرج جدك يا بنيتي من الحجرة التي أرادوه أن يقضي فيها وقتا. خرج لكنه هذه المرة كان ملفوفا في ثياب بيض. لماذا غطوه هكذا ؟ لماذا غطوا وجهه، عينيه، أنفه؟
أتراك تحب أن تكون هكذا مغطى يا أبي؟ أتراك لا تحب أن نرى وجهك الطيب الوادع؟ أتراك لا ترغب في أن تنظر إلينا نظرة واحدة قبل أن ترحل كما عودتنا؟ لماذا تركت هؤلاء الرجال يغطون وجهك؟ لماذا تركتهم يلفونك بهذه الثياب البيض؟ لماذا تركتهم يضعونك هكذا في صندوق؟ أو قد عزمت على مغادرتنا يا أبي؟ لابد أنك ستعود. متى ستعود يا أبانا؟ إن قلبك الحنون لا يدعك تتركنا هكذا وتغادر! أو قد عزمت على الرحيل؟ إذن دعنا نحن نودعك، نسلم عليك، نقبل يديك، دع أمي شريكتك تقبل جبينك. رد هؤلاء الرجال عنها. إنهم يدفعونها دفعا بعيدا عنك. أوتدري أنها اليوم متهالكة ! لماذا تتركهم يحولون بينها وبينك؟ رد هؤلاء الرجال الذين لا يريدوننا أن نقترب منك، ننظر إليك.
وهكذا خرج جدك يابنيتي … وهناك في أقصى أطراف المدينة رقد وسكن. ليس على مرقد وثير كمرقده في بيتنا، بل على التراب. ليس بين زوجه وبنيه، بل وحيدا. ليس خلف باب يفتحه وقتما يريد، بل خلف صخرة كبيرة لا تلين لأدمي. وحيدا وحيدا بين تراب وظلمة ووحشة ما أقساها.
ماذا نفعل له؟ كيف نخلصه؟ لقد علمنا يا بنيتي قبل أن يموت – وكنا نراه دوما يفعل – أن نقرأ القرآن، وأن ندعو به لموتانا.
وهكذا يا أبي أصبحت واحدا منهم ندعو لك بالقرآن، بعد أن كنت واحدا منا تدعو معنا به لمن سبقنا إلى الموت.
وهكذا يا بنيتي عليك أن تفعلي يوما ما لأبيك مثلما فعل هو لأبيه، بأن تقرئي له قسطا من القرآن وأن تسدي له خالص الدعاء ..