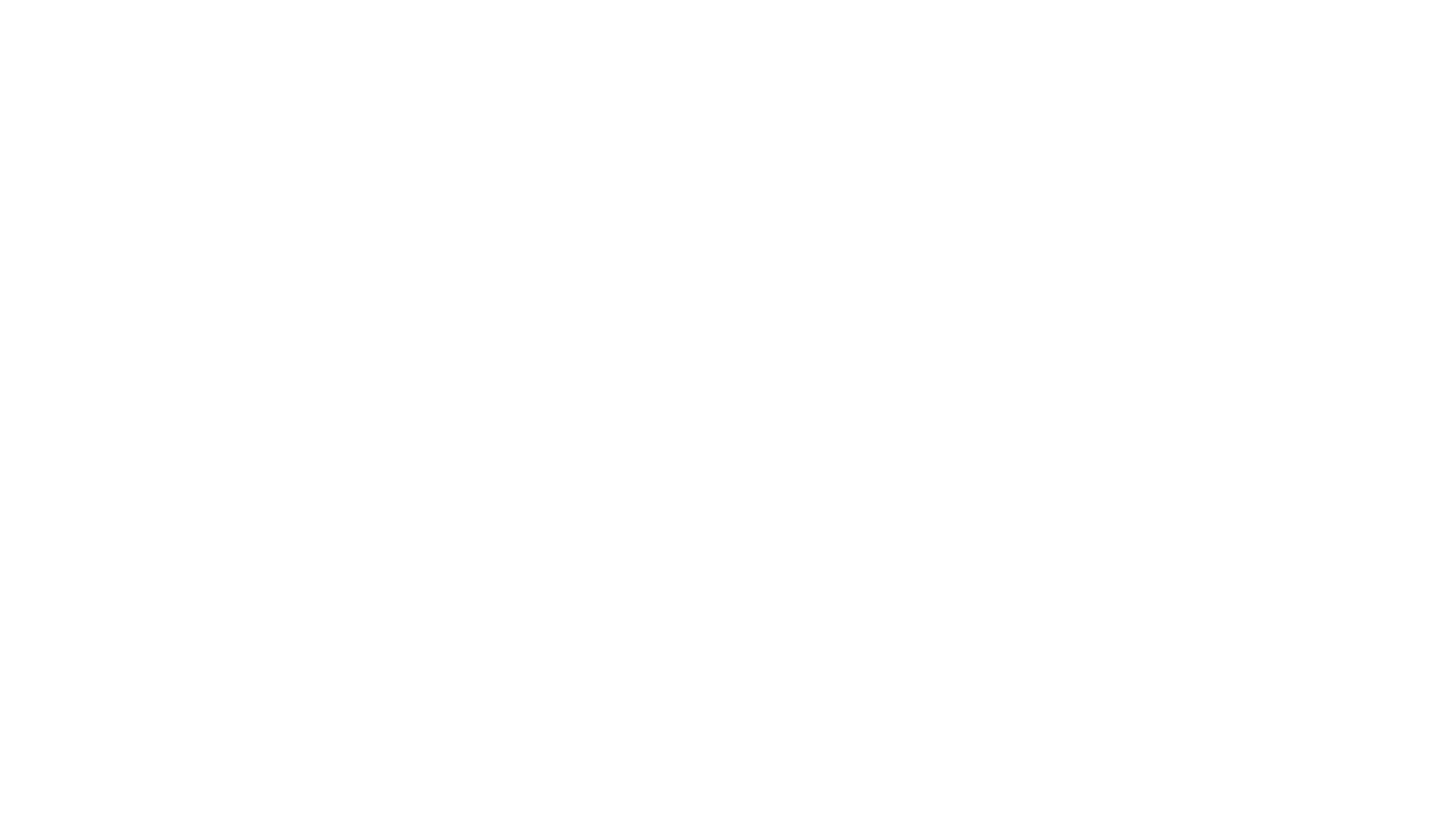ساعة الحائط توقفت عقاربها. أنا أعرف أن الزمن لا يمكن أن يتوقف. لعله شريان الحياة فيها، البطارية، نفدت فيها الطاقة. وتناولت الساعة بعد أن أحضرت بطارية جديدة. واستبدلت بالقديمة الخواء بطارية شابة مفعمة بالطاقة.
ولما وضعتها في مكانها من الساعة، دبت حركة جنونية في عقارب الساعة، وأخذت تجري بسرعة رهيبة، وكأنها تلهث.
أرعبني مرآها وهي تكاد يسابق كل منها الآخر، وكأنه يفر من مصير محتوم.
فهذا هو اليوم الذي يجب أن أزورها فيه. كلنا، أبناءً وأحفادًا، تركناها تعيش في صحبة من أترابها سنا، في دار للرعاية. وقليلا ما نزورها. صحيح أننا نطمئن عليها، بين وقت وآخر إما برسالة على هاتفها المحمول، وإما بمحادثة مقتضبة قد لا تستغرق دقيقتين. لكنني دون أخواتي وإخواني أواظب على زيارتها، لأجلس معها ونتذكر أيام زمان.
بالرغم من كبر سنها، فمازالت – بفضل الله – سليمة التفكير ومتقدة الذاكرة، خاصة ما عاصرته في القرن الماضي. وكلنا حمدنا الله تعالى أن الوباء لم يهاجمها. بل زادها شغفا وتعلقا بسماع أخباره، وما يقوله العلماء عنه، وما يحكيه الناس الذين اكتووا بناره.
إنها فعلا امرأة عجيبة، أو ربما أقول كانت عجيبة.
كانت تجتذب من حولها إلى الاستماع إلى حديثها، بل أحاديثها، إذا تكلمت. كانت فريدة بين بنات جيلها، تخرجت في مدارس إنجليزية، تعلمت فيها غير لغة، وكانت تتحدث بسبعة ألسن، كما يقولون. وتجيد النطق في معظمها بلا لكنة، وإن شابتها لكنة فهي محببة للأذن.
وتعلمت من الإنجليز حب القراءة، فاتسعت دوائر ثقافتها. كنا – نحن أبناءها – نجالسها ساعات طويلة نستمع في استمتاع إلى حكاياتها. من الشرق حكاية، ومن الغرب حكاية. تطوف بنا هنا وهناك.
وذاع صيتها في شارعنا، فأخذ الجيران يتوافدون يوما بعد يوم ليستمعوا إلى أحاديثها. وكان بعضهم، ممن لا يحسنون لغة أجنبية، أو لا يملكون وسيلة يتابعون عن طريقها الأخبار، يلجأ إليها أحيانا لتروي لهم آخر الأخبار في العالم.
وما كنا أبدا نضيق بجموع الناس، بل نسعد بهم.
وبعد سنوات وسنوات، بدأت أعداد الوافدين على بيتنا تتضاءل. لكنها لم تألم لذلك وواصلت معنا، نحن دائرتها المقربة، من الأبناء والأحفاد، جلساتها ولمست من بعضنا تشجيعا. نعم بعضنا، فقد كبرنا، وترك بعضنا البيت، وتزوج بعضنا، وشب بعضنا وارتحلوا في طلب العلم، كما رحل بعضنا.
لكنا ظللنا أوفياء، نجتمع في هذا اليوم، مهما ابتعدنا، لنكون بجانبها في البيت قبل أن ننقلها إلى دار للرعاية عندما عجزنا نحن عن رعايتها، خاصة وأن أمراض الشيخوخة بدأت تتسلل إلى جسدها، الذي اعتلته ترهلات الزمن.
لكن الطامة الكبرى واتتها، واكتسحتنا نحن أيضا، عندما ظهرت أجهزة الهواتف التي يسمونها ذكية، وكأن بها عفاريت من الجن، والأجهزة الأخرى اللوحية. واستغنى الناس، خاصة شبابهم، بها عن جلساتها وحكاياتها وما ترويه من أخبار.
نظرت إلى الساعة وقد هدأ روع عقاربها واستقر بها المقام، كل في مكانه، يسير الهوينى أو يسير في عجلة، بحسب ما تراه أنت فيها. اليوم يكاد يتخلص من ساعاته الأخيرة. لابد أن أسرع قبل أن تقفل الدار أبوابها.
ووصلت بحمد الله تعالى إلى الدار. كان الباب مفتوحا، وهرولت إلى مكانها، فأنا أعرف غرفتها. كان السرير خاليا، تهب منه نسمات باردة.
وسارعت إلى مكتب الاستقبال. وسألت. وعرفت أنها نقلت إلى المستشفى.
وقالت لي موظفة الاستقبال: اطمئن، فهي وعكة بسيطة، لكنها كانت بحاجة إلى مساعدة حتى تتنفس بطريقة طبيعية.
سمعتها وأنا أتألم. ثم عقّبت: لا تنس يا سيدي أنها في الثانية والثمانين.
فتمتمت في نفسي، أعلم ذلك، ولا أريد أحدا ينبهني إلى ذلك. أنا ابنها
بهية بهاء سعيد
كل عام وأنت بخير،
فاليوم ٣ يناير،
وعام سعيد، عن بعد.
مرتبط
اكتشاف المزيد من أَسْرُ الْكلام
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.