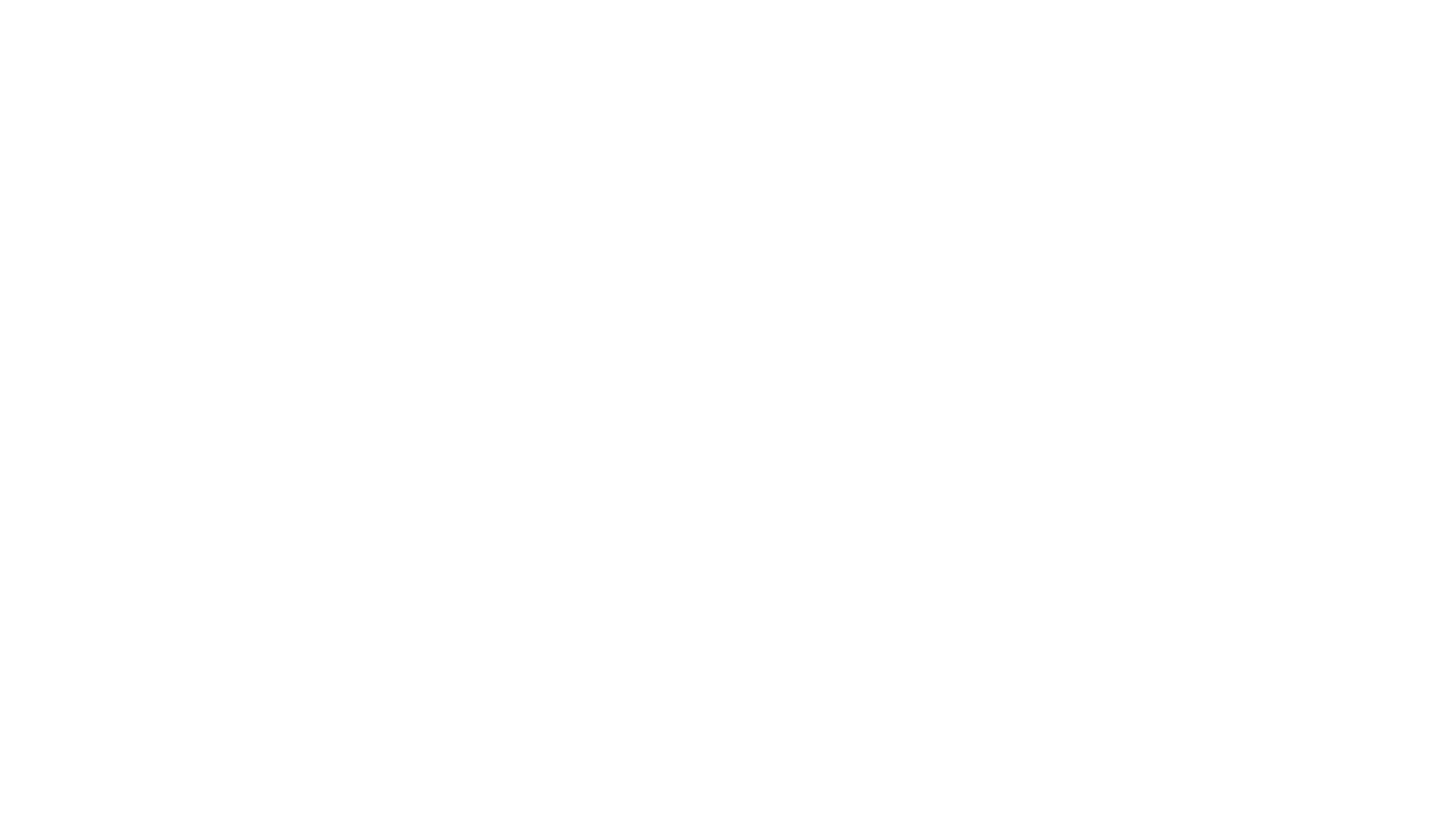الاثنين ٨ رمضان ٢٠١٦
رمضان والتدبر
مع بدء شهر رمضان يتغير نظام حياة كثير من المسلمين اليومي، إذ تجدهم يلتزمون بأداء الصلوات – حتى وإن كانوا لا يفعلون من قبل – فيهرعون إلى المساجد، ليس لصلاة التراويح فحسب، بل لأداء معظم الصلوات الأخرى. ويعكف نفر منهم على قراءة القرآن الكريم وختمه مرة، وربما أكثر من مرة. ويتفنون خلال نهاره – وهم جوعى – في حشد قسط وافر من الأطعمة حلوها ومالحها ليشفوا غلة المعدة التي خوت وخلت وملئها بما قد يسكت جوع يوم قادم.
هذا التغير في مسلك حياة المسلم اليومية – خاصة في جانب العبادة – كفيل بأن يغير الكثير في تفكيره. لكني لست أراه منعسكا في مسلك كثير من الناس لا في فكرهم ولا في تصوراتهم ونظرتهم إلى العالم وما حولهم ومن حولهم.
فلماذا؟
أحسب أن الجواب يكمن في أمرين:
أولهما أن جل هم الكثير منا في عباداته هو أداء الطقس الديني أو الشعيرة والانتهاء منه
وثانيهما غياب التدبر في التعامل مع القرآن الكريم، وفي أداء الشعائر.
فنحن في صلواتنا، نؤديها ولا نُقيمها، بالرغم من أن القرآن لا يتحدث عن الصلاة إلا ويقرنها بالإقامة.
ونحن في التعامل مع القرآن الكريم، وهو النبع الأصيل لهذا الدين، نقرؤوه، ولا نتلوه ونتدبره، فالتلاوة في معناها الأصيل تعني التريث والتمهل. ولسنا مطالبين بختمة واحدة أو نصف ختمة، أو حتى ربع ختمة. بل نحن مأمورون بقراءة ”ما تيسر“ منه. ومأمورون أيضا بتدبره، ”أفلا يتدبرون القرآن“.
وقد أدى تركيزنا على ”أداء الشعيرة“، وغياب ”التدبر“ إلى شيوع أنماط من السلوك ورسوخ تصورات في الأذهان – أرجو أن آتي على ذكر بعضها في يومياتي إن شاء الله تعالى – أظنها مخالفة تماما لجوهر الدين السمح الرحيم الودود.
ورمضان كريم
الثلاثاء ٩ رمضان ٢٠١٦
الحوار وحل المشكلات
من يتدبر كتاب الله تعالى ويسعى إلى فهم آيه ومقاصده، يعجب لما أصبح عليه حال المسلمين.
فكيف يستقيم لديه ما يشاهده كل يوم من إقدام منتسبين إلى الإسلام على القتل والذبح والتفجير والانتحار وأبشع أنواع الانتقام وأفظعها لمن وممن يخالفونهم الرأي أو التفسير والاجتهاد، من بني شريعتهم، أو يخالفونهم العقيدة ممن ينتمون إلى شريعة أخرى.
فلا يستقيم هذا في العقول مع ما يزخر به القرآن الكريم من أول كلمة فيه وحتى آخره، من حوار بين الخالق سبحانه وإبليس، وبينه وبين المكذبين والكفار والمشركين، وبين أنبيائه وأقوامهم. وآي القرآن في ذلك واضحة النهج في عرض فكر واتجاه الطرف الآخر بأمانة وتفصيل، دون ابتسار، حتى وإن ادعوا على الله ما يدعون أو افتروا عليه ما يفترون.
وقصص القرآن الكريم لا تهدف إلى التسلية أو التسرية، بل ترمي إلى تعليمنا دروسنا كثيرة. أولها وأهمها في رأيي هو اللجوء إلى التحاور إذا ما نشب خلاف، أو طرأ اختلاف.
ومن هنا كانت جريمة قتل النفس – أي نفس بشرية بغض النظر عن العقيدة أو الشريعة أو اللون أو الجنس – أبشع جريمة من وجهة نظر كتاب الله تعالى: فمن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
فهل يقبل عقل مسلم متدبر لآي الكتاب العزيز، بعد ذلك، أي تفسير أو توجيه مغرض – مهما كان مصدره، ومهما علا كعب من يتجرأ على القول به – لمعاني آيات الله تعالى يميل إلى حل النزاع بالقتل أو الصلب أو الذبح أو إلقاء الناس من فوق أسطح المنازل؟
تلك شريعة لا أعرف مصدرها ولا أحسب أنها تنتسب إلى الله جل وعلا.
عودوا إلى كتاب الله وحاولوا تدبر معانيه ومقاصده العليا، فهذا – في رأيي – أولى من حفظه بلا فهم، وختمه بلا استيعاب.
ورمضان كريم
الأربعاء ١٠ رمضان ٢٠١٦
بين العقل والأُذُن
مِن بين مَن تعرفنا – أنا وزوجتي – عليهم في بي بي سي شاب باكستاني يعمل في الأمن. نلقاه كل يوم صباح مساء فنلقي عليه التحية بالعربية فيُسَرّ لذلك أيما سرور لأنه يحاول تعلم لغة القرآن الكريم.
وتكثر في كلامه كلمات وتعبيرات قرآنية، يرددها أحيانا في غير محلها، فيثير ضحكنا. من ذلك – مثلا – ما حدث ذات مرة عندما كان يسلم على زوجتي ممسكا بيدها. والتفت إلي قائلا وهو يبتسم: ”لحما طريا“.
وخضنا في مرة أخرى في حديث خاطف كلاما عن العبادة، والخشوع، وحب الله تعالى. وقالت زوجتي معبرة عن وجهة نظرها: ”إنني رأيت الله غير مرة، في حوادث كثيرة“. ثم أضافت مشيرة إلى صدرها: ”إنه هنا فيّ“. وبانت على صاحبنا أمارات الامتعاض. ثم اعتدل في وقفته واتجه إلى زوجتي وقال في صوت أكثر حدة: ”لا، لا ..حاشاه“. وأسرع مضيفا دون أن يعطيها أو يعطيني فرصة للحديث: ”قولي إنه هنا بالعلم، وليس بذاته.“
فهمنا ما يقصده ونصحت زوجتي أن تنهي الحديث ولا تتمادى فيه أكثر.
صاحبنا هذا نموذج لكثير من الباكستانيين – بل لكثير من المسلمين أيضا – فيما يتبنون من أفكار، هي غرس ثقافة ارتوت بمأثورات ومرويات فنمت وأينعت في بيئة يهيمن عليها الانغلاق على النفس، والنأي عن العالم بما فيه من ثقافات وأفكار واتجاهات أخرى. والأهم من ذلك كله هجر النبع الثر للإسلام، ألا وهو القرآن العظيم، الذي يحفظون منه سورا ويقرؤون منه أجزاء، دون تدبر أو استيعاب.
ويأخذ هذا النوع من المسلمين الكلام بطريقة حرفية، ويقف عند حروف النص الديني لا يتعدونها. ويكادون يلغون المجاز من اللغة، فيرفضون تعبيرات مماثلة لما قالته زوجتي معبرة بصدق عما تشعر به، دون أن ترمي أبدا إلى أي ”تجسيد“ الله تعالى.
وهم أيضا لا يقبلون عبارات شائعة من قبيل ”.. وقبل كل شيء ..“، لأن الله وحده هو الذي كان قبل خلق الكائنات، و”.. فلان رسول المحبة ..“، لأن الرسول – في رأيهم – شخص مبعوث من الله، و”.. أهلا وسهلا بك .. زارنا النبي ..“، إذ كيف تسوّي ضيفك بالنبي الكريم. وغير ذلك من أمثلة تناولها داعية شاب ذات مرة في شريطي تسجيل تحت عنوان (ألفاظ تخالف العقيدة) ووجدا طريقهما إلى الشيوع عبر سيارات الأجرة التي يفرض سائقوها في مصر مثل هذه الشرائط على ركابهم في رحلات الذهاب والإياب.
هذا النهج ”الحرفي“ تربة خصبة جدا لتقبل التفسيرات المتشددة لكتاب الله تعالى، إذ يغيب معه دور ”العقل“، فليس للعقل دور أو مجال في مدرسة ”النقل“ وفي الثقافة ”السمعية“ التي تحتل الآذان فيها دور العقل وتكون هي وسيلة التواصل.
ورمضان كريم
١١ رمضان ٢٠١٦
”ضرب“ النساء وتغييب العقل
فقهاؤنا وعلماؤنا الأفاضل بشر مثلنا. وكذلك الفقهاء والعلماء في أي عصر، يتأثرون ببيئاتهم التي ينشؤون فيها، وبزمانهم الذي يعيشون فيه، وبمجريات الأحداث من حولهم. ولذلك يُؤخذ منهم ويُرد، ولا ينبغي أن نخلع عليهم أبدا ثياب القداسة. وإن كنا نحترمهم ونجلهم، لكنا نرفض في الوقت ذاته من آرائهم ما يخالف القرآن الكريم، وما يناقض هبة الله فينا، ألا وهي العقل.
هذا هو موقفي من أي فقيه أو عالم في أي عصر أو مدينة. وأنا أقول هذا الكلام لما رأيته من هيمنة آراء بعض الفقهاء – خاصة من ينتمون إلى عصور الإسلام الباكرة – على فكر الناس، متعلميهم وغير متعلميهم – وغلبة تلك الآراء والأفكار على حياتنا وفضائياتنا وبرامجنا المسموعة والمرئية. ويرجع ذلك – كما قلت في اليومية السابقة – إلى طبيعة ثقافتنا السمعية التي يتوارى معها دور العقل.
ولست أرغب في التمادي في هذا السرد النظري، بل أود أن أطرح مثالا واحدا للاستدلال على ما أذهب إليه.
يتعلق هذا المثال بالمرأة ومسألة نشوزها، وكيف نتعامل معها، ومع الآيات الكريمة التي تتناول هذه المسألة. وأريد هنا التوقف عند مسألة ”ضرب“ المرأة. لكني سأطرح أولا بعض الأسئلة.
١- هل النشوز خاص بالمرأة فقط؟
٢- هل يمكن أن يأمر الله سبحانه وتعالى، وهو الودود الرحيم، بالضرب؟
٣- هل هناك تدرج في التعامل مع النشوز؟
من يقرأ آي القرآن الكريم ويتدبرها يعلم أنه تحدث عن نشوز الرجل ونشوز المرأة. لكن ثقافة مجتمعاتنا ”الذكورية“ تهمل الأولى وتركز على الثانية لقمع النساء.
ولست أتصور أبدا أن الله جل شأنه يأمر الرجال بضرب النساء. إذ لا يستقيم هذا الفهم ألبتة ومساواته تعالى بين ”الذكر والأنثى“، والرجل والمرأة. ومهما قيل عن نوعية الضرب من أنه ”خفيف“، وأنه قد يكون بالسواك مثلا، ومهما بذل من محاولات لتجميل هذا الفهم ”السقيم“ فإنه لا يستقيم أبدا وعدل الله تعالى ورحمته.
علينا إذن أن نقلب النظر ونعمل الفكر للوصول إلى فهم أفضل يتماشى وعدل الله تعالى ورحمته ورأفته بعباده جميعا، ويتماشى أيضا ومساواته بين الرجل والمرأة، كما نفهم ذلك من آيات الكتاب الكريم.
ولا يهمنا في ذلك انتقادات غير المسلمين في الغرب أو في الشرق للتفسيرات التقليدية المتداولة لهذه المسألة، إذ إن تلك التفسيرات – كما قلت سابقا – بشرية يخطئ أصحابها ويصيبون. ومن حق أي مطلع عليها أن يبدي فيها رأيه، ولو كان منتقدا.
وقبل أن نجيب على السؤال الثالث تعالوا ننظر معا في الآيات الخاصة بالمسألة. وهذه الآيات وردت في سورة النساء (٣٤ و٣٥).
”وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً“
نرى في الآيات أن الخطوة الأولى لعلاج النشوز هي الوعظ والنصيحة. يأتي بعد ذلك – إن فشل النصح – الهجر في الفراش. وقد يكون ذلك بالنوم في الغرفة ذاتها وليس في مكان النوم نفسه. ثم تتمثل الخطوة الثالثة، والتي من المتوقع أن تكون تدرجا لما قبلها، في ”الضرب“. ومعنى الضرب هنا الذي يتماشى والسياق هو الإعراض كلية. فـ”اضربوهن“، أي ”اعرضوا عنهن“، مثل الإضراب عن العمل، أو الإضراب عن الطعام، أي ترك الغرفة كلية والنوم، وربما المعيشة أيضا، في غرفة أخرى داخل البيت.
وفي هذا جواب على سؤالنا الثالث والقول بوجود تدرج في التعامل مع مسألة النشوز.
هذا ما قال به بعض المفسرين المحدثين للنص، وهذا – في رأيي – ما يتماشى وروح النص، كما أنه يتماشى أيضا مع عدل الله، والتدرج الطبيعي لخطوات التعامل مع النشوز.
ما يهمنا هنا هو موقف بعض العلماء المسلمين، وأخص أستاذة للشريعة في جامعة الأزهر، ممن رفضوا هذا التفسير. ولم يكن رفضهم مبنيا على المنطق أو العقل، أو الحجة، بل كان دافعه هو أن ”هذا التفسير يخالف ما تعارف عليه علماؤنا القدماء“.
وهكذا أرادت تلك الأستاذة أن تنتصر للقديم ”المقدس“ لديها، بالرغم من أنه يسيء بطريقة غير مباشرة إلى الله تعالى، لأن فيه اتهاما له – جل شأنه – بعدم العدل بين الجنسين، واتهاما له بعدم الرحمة، لأنه ”يأمر“ بالضرب. لكن المهم لديها، هي ومن لف لفها، الحفاظ على ”قدسية“ كلام الفقهاء والعلماء، لأنه يعشش في عقولنا بسبب الثقافة السمعية، وعدم احترام العقل واحترام دوره، وضرب الحائط، وربما الحيطان كلها، بأي رأي آخر، حتى وإن أساء لله تعالى، وحتى وإن كان فيه دفاع عن بنات جنسها.
هذه هي سمات النهج الحرفي الذي يقتل الاجتهاد، ويُغيّب العقل. وثقوا أن اجتماع هاتين الصفتين (قتل الاجتهاد وتغييب العقل) يعني ضرورة مخالفة مقاصد القرآن الكريم العليا.
ورمضان كريم
الجمعة ١٢ رمضان
القرآن الكريم والمرويات الظنية
موضوع استطلاع أهلة الشهور العربية، خاصة شهر رمضان، نموذج آخر للنهج الحرفي الذي نعرض لأمثلة منه في بعض تلك اليوميات، والذي أزعم أن سبب انزلاقنا إليه هو الابتعاد عن نبع شريعتنا الأصيل، القرآن الكريم، وعدم تدبر آياته.
حينما يقترب حلول شهر رمضان، تتناول وسائل الإعلام الموضوع في برامجها، وتناقش المسألة وارتباطها بالحساب الفلكي، والرؤية البصرية للهلال الوليد، دون الخروج بنتيجة عملية تساعد في الوصول إلى سبيل يتحد بها المسلمون في بدء صومهم، والاحتفال بعيديهم.
ولابد هنا من الوقوف عند عدة قضايا.
أولاها إصرار المسلمين – الكاشف عن فساد في الفكر والمنهج – على التمسك حتى الآن في مسألة استطلاع الهلال بحديث منسوب للنبي فحواه ”صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته …“. وأصبح هذا الحديث لدى المسلمين، وأكاد أقول جلهم، هو المعيار الأوحد الذي يعتمدون عليه، ويطرحون في سبيله جانبا كل شيء آخر، حتى هدي القرآن، ونتائج العلم.
وإذا طرحت المسألة للنقاش يبادرك محاوروك دوما بهذا الحديث ليصادروا على رأيك وليغلقوا باب النقاش. ولا يتطرق أحد منهم أبدا لصحة الحديث أو عدم صحته. ولا يلفت أحدهم إلى قبول تأويل ”الرؤية“ الواردة في الحديث – إن سلمنا بصحته – بالحساب الفلكي، إذ لا يجوز في النهج الحرفي اللجوء إلى التأويل.
أما القضية الثانية في هذه المسألة فهي ”تهميش“ القرآن وهديه، واحتلال المرويات والأحاديث درجة أعلى منه، تعد معها هي الأساس المعتمد في بحث المسائل.
وآيات القرآن فيما يخص تلك المسألة – كما أراها وأفهمها – واضحة جلية. إذ ترشدنا الآيات إلى أن ”الشمس والقمر بحسبان“ (سورة الرحمن ٥)، و”الشمس والقمر حسبانا“ (سورة الأنعام ٩٦)، أي بحساب دقيق، وفي هذا آية من آيات الله في الخلق. وهذا الحساب الدقيق اكتشفه علماء الفلك في عصورنا، ومكنتهم تلك الدقة من معرفة ميلاد الأهلة وتحديد أوقات ولادتها ونهايتها، بل ساعدتهم أيضا على وضع جداول لمواقيت الصلوات لأعوام وأعوام مقدما.
فلماذا نترك آية الله تعالى في دوران الشمس والقمر بحساب دقيق، ونتمسك بحديث نصر على قصر تفسير ”رؤية“ الهلال فيه على الرؤية البصرية؟
أولم ننتبه – وهذه هي القضية الثالثة – إلى التناقض الصارخ في نهجنا، في الأخذ بحساب الفلك في مواقيت الصلاة، وتركه في تحديد الأهلة؟
وسبب هذا التناقض هو حديث ”الرؤية“ الذي قدسناه وجمدنا فكرنا عنده فلم نستطع منه فكاكا، ولم نجرؤ على تأويله. وهذا هو بعينه ملمح النهج الحرفي في قراءة النصوص.
وكان من نتاج الالتزام بهذا الحديث والالتزام بحرفيته، رفض هدي القرآن وطرحه جانبا، ورفض العلم وحساباته الفلكية. والأدهي من ذلك محاولة بعضنا تشويه صورة العلم والفلك في أذهان الناس. إذ يقول بعض الكتاب إن حسابات الفلك ”حدس وتخمين ولذلك لا يأخذ بها الفقهاء“. وفي هذا خلط مقصود بين علم الفلك أو النجوم والتنجيم.
ويقول ابن تيمية إنه ”لا يجوز الاعتماد على الحساب بالنجوم باتفاق الصحابة والسنة، لأن علماء الفلك لا يتيقنون من ضبط هذا الأمر بالحساب وحده“.
ومجمع البحوث الإسلامية في مصر التابع للأزهر يقرر أن الرؤية البصرية ”هي الأصل في معرفة دخول أي شهر قمري“.
وهكذا سيظل المسلمون غير متحدين في صيامهم، لابتعادهم عن هدي القرآن الكريم وعدم تدبر آياته، والإصرار على إعلاء مرويات ظنية أخرى عليه، وتقديسها والتزام النهج الحرفي في النظر إليها.
ورمضان كريم
السبت ١٤ رمضان ٢٠١٦
أساطير وخيال جامح
لدى بعض المسلمين خيال جامح يفوق في جموحه قصص ألف ليلة وليلة، وأفلام هوليوود الأسطورية.
والخيال وسيلة مهمة في الوصول إلى الجديد من المخترعات، يتمتع به علماء الأمم المتقدمة ومفكروها وأدباؤها. وكم من مخترعات وأفكار موجودة في حياتنا ونفيد منها كل يوم، بدأت أول أمرها بشرارة من خيال في عقل كاتب أو عالم.
أما خيالنا نحن المسلمين فلا يقودنا إلى العمل، ولا يدفعنا إلى تقدم، بل يؤدي بنا إلى تقاعس ويزرع في صدورنا بذور الخوف والرهبة.
تعالوا ننظر معا في بعض السيناريوهات الخيالية التي كتبها رجال – ربما من زمن ماض قديم، أو من زمن قريب من عصرنا – وحفظتها ثقافتنا النقلية بأمانة.
ثم أخذت تلك السيناريوهات تشيع وتظهر كل يوم بين الحين والآخر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي – من قبيل فيسبوك، وتويتر وواتسأب، وغيرها – ينشرها مستخدمو تلك المواقع بحسن نية ودون وعي لنوال الثواب من وراء نشرها، ولإتاحة الثواب نفسه والجزاء عينه لمن قرأها ثم نشرها، بحسب ما يعتقدونه.
السيناريو الأول: المنظر في الجنة:
”يظهر في جانب الصورة رجل يؤدي الصلاة، وفي الجانب الآخر من الصورة طائر جميل يقف على شجرة كبيرة تقع قرب نهر. وترى في المناظر التالية الطائر وهو يحط من على الشجرة، ثم يغمر نفسه في مياه النهر، ثم يخرج نافضا ريشه على جانب النهر. وتتحول كل قطرة من قطرات المياه المتساقطة من ريشه إلى مَلَك، نراه يتمتم بدعاء متوجا به إلى رب العالمين“.
والطائر – يا سادة يا كرام – اسمه ”التحيات“، أما الشجرة فاسمها ”الطيبات“، والنهر اسمه ”الصلوات“. أما حركة آلة التصوير فهي على النحو التالي: كلما قال المصلي ”التحيات لله، والصلوات الطيبات“، نزل الطائر عن الشجرة، فانغمس في النهر، ونفض ريشه على جانب النهر. وكل قطرة وقعت منه خلق الله منها ملكا يستغفر للمصلي إلى يوم القيامة.
هذا السيناريو جاء تحت عنوان (معلومة رائعة يجهلها الكثير)، بلا أي سند، ويتداوله مسلمون طيبون على موقع فيسبوك. وقد لا يكون فيه ضرر، لكن مناخ الثقافة النقلية في وسط تشيع فيه الأمية يساعد في انتشاره.
السيناريو الثاني: يوم القيامة.
وجاء هذا السيناريو في روايات نسبها مؤلفوها – في جرأة غريبة – إلى النبي الكريم عليه السلام.
“يكون أول من يجتاز الصراط أنا وأمتي … لن يكون هناك سوى مكانين الجنة والنار، ولكي تصل إلى الجنة يجب أن تجتاز جهنم. … يُنصب جسر فوق جهنم اسمه “الصراط” وهو بعرض جهنم كلها.
وهذا الجسر – أو الصراط بحسب المرويات – ”أدق من الشعرة، وأحد من السيف، وشديد الظلمة، وتحته جهنم سوداء مظلمة. وعليه كلاليب (خطاطيف) وتحته (شوك مدبب) يجرح الأقدام و يخدشها. وتسمع أصوات صراخ كل من تزل قدمه عليه ويسقط في قاع جهنم عاليا. وترى الرسول واقفا في نهايته عند باب الجنة، يرى المار وهو يضع قدمه عند أول الصراط ويدعو له: ”يارب سلم، يارب سلم“. ويمر عليه كل إنسان وهو يحمل ذنوبه، فإذا كانت ثقيلة كان مروره بطيئا عليه، وإن كانت خفيفة مر سريعا كالبرق. ويرى العبد الناس أمامه، منهم من يسقط ، ومنهم من ينجو، وهو لا يبالي. وقد يرى العبد والده وأمه، لكنه لا يبالي بهما أيضا، فكل ما يهمه في تلك اللحظة هو نفسه فقط.“
يتداول المسلمون هذه المرويات الخيالية، التي تحمل هذا السيناريو، دون أن تثير في عقولهم أي تساؤل: هل لمثل هذا ”الجسر“ وجود فعلا يوم القيامة؟ إذ لا ذكر له – بحسب علمي – في القرآن الكريم، وإن توهم بعض الساذجين أنه هو الصراط المذكور في آيات قرآنية عدة، ومنها آيات سورة الحمد (اهدنا الصراط المستقيم).
وإن افترضنا أن وجوده حقيقة، فكيف سيكون وضعه يوم القيامه؟ وهل سيكون المرور عليه عقب الحساب والميزان؟
وإذا كان ذلك كذلك، فما فائدة الحساب والميزان؟ وهل نتخيل أن الله تعالى العدل الرحيم مالك يوم الدين، يعلق جواز المسلم إلى الجنة على مروره على جسر بمثل هذه الصفات، وليس على عمل كل منهم؟
روايات من نوع آخر
وإلى جانب تلك المرويات الخيالية، ثمة روايات من نوع آخر منتثرة في كتب الحديث.
من ذلك مثلا ما يُنسب إلى النبي الكريم عليه السلام:
”إذا قرأت الفاتحة ثلاث مرات فقد تصدقت بأربعة آلاف درهم“.
و”إذا قلت لاإله إلا الله وحده لاشريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير عشر مرات فقد زرت الكعبه“.
و”إذا قلت لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات فقد حفظت مكانك في الجنة“.
و”من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات“.
هذا النوع من المرويات يرسم صورة للمسلم مغايرة لصورته التي نرى ملامحها في القرآن الكريم.
فهو هنا يتصدق وهو لم يبرح مكانه، لكنه يقرأ فقط فاتحة الكتاب ثلاث مرات. وما أيسر التصدق بهذه الطريقة دون بذل جهد أو إنفاق مال.
وهو هنا أيضا يحج أو يعتمر وهو جالس في مكانه، ودون إنفاق أو جهد، فما عليه إلا أن يتمتم بكلمات.
وهو هنا أيضا يحفظ مكانه في الجنة، بلا عمل وبلا حساب، بعد أن يردد كليمات.
وهو يستطيع كذلك تخفيض سيئاته، ورفع درجاته، بتكرار صيغ لفظية للصلاة على النبي الكريم عليه السلام.
فأين من ذلك – بالله عليكم – صورة المسلمين الذين ”آمنوا وعملوا الصالحات“.
ورمضان كريم
الاثنين ١٥ رمضان ٢٠١٦
”أهل الذكر“ وعوار الخطاب الديني
من بين ما يردده أتباع الخطاب الديني التقليدي آيات قرآنية، أو بعض آية، تسمعها في المناقشات هنا وهناك، يكررها كبارهم بلا تدبر ويلوكها صغارهم بلا تفكر. من ذلك جزء من آية سورة النحل (٤٣) ”… فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون …“.
وهم بترداد ذكر ذلك الجزء من الآية يسعون إلى تأكيد سلطة دينية – لا يرغبون في أن ينازعهم فيها أحد – أسسوها في عقول المسلمين البسطاء في وسط من الثقافة السمعية النقلية، التي تسمح بانتشار خطابهم وشيوعه.
ودور المسلمين في هذا الوسط السمعي النقلي هو أن يطرحوا الأسئلة ويتلقوا من ”علماء الأمة“ الجواب الشافي. وليس المسلم فيه بحاجة إلى إعمال عقل أو تفكر أو تدبر، فقد تكفل ”أهل الذكر“ بالمهمة جميعا.
وأنا أؤكد أن عبارة ”… فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون …“ جزء من آية، وليس آية كاملة. وهذا هو ديدن أتباع الخطاب الديني التقليدي، وهو أيضا أحد ملامح خطابهم: يقتطعون آية، أو جزءا من آية، من سياقها، ويستدلون به فيما يرغبون. وهم يدركون ألا أحد يدقق أو يراجع.
ولنعد إلى ”أهل الذكر“ مرة أخرى.
ورد هذا التعبير مرتين في القرآن الكريم: في سورة النحل في الآية ٤٣ والآية ٤٤ ”وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات وبالزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون“. وفي سورة الأنبياء في الآية ٧ والآية ٨ ”وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وما كانوا خالدين.“
والخطاب في الآيتين موجه إلى النبي الكريم عليه السلام، وفيه حديث عمن سبقه من الرسل ومهمتهم وصفاتهم. فهم بشر ”رجال“ ولكن ما يميزهم من غيرهم هو أنهم يوحى إليهم. وحتى يتأكد النبي الكريم ومن تبعه من ذلك، يأمرهم الله تعالى بسؤال ”أهل الذكر“. وأهل الذكر في هذا السياق – في الآيتين الكريمتين – هم ”أهل الكتاب“، كما توضح الآية التالية ”بالبينات وبالزبر“ والسياق الذي وردت فيه الآيتان في السورتين. فأهل الكتاب أدرى بالأنبياء وبالرسل السابقين لأنهم مذكورون في كتبهم، أكثر من أهل الشريعة الجديدة.
ولفظ ”الذكر“ يستخدمه القرآن الكريم للدلالة على ”الكتاب“. واستخدم القرآن هذا اللفظ في الإشارة إلى التوراة والإنجيل، كما استخدمه صفة للقرآن الكريم.
وهكذا يكشف لنا تدبر الآيتين الكريمتين أن المقصود بتعبير ”أهل الذكر“ ليس ”العلماء!“ وليس ”علماء الدين!“. وأن استخدامه من قبل أتباع الخطاب الديني التقليدي بمعنى ”علماء الأمة“ أو ”علماء الدين“، إنما هو استخدام فيه مغالطة مقصودة ترمي إلى كبح جماح العقول، ووقف تفكير الناس في أمور دينهم. وهذا هو الكهنوت بعينه الذي لا مكان له في الشريعة الإسلامية.
وثمة أمثلة أخرى لنهج اقتطاع الآيات من سياقها – أو حتى اقتطاع جزء منها من سياقه – مما يردده أتباع الخطاب الديني التقليدي، قد نعرض لها في تلك اليوميات لبيان عوار هذا النهج الذي كان من نتاجه خطاب التطرف الذي تستخدمه الجماعات المتشددة باقتطاع بعض آيات ”القتال“ في القرآن الكريم من سياقها، لتبرير وحشيتهم.
ورمضان كريم
الثلاثاء ١٦ رمضان ٢٠١٦
الصلاة على النبي ليست شقشقة باللسان
في سورة الأحزاب – وهي سورة مدنية – آية تتضمن أمرا إلهيا للمؤمنين أحسب أننا لم نحسن فهمه، ونؤديه على غير ما ينبغي.
الآية هي الآية ٥٦ التي تقول ”إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.“
وفي تعامل الخطاب الديني التقليدي مع هذه الآية الكريمة مثال آخر لنهج اقتطاع آي القرآن الكريم من سياقها، وقد ترتب على هذا فهم – أظن – أنه غير صائب لمعناها الذي يحدده سياق السورة.
وحتى نفهم الآية حق فهمها علينا أن نعود إلى السياق الذي وردت فيه في سورة الأحزاب.
تبدأ السورة بخطاب إلى النبي الكريم عليه السلام ”يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين …“. وهذا هو مفتاح السورة، إذ يدور جزء كبير منها على العلاقة بين النبي الكريم والمؤمنين من ناحية والكفار والمنافقين من ناحية أخرى. وفي السورة أيضا حديث عن الظهار، والتبني، وحرمة زوجات النبي على المسلمين، وذكر لغزوة الأحزاب، أو الخندق، وموقف المنافقين المذبذب من القتال، وإيذاء الكفار والمنافقين للنبي وزوجاته والمؤمنين والمؤمنات.
وتقع الآية ٥٦ في سياق ينبه فيه الله تعالى نبيه الكريم إلى ما يتعرض له هو وزوجاته والمؤمنين والمؤمنات من أذي من قبل الكافرين والمنافقين، ويحثه – في هذا الصدد – على التوكل على الله وحسب. ويبين السياق أيضا عقاب الله لمن يرتكبون هذا الإيذاء ”إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا“.
وفي ضوء هذا السياق ينبغي – كما أحسب – أن نفهم الآية ٥٦ ”إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.“
وفي الآية شقان: شق يتعلق بصلاة الله تعالى وملائكته على النبي، وشق آخر يتضمن توجيها إلهيا للمؤمنين بالصلاة على النبي والتسليم عليه.
فكيف يصلي الله تعالى على النبي عليه السلام؟ وكيف تصلي الملائكة عليه؟
تقول كتب التفسير إن الصلاة من الله هي الثناء أو الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الناس الدعاء.
لكن هذا التفسير لم يشف غلتي ولم يقنعني. ومازلت أرى أن في الآية الكريمة إلماعا إلى معنى آخر يرتبط بالسياق الذي تحدثنا عنه، ألا وهو سياق إيذاء الكفار والمنافقين للنبي وزوجاته وللمؤمنين والمؤمنات.
وقبل أن أشير إلى هذا المعنى، أود أن ألفت الانتباه إلى أن صلاة الله تعالى وملائكته ليست مقصورة على النبي الكريم وحده، بل تشمل المؤمنين أيضا. وقد جاء ذلك في آية سابقة أخرى في السورة نفسها، سورة الأحزاب. وهي الآية ٤٣ التي جاءت في سياق حث المؤمنين على ذكر الله تعالى. يقول الله تعالى (آيات ٤١-٤٣) ”يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.“
وقد تساعدنا هذه الآية في فهم معنى صلاة الله تعالى وصلاة ملائكته على المؤمنين.
تتضمن الآية أمرا للمؤمنين بذكر الله وتنزيهه صباح مساء، فهو – جل وعلا – الذي ”يصلي عليكم“ هو وملائكته، حتى يخرجكم من الضلال إلى الهدى. فهل الصلاة التي تؤدي إلى الخروج من الضلال إلى الهدى، هنا هي الثناء؟ أو هل هي ”الرحمة“ – كما تقول بعض التفاسير؟
أنا أزعم أن معنى الصلاة هنا هو الرحمة بالتأييد والنصرة، فهو الذي يرحمكم بتأييده ونصرته هو وملائكته لكم.
وفي ضوء هذا الفهم يمكننا أن نفهم معنى الشق الأول من الآية ٥٦ ”إن الله وملائكته يصلون على النبي“، على النحو التالي، أي أن الله وملائكته يؤيدون وينصرون النبي الكريم عليه السلام – رحمةً منه سبحانه وتعالى – حيال ما يلقاه هو وزوجاته والمؤمنون والمؤمنات من إيذاء الكفار والمنافقين.
وليس بغريب أن يأتي عقب هذه الآية مباشرة قوله تعالى (آية ٥٧) ”إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة …“، ثم قوله في الآية التالية (آية ٥٨) ”والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.“
ومما يدفع الأذى عن زوجات النبي الكريم والمؤمنات آنذاك إدناء جلابيبهن عليهن في الآية ٥٩ ”يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين …“، فإذا عرف الكفار والمنافقون من هن باحتشامهن لم يجسروا على إيذائهن.
كيف يمكن إذن – بعد بيان معنى الشق الأول من الآية – أن نفهم أمر الله تعالى في الشق الثاني منها ”يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما“؟
هل يمكن أن يأمرنا الله في هذا الجزء من الآية – بحسب معظم التفاسير – بالثناء أو الدعاء للنبي الكريم؟، وهل كان النبي عليه السلام بحاجة إلى دعاء المؤمنين له وقت تعرضه للإيذاء، أم أنه كان بحاجة أكثر إلى تأييدهم ونصرتهم؟ وهل هو – بعد موته – بحاجة إلى دعاء المؤمنين في عصورنا هذه، أم تراه بحاجة أكثر إلى نصرتهم وتأييدهم بالدفاع عن ذكره الكريم وسيرته بالحسنى في مواجهة أي انتقاد؟
وهل يمكن أن يأمر الله تعالى المؤمنين بالصلاة على نبيه بتكرار صيغ لفظية، تملأ الكتب من قبيل (اللهم صل على النبي)، أو (صلى الله عليه وسلم)، وهي صيغ لا تحمل في ذاتها إلا إحالة الأمر كله إلى الله، وكأننا نقول (ياالله صل أنت على النبي)، و(اللهم ارحمه واغفر له)، دون أن نفعل شيئا من جانبنا؟
أعتقد أن أوامر الله للناس وللمؤمنين في كتابه الكريم هي دوما أوامر تقتضي فعلا وعملا من جانب المخاطبين بها. وهاكم أمثلة لما أقول:
”يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون“ (البقرة ٢١)
”يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين“ (البقرة ١٥٣)
”يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين“ (البقرة ١٦٨)
”وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين“ (البقرة ١٩٠)
”يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم ترحمون“ (آل عمران ١٣٠)
”يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم …“ (المائدة ٦)
”يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ….“ (التحريم ٦).
ولا يمكن – بحسب رأيي – أن يأمر الله الناس بصفة عامة، والمؤمنين، بصفة خاصة، بتكرار صيغ لفظية، أو شقشقة ليس وراءها عمل أو فعل. فحتى الآيات التي يأمر فيها الله تعالى بذكره تقتضي من المخاطب عملا أقله مراقبة الله في مسلكه وأفعاله. وهذه المراقبة في ذاتها فعل.
وهكذا يمكن أن نقول إن معنى ”يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما“ – كما أفهمها – أي أيدوه وانصروه بالدفاع عن ذكره الكريم وسيرته بالحسنى إزاء أي هجوم أو انتقاد.
ورمضان كريم
الأربعاء ١٧ رمضان ٢٠١٦
الترهيب والتخويف
ينحو الخطاب الإسلامي التقليدي إلى ”التخويف والترهيب“ للسيطرة على جمهوره. ويهيمن عليه هنا موضوعان أثيران هما: عذاب القبر وعلامات الساعة.
ولا يجد دعاة هذا الخطاب في القرآن الكريم ما يعضد ثقافة التخويف تلك، ولذلك يعمد الدعاة إلى اقتطاع بعض الآيات عن سياقها، ولي أعناقها تأويلا مساندة لمآربهم.
بيد أنهم يجدون في المرويات الظنية المنسوبة افتراء إلى النبي عليه السلام ساحة رحبة. كما أن طبيعة شعوبنا الطيبة – التي تسود بينهم الأمية، وتهيمن عليهم الثقافة النقلية السمعية – تساعد في انتشار هذا الخطاب بين الناس.
ولما أزل أذكر فترة شبابي – حينما اتجهت فترة من الزمن إلى إعفاء لحيتي وإمامة الناس في حارتنا يوم الجمعة في مسجد صغير، تتلمذت فيه لأمامه، وهو شيخ أزهري مكفوف البصر، وقرأت عليه بعض متون تجويد القرآن الكريم والفقه والتفسير عقب انتهاء دراستي في قسم اللغة العربية واللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة الأسكندرية، التي شعرت بعدها بحاجتي إلى التزود أكثر بزاد من العلوم الإسلامية على الطريقة التقليدية.
مازلت أذكر خلال تلك الفترة يوما جاءني فيه أحد أقاربي وطلب مني التدخل في لم شمل أسرة طلق الزوج فيها زوجته، وشعر هذا الشخص أن بمقدوري أن أرد الزوجة إليه.
لقد حكم هذا الشخص على مظهري وحده، وكنت ملتحيا، ارتاد المساجد للصلاة، وأؤم الناس خطيبا يوم الجمعة، ظانا أنني أصبحت ”شيخا“ يطرق بابه. وهذه هي طبيعة شعوبنا الطيبة التي تحكم على الناس بالمظهر، دون أن تدري شيئا عن المَخبر. ولم أقدم طبعا على ما أرادني القيام به، لأني أعرف أني لست الرجل المؤهل لذلك.
في هذا الوسط، يشيع الخطاب الديني التقليدي، مركزا على ”ثقافة الخوف“، إذ إن جمهورنا – في أغلبه – يتلقى ولا يشارك، ويسمع ولا يناقش، وإن تجرأ وسأل فهو مقتنع مسبقا بما سيتلقاه، لأنه ينزل عليه من عل: من رجال ينتسبون إلى الدين، ويرددون آيات الله تعالى، ويروون أحاديث رسوله الكريم.
وهنا نجد موضوع عذاب القبر في صدارة هذا الخطاب. وهو موضوع – إن أمعنا فيه التفكير – يناقض خطاب القرآن الكريم تماما. ولن أدخل في تفاصيل القضية لكنني أطرح سؤالا واحدا فقط هنا، ألا وهو: كيف يسارع الله سبحانه وتعالى إلى تعذيب عباده في القبور – وهو عدل – قبل أن يحاسبهم يوم القيامة ساعة الحساب؟
ولا أتوقع أن ينبري أحد من دعاة هذا الخطاب التقليدي للرد على هذا السؤال. إذ إن عادتهم هنا هي دوما الهروب منه، وطرح آية أو آيتين عن آل فرعون وعرضهم على جهنم.
وإذا كان ”عذاب القبر“ يناقض خطاب القرآن في قضية أساسية، وهي قضية البعث، والحساب، فلماذا يصر عليه الخطاب التقليدي؟
والجواب الوحيد هنا هو مئات المرويات التي يعلي هذا الخطاب من شأنها ويضعها فوق القرآن الكريم، والتي تتفنن في بسط فنون العذاب، دون أن تتعرض ”لنعيم القبر“ إن كان هناك مثل هذا النعيم.
هذا الخطاب إذن يتخذ من المرويات سندا لإشاعة فكرة ”عذاب القبر“ وترهيب الناس، ودون أدنى مبالاة بمخالفة القضية برمتها للقرآن الكريم. وجميع تلك المرويات مبنية على أساس منهار، مهما قيل بشأن رواتها وأسانيدها، لأنها تناقض القرآن الكريم، وتناقض صفة عدل الله تعالى الذي لا يعذب – جل وعلا – قبل أن يحاسب.
الموضوع الثاني الأثير لدى دعاة الخطاب الديني التقليدي، هو علامات الساعة، أو أشراطها، وهو موضوع تصرف فيه ساعات من البرامج على الفضائيات وتبذل فيه أموال طائلة.
وهو أيضا يناقض صريح آيات القرآن الكريم التي تخاطب النبي الكريم ”قل علمها عند ربي …“ وكل ما يستند عليه من مرويات، مهما علا شأن رواتها، أو سلاسلها الذهبية، أو أسانيدها، منهار الأساس، لأنه يناقض القرآن الكريم. بل إن فيه إساءة للنبي الكريم، إذ كيف يخالف ما أمره الله به من القول.
فأيهما نريد أن نتخذ سندا لبناء عقيدتنا: القرآن الكريم الذي يحترم العقل ويطالبنا بإعماله، والذي ينبني كله على مبدأ العدل. أو المرويات الظنية المخالفة للقرآن، والمليئة بالأساطير والخرافات التي لا تفسح للعقل مجالا؟
فأيهما سنختار؟
ورمضان كريم
الخميس ١٨ رمضان ٢٠١٦
الكلاب واللهاث وراء الحقيقة
موقف كثير من المسلمين من الكلاب يثير الاستغراب. فهم لا يستأنسون بها في بيوتهم، وينأون عنها في الطرقات بأنفة ورعب، خوفا من ”نجاستها“. ويظل دور الكلب في حياة هؤلاء المسلمين اليوم – على الرغم من ذلك – إما الحماية والحراسة، وإما مساعدة الشرطة في التفتيش، وإما عون المكفوفين في السير. لكن يحلو لمثل هؤلاء المسلمين التشهير باسم الكلب ونعت آبائه في سب من يكرهون ولعنهم.
وهذا الموقف المجافي للكلاب مثال آخر لهيمنة المرويات الظنية على المسلمين ومسلكهم وعلى علاقاتهم بالكون وبالآخرين وبالكائنات.
ويقول دعاة الخطاب الإسلامي التقليدي إنه ”لا يجوز للمسلم أن يقتني الكلب، إلا إذا كان محتاجاً إلى هذا الكلب في الصيد أو حراسة الماشية أو حراسة الزرع. روى البخاري (٢١٤٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ).
وروى ابن ماجه (٣٦٤٠) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ).
ويرى الشيخ ابن عثيمين (شرح رياض الصالحين – (٤/٢٤١) أن اقتناء الكلاب ذنب كبير ”وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام، بل هو من كبائر الذنوب“، بل إن ”نجاستها“ لديه عينية، ”والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزوالها بالكلية“، أي بقتلها.
ويسوي هذا الخطاب ”غير الإسلامي“ المرأة بالكلاب والحمير، فقد سئل الشيخ (عبد العزيز بن باز) – رحمه الله -: ”لقد سمعنا منكم إذا مر كلب أو حمار أو امرأة أمام المصلي تبطل الصلاة، فما هي المسافة التي تمر فيها هذه الأشياء، وهل إذا كانت هذه المرأة من المحارم أيضا تبطل الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله؟
وكان جوابه: ”ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود.“
وكل ما يهم صاحب السؤال – وهو نموذج لكثير من المسلمين الذين لا يمكن أن يشكوا فيما يرويه دعاة الخطاب التقليدي كما رأينا – هو ”مقدار المسافة بين المصلي والمار أمامه“، وكأن كل شيء آخر في ما روي هنا أمر صحيح مقبول.
ولم تعرف الثقافة العربية هذا العداء للكلاب قبل مرويات أبي هريرة – الذي كان فيما يبدو يكره الكلاب ويألف القطط، بل كان يحمل في سيره هرة صغيرة حتى كني بها.
فقد كان الكلب جزءا من حياة العربي في البادية، يعيش معه، ويتآلفان، إلى درجة أن أصبح الكلب الألوف الذي لا ينبح على الضيف صورة مدح للكرام. يقول حاتم الطائي (المتوفى ٤٦ قبل الهجرة):
إذا ما بخيل الناس هرت كلابـه وشق على الضيف الضعيف عقورها
فإني جبان الكلب بيتي موطــئا أجود إذا ما النفس شح ضمــيــرها
وإن كلابي قد أُهرّت وعُـــــوّدت قليل على من يعـتـريـني هــريـــــرها
ودور كلاب الصيد في الشعر العربي – خاصة في فن ”الطرديات“ مشهور يدركه كل من درس الأدب العربي القديم. ومن هذا الباب قول ابن المعتز (المتوفى ٢٩٦ هـ):
قـد أغـتـــــدي واللـيـل كالغــــــراب داجي القـنــاع حالك الخـضــاب
بكلبـــة تــاهــت على الكــــــــــلاب تـفــوت سبــقـا لـحــظـة المـــرتـاب
تـنـساب مــثل الأرقـم الـمـنـســاب كأنـمـا تــنــظــر مـن شــهـــــــاب
وفي المرويات المنسوبة للنبي الكريم أيضا ما يناقض الصورة السابقة المعادية للكلاب. إذ روي أنه “بينما رجل يمشي بطريق اشتدَّ عليه العطش، فوجد بئرًا، فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ منِّي، فنزل البئر فملأ خُفَّه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له، قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر.“
وليس في القرآن الكريم ما يشير أبدا إلى نجاسة الكلاب، أو يشجع على معاداتها. لقد ورد ذكر الكلب في القرآن خمس مرات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. أهمها موضعان:
الأول: في سورة الكهف (آية ١٨): ”وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا.“
وأصحاب الكهف كما ورد في القرآن ”فتية آمنوا بربهم“ وزادهم الله هدى، وهم عندما دخلوا إلى الكهف ليحتموا من قومهم كان معهم كلبهم، فكيف يحرص فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى على اصطحاب الكلب وهو حيوان نجس – كما جاء في مرويات أبي هريرة؟ وهل لم يكن الكلب آنذاك نجسا؟ أم ترى أن النجاسة حلت على الكلاب فقط مع بداية الإسلام؟
والموضع الثاني المهم الذي ورد فيه ذكر الكلب هو في سورة المائدة: ”يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤) سورة المائدة.
وقوله تعالى: ”وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ“ أي: أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، وأحل لكم ما اصطدتموه بالجوارح، وهي الكلاب والفهود والصقور وأشباه ذلك.
فكيف يحل للمسلم بنص القرآن الكريم أكل ما اصطاده الكلب، إن كان الكلب نجسا؟
وربما يظن بعض المسلمين أن القرآن الكريم ذم الكلاب في آية سورة الأعراف (١٧٦) ”وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١٧٦)
لكن الآية الكريمة تتحدث عن طبيعة لدى الكلاب، وهي اللهاث، أي التنفس السريع المتتابع غير العميق الذي تفغر فيه الكلاب أفواهها وتدلي فيه ألسنتها. وهي تفعل ذلك للتخلص من حرارة الجسم الزائدة، والسعي لتبريده، ولتهدئة التنفس عقب بذل جهد أو بسبب الخوف أو الإثارة. فالكلاب دوما تفعل ذلك سواء أكانت في وضع الراحة أم في حالة مطاردة.
لكن بعض المفسرين تمادى في الربط بين من يترك آيات الله تعالى ولا يعمل بها، وصورة للكلاب مسيئة بسبب كراهية هذا المفسر أو ذاك ومجافاته لها، لأنه تربى على ثقافة لا صلة لها بالقرآن الكريم.
ورمضان كريم
الجمعة ١٩ رمضان ٢٠١٦
وقفة تأمل
خلال رحلتي لأداء فريضة الحج في عام ٢٠١٢ أحسست بحاجة ملحة إلى الكتابة عما شاهدته منذ الإعداد لرحلة العمر، وخلال أداء شعائرها، من اتساع للهوة بين تعاليم القرآن الكريم – كما تبسطها آياته – وسلوكنا، نحن المسلمين. لقد تعرضت للسب من قبل أحد المطوعين الأفظاظ لأني رفضت فصل زوجتي عني عند ركوب الحافلة التي كانت تنقلنا بين المشاعر، وآثرت ألا أجادل فلم أرد. وقد عزمت منذ تلك اللحظة على الكتابة لبيان مدى ابتعادنا عن سماحة القرآن، ويسره، وهرولتنا وراء أقاويل ومرويات لا نكلف أنفسنا حتى عناء التحقق من موافقتها – أولا – لما جاء به كتابنا الحكيم، ثم صحتها – في المقام الثاني -، وإن كانت – في المقام الثالث – توافق العقل، هبة الله تعالى لنا.
وكان هذا أحد دوافعي في كتابة ”يوميات صائم“ في السنوات الثلاثة الماضية، وهذه هي السنة الرابعة التي أتابع فيها هذه اليوميات.
ولم أدّع أبدا ولا أزعم قط، أني ”أفسر“ القرآن الكريم، فالقرآن – في رأيي – يفسر بعضه بعضا، والرسول الكريم المبلغ لم يفسر القرآن. لكني أقول إنني قارئ متدبر لما أقرأ فيه، ولست أقرأه لأنهي ”وِردا“ أو ”خَتمة“، بل لأتعلم وأفهم وأفكر وأتساءل. وما أكتبه ليس إلا ”اجتهادات“ لن يمنعني عنها أبدا أي شيء، حتى تلك القيود التي يكبلنا بها الخطاب الديني التقليدي، من قبيل ”لا اجتهاد مع النص“، الذي يسعى دعاته إلى جعل القرآن وقراءته وفهمه وتدبره حكرا عليهم، وعلينا نحن المسلمين الاستماع إلى ما يقولون به من ”ترهات“ أحيانا واتباعها بلا مناقشة.
ولن أستعرض هنا أمثلة من هذه الترهات التي تغص بها مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يستطيع من يشاء العودة إليها في أي وقت، والتي يقول بها رجال من المفترض أنهم لا يقولون بلا ”دليل“، و”لا يجتهدون مع النص“، بيد أن مقولاتهم تجيء في كثير منها مخالفة للقرآن الكريم ومقاصده، ومنافية للعقل، بل مسيئة أيضا لديننا السمح.
ودعوني أقف هنا في هذه اليومية عند بعض التعليقات التي تردني على ما أكتب، لنتعرف على تفكير أصحابها.
مما يحاججك به دعاة الخطاب التقليدي لثنيك عن القول في أي آية أو مروية برأي ”كثرة مشاكل المسلمين التي تحتاج إلى العلاج“، وأن ما تخوض فيه لن ينفع الناس الآن. وهذا أمر طبيعي من قبلهم، فهم لا يريدون أي صيحة استيقاظ أو دعوة تدبر، تكشف للناس بعض الخرافات والأوهام التي يعيشون في أعشاشها.
والأخطر من ذلك في سياق الرد عليك ما يبين لك من خلط في أذهان دعاة الخطاب التقليدي بين المصطلحات والمفاهيم، للوصول في نهاية المطاف إلى مبتغاهم من إسباغ عباءة ”المقدس“ على كل شيء: المرويات الظنية، وكلام الفقهاء، وآراء المنتسبين إلى الدين من الدعاة ، واعتبار ذلك كله ”دينا“. لا يجوز أبدا المساس به أو ”تجريده من قدسيته“.
فقد قال أحدهم معلقا على قولي ”من حق أي مطلع على آراء الفقهاء والعلماء وتفسيراتهم أن يبدي فيها رأيه، ولو كان منتقدا“: (هكذا بكل بساطة يريد (…) وأمثاله تجريد الدين من قدسيته، عندما يساوي بين العلماء والعامة).
من الواضح أن ثمة خلطا في ذهن المعلق بين أقوال (الفقهاء) وأقوال من يُسمون بـ(العلماء)، وهم بشر يخطئون ويصيبون، و(الدين).
فهو يعد أقوال هؤلاء جميعا – وهي متغيرة من بيئة إلى بيئة، ومن عصر إلى عصر – جزءا من (الدين).
وهو يسبغ على تلك الأقوال جميعا – بعد أن جعلها جزءا من الدين – قدسية، فلا يصح لأي شخص المساس بها.
ولا يقدم دعاة الخطاب التقليدي بعد طرح القضية بمثل هذا الخلط – الذي لا أدري إن كان مقصودا أو عن غير قصد – أي دليل على أن أقوال (فقهاء) و(علماء)، يتأثرون بأزمانهم وبيئاتهم وأحوالهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية تماما كما نشاهد مسلك نظرائهم في عصرنا، أصبحت جزءا من الدين وشملتها عباءة ”المقدس“ وعلينا أن نتبع ما ألفيناهم عليه بلا إعمال لعقل أو تدبر.
وإن حاولت أنت أو غيرك تفنيد وتفتيت تلك الأقوال فقد سلكت مسلك (تجريد الدين من قدسيته).
ويكشف المعلق في تعليقه عن (كبرياء!) يدعيها دعاة الخطاب التقليدي، من أنهم طبقة ”عليا“ لا يجوز التجرؤ على مساواة غيرهم من (العوام!) بهم.
وهذا هو (الكهنوت) بعينه الذي حاربه القرآن الكريم.
ومما يسوقه أيضا دعاة الخطاب التقليدي في وجه من يحاول إبداء رأيه مقارنة الدين بعلمي الطب أو الهندسة، ويقولون لك ”هل يمكن أن تقرأ كتابا في الطب ثم تذهب إلى المستشفى وتبدأ في إجراء عملية جراحية لمريض؟ أو هل يكفيك أن تطلع على مخططات بناء معماري ثم تبدأ في تنفيذه وأنت لم تكمل المرحلة الثانوية من التعليم؟“
وهم يحاولون بذلك – مرة أخرى – تأكيد ما وقر في أذهانهم من أن للدين (فقهاء) و(علماء) متخصصين لهم وحدهم الحق في شرح وتفسير النص القرآني الكريم، وإبداء رأيهم فيه. وأنه لا يحق لأي شخص آخر إبداء رأيه أبدا.
وعرض المقارنة بين (الدين) الثابت المبادئ الذي يكوّن عقيدتنا ويشكل سلوكنا، ويحدد علاقتنا بخالق الكون وعلاقتنا بالآخرين من الناس والأمم، والعلوم الطبيعية التجريبية المتغيرة التي يدرسها الطلاب ليتخذوا منها مهنة في وقت لاحق، فيه خلط جسيم مقصود لإسكات الناس.
فليس الدين (علما)، بل هو (عقيدة) و(عبادات) و(شرائع) ثابتة. لكن الطب والهندسة (علمان طبيعيان تجريبيان متغيران ومتطوران).
ولعل ما يدفع دعاة الخطاب إلى مثل تلك المقارنة هو الخلط الموجود في أذهانهم بين القرآن الكريم الذي يمثل نبع الدين، وأقوال (الفقهاء والعلماء) واعتبارها جميعا هي (الدين)، ظانين أن حفظ المتون يجعل من هؤلاء (الفقهاء والعلماء!) (علماء) بالمعنى التجريبي للعلم.
ولست أظن أن نتائج مثل هذه المقارنة ستكون في صالح هؤلاء الدعاة، بل إنها في رأيي مسيئة لدين الله جل وعلا، إذ تسوي بينه وبين علوم بشرية تجريبية متغيرة متطورة، ومهن يرتكب فيها ممارسوها أحيانا أخطاء، ثم يعدلون عنها ويصححونها. فالدين ليس علما لأن أي علم قابل للتغير، والدين ليس مهنة، بل عقيدة وعبادات وشعائر تمارس ثم يحاسب عليها صاحبها فيما بعد.
فآمل أن يقلعوا عن هذه المقارنة حتى لا يسيئوا إلى الدين أكثر وإلى الله جل وعلا أكثر دون أن يدروا.
ورمضان كريم.