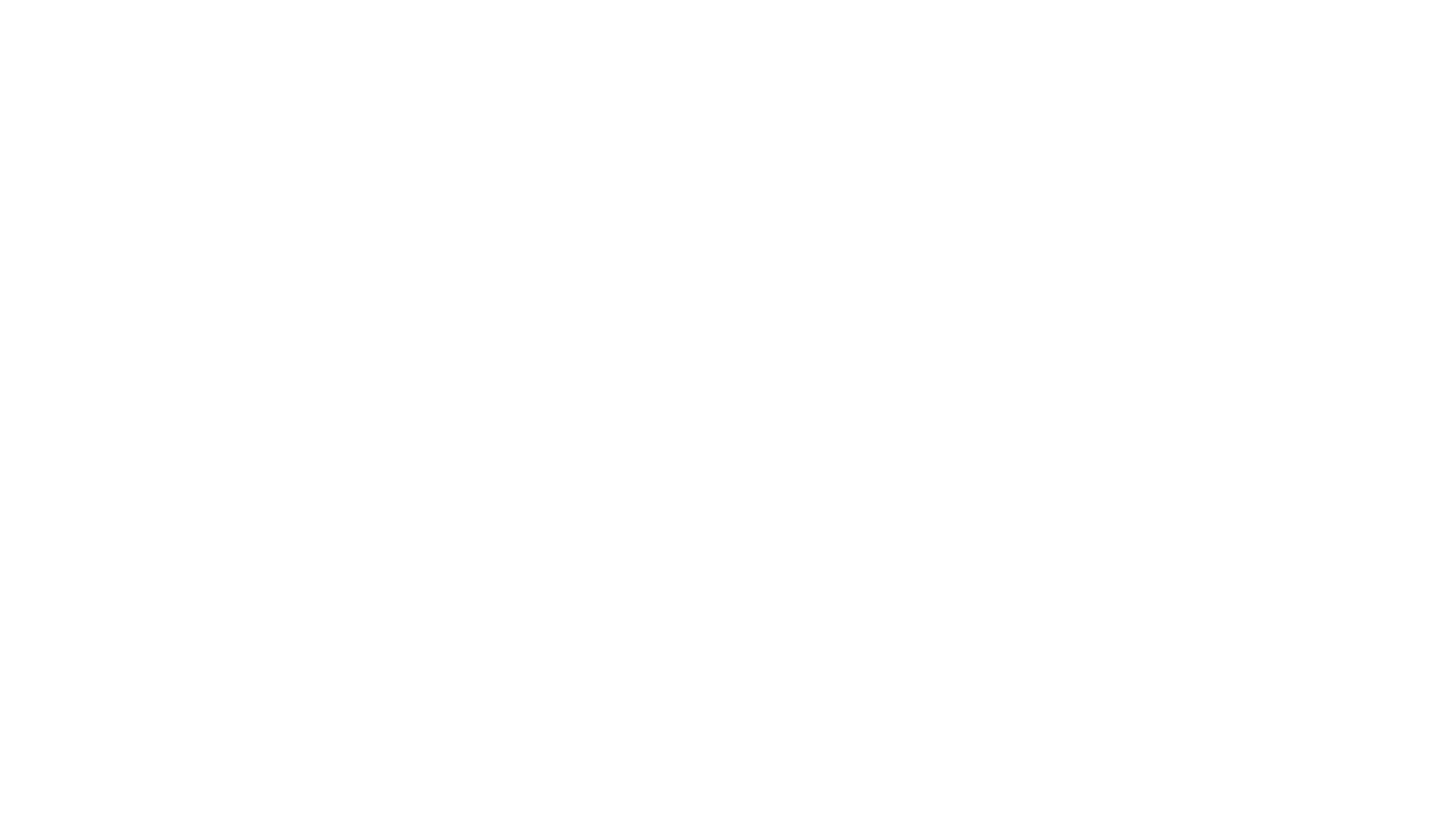الأربعاء ٣٠ شعبان ٢٠١٥
فكرة ملحة
في يوميات صائم هذا العام سأنحو نحوا مختلفا. فلن تكون يومياتي هذه المرة منبرا لخواطر تولد شرارتها أحداث أو مقابلات أو قراءات. بل ستعبر عن ”فكرة“ واحدة، لا تزال تلح علي منذ شهور، أتناول منها في كل يومية جزءا، حتى تكتمل الفكرة – إن استطعت – في نهاية الشهر الكريم.
فما زال يروقني أن أكتب عن صورة النبي محمد عليه السلام، كما ترسم معالمها آي القرآن الكريم. وهي صورة أتوقع أن تختلف كثيرا عن صورة النبي الكريم، كما هي مرسومة في أذهان الكثيرين منا، والتي نجد روافدها في كتب الحديث.
وستكون خطوة البدء من القرآن، الذي سأحاول أن أعيشه كما أنزل. وهذا يعني أنني سأقرأ سوره معكم هنا في يومياتي، بحسب ترتيب النزول، وليس بحسب ترتيب المصحف، مركزا على صورة النبي الكريم.
وآمل أن تجلي يومياتي الفكرة والصورة معا. وأن تساعد في كشف الحقيقة التي ربما سترها ركام نُقُول من هنا وهناك، أبعدتنا عن النبع الصافي الثر.
فإلى لقاء
ورمضان كريم
الخميس ١ رمضان ٢٠١٥
مفتتح الوحي
كانت سورة العلق هي مفتتح الوحي للنبي الكريم. وكان هذا الحدث الجلل في حياة محمد في السنة الثالثة عشرة قبل الهجرة.
وكان خطاب الله سبحانه وتعالى في السورة إلى محمد خطابا مباشرا، جاء في صيغة الأمر في (اقرأ، اسجد، اقترب)، والنهي في (لا تطعه)، والاستفهام في (أرأيت).
وتمثلت تلك المباشرة أيضا في استخدام ضمير المخاطب المضاف إلى لفظ رب، في (ربك) الذي تكرر ثلاث مرات في أول لقاء بين النبي والوحي في السورة، والذي ربما يهدف إلى شد أزره بأن ربه معه.
وبالرغم من أن الخطاب في السورة موجه إلى النبي خاصة، أمرا ونهيا واستفهاما، فإنه لم يكن بوسعه أبدا إلا أن يبلغه كما هو إلى من آمنوا به، وإلى الناس، وإلى جميع من يقرأ القرآن. فمهمة محمد هي تبليغ الرسالة، دون تحوير في الخطاب أو في الصيغة. وهذه نقطة جوهرية جدا، وملمح مهم من ملامح صورة النبي في القرآن.
أما الموضوعات التي دارت عليها السورة فهي الخلق (خلق الإنسان)، والعلم والتعليم (بالقلم)، وطبيعة الإنسان وميله إلى الطغيان بما يملك من مال وثراء، وتذكير هذا الإنسان الطاغي بالموت والرجعة إلى الله تعالى، ثم تخويف له بعقاب إن تجبر بما يملك، أو بمن يصاحب ويعرف.
وفي السورة ذكر للصلاة، حتى قبل فرض الصلاة التي نعرفها ونؤديها، وذكر للسجود. وهذا يدل على وجود تلك الشعيرة وممارستها في الجزيرة قبل رسالة الإسلام، ويدل أيضا على أن السجود كان جزءا منها.
الجمعة ٢ رمضان ٢٠١٥
محاذير !
قبل أن أمضي قدما في حديثي عن ملامح صورة النبي عليه السلام في القرآن الكريم ينبغي أن أتوقف قليلا لأوضح عدة أمور:
أولها أن ترتيب سور القرآن بحسب النزول غير متفق عليه بين العلماء. فالسورة الثانية من حيث النزول في الترتيب الشائع هي (القلم)، بيد أن بعض العلماء يخالفون ذلك ويرون أن (المدثر) هي التي تحتل هذه المرتبة. وأنا هنا سألتزم بالترتيب الشائع.
ثانيها أن بعض السور لم تنزل آياتها جميعا مرة واحدة، بل ربما نزل بعضها في فترة، ونزل بعضها الآخر في فترة مختلفة. لكني سأعتبر السورة هنا في يومياتي وحدة متكاملة وآخذ بها كما هي لضيق المجال.
ثالثها أن هدفي من إثارة هذا الموضوع في يومياتي هذا العام هو أن ألفت إلى قضية، وأعرض فيها رأيي واجتهادي الذي قد يحالفني فيه الصواب، وقد لا يحالفني. ويكفيني هنا أنني حركت راكدا من الماء آن له أن يتحرك.
القلم مرة أخرى
في السورة الثانية من حيث النزول، وهي سورة (القلم) يتكرر ذكر (القلم) الذي ذكر لأول مرة في سورة العلق. ويتكرر مع القلم كلمات مرتبطة به، مثل (يسطرون)، و(كِتاب)، و(تدرسون)، و(يكتبون). وتثير هذه جميعا قضية معرفة النبي الكريم بالقراءة والكتابة.
ومن يقرأ آي القرآن الكريم التي يرد فيها ذكر لفظ ”الأمي“، و”الأميين“ يدرك أن معناه ليس ”من لا يعرف القراءة والكتابة“، بل من ”لا يعرف الكتاب (التوراة والإنجيل)“، ومن لم يكن ”يستنسخه، أو يخطه بيمينه“. فالنبي في القرآن – في رأيي – يعرف القراءة والكتابة وليس ”أميا“ بالمعني الحديث للكلمة. وقد بحث هذه القضية بحثا مفصلا الدكتور محمد عابد الجابري في كتابه (مدخل إلى القرآن الكريم) في جزئه الأول.
في هذه السورة يحدد القرآن الكريم بعض صفات النبي عليه السلام: فهو رجل ”عاقل“، وليس ”مجنونا“، كما نعته المشركون (ما أنت بنعمة ربك بمجنون)، بل هو ”على خلق عظيم“ (وإنك لعلى خلق عظيم). وهو أيضا مدعو إلى التحلي بالصبر إزاء إيذاء قريش، (فاصبر لكم ربك). وحفي بمن كلف بتبليغ الرسالة أن يكون هكذا.
وخطاب القرآن للنبي الكريم في السورة لا يزال يتم إما بصورة مباشرة، باستخدام الضمير (المخاطب المنفصل: أنت)، و(المتصل: رب + ك)، وباستخدام الأمر (اصبر لحكم ربك)، و(سلهم أيهم بذلك زعيم)، وباستخدام النهي أيضا في (لا تطع المكذبين)، و(لا تطع كل حلاف مهين). وإما بنواة حوار، كما في (أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون).
وينشئ القرآن في السورة حوارا آخر مع المشركين، (ما لكم كيف تحكمون)، و(أم لكم كتاب فيه تقرأون)، و(أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة) وإن كان مبكتا لهم فيه.
وحفلت السورة بآيات كثيرة لتثبيت قلب النبي في مواجهة عنت الكفار وادعاءاتهم عليه:
كما في الوعد السخي (وإن لك لأجرا غير ممنون)
وفي تخويف المشركين من العقاب بسرده (قصة أصحاب المزرعة ”الجنة“ المغرورين)
وفي سرد (قصة صاحب الحوت ”النبي يونس“).
بقيت الـ”نون” التي افتتحت بها السورة، وقد ذهب الباحثون في ذلك مذاهب. منها تفسير “عددي” يرى أن الحروف المقطعة في سورها هي أكثر الحروف تكرارا. وغير ذلك من المذاهب التي لا أظن أنها أتت بجواب شاف.
ورأيي هنا أنه لا توجد نظرية واحدة تفسر كل الحروف المقطعة في كل سور القرآن الكريم، بل إن لكل سورة تبدأ بحرف أو حرفين أو حروف مقطعة تفسيرا خاصا بها.
وفي سورة القلم أقول إن بدء السورة بـ”نون” هو مفتاح موسيقي يرتكز عليه القارئ في مطلع السورة. وما أعنيه بذلك هو أن القرآن أنزل ليقرأ، ومن هنا سمي قرآنا، والنون من الحروف التي يكثر دورانها في العربية، وتعرف بحروف “الذلاقة”، وهذه الحروف تسمح للقارئ بمد الصوت فيها مدا مستحبا للتنغيم، كما أن النون من الأصوات الأنفية التي تحلو معها الغنة، وهي خروج الهواء المصاحب للصوت من الأنف، والغنة مستحبة في إنشاد الشعر، وتلاوة القرآن، والغناء العربي بصفة عامة.
السبت ٣ رمضان ٢٠١٥
المهمة والتهيئة لها
في سورتي ”المزمل“ و”المدثر“ التاليتين من حيث ترتيب النزول، يحدد الله تعالى للنبي الكريم المهمة التي كُلف بها.
ومهمة محمد هي أنه سيكون رسولا يحمل للبشر رسالة، (أرسلنا إليكم رسولا) وهذا الرسول إما يبشر الناس، وإما ينذرهم، لكن الله تعالى اختار في تلك المرحلة المكية، والدعوة لا تزال في بداياتها، الإنذار أولا (قم فأنذر). وهو من بعد ذلك سيكون شاهدا على الناس: هل سمعوا، هل أطاعوا، هل عصوا؟ (أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم).
وسوف تتضح في قادم السور ملامح المهمة أكثر فأكثر. بل سيتضح أيضا ما يصاحب ذلك من عواقب ذكرها الله تعالى إن لم ينفذ محمد المهمة أو حاد عنها.
لكن السورتين تبدأان ببعض الاستعدادات التي تهيؤه محمدا لهذه المهمة. ومن هذه الاستعدادات توجيهات تعينه على الارتقاء الروحي، والاستعداد النفسي، حتى يقوى على ما قد يلاقي من الناس.
وذكرت السورتان منها قيام جزء من الليل تعبدا، (قم الليل)، وترتيل القرآن، (رتل القرآن)، واستحضار الله دوما وإعلاؤه، (واذكر اسم ربك)، و(ربك فكبر)، والانقطاع له تعبدا (تبتل إليه تبتيلا)، والاعتماد عليه (اتخذه وكيلا)، ثم الصبر على ما سيواجهه (اصبر على ما يقولون)، و(لربك فاصبر). وإن أراد تجنب قومه والابتعاد عنهم فليكن بعده دون نزاع (اهجرهم هجرا جميلا). والبعد الحقيقي ينبغي أن يكون عن ممارساتهم مثل عبادة الصنام والشرك (الرجز فاهجر).
ثم تشير ”المدثر“ إلى التهيئة الجسدية للمهمة (وثيابك فطهر).
ولم تدع السورتان ما قد يواجهه محمد من صعوبات ومشاق في الاستعداد وفي رد الفعل من الناس كليهما دون ذكر، بل فصلتا ذلك بجلاء.
فقيام الليل أمر شاق، ولذلك يقول القرآن الكريم – مهونا على محمد وصحبه – (إن ناشئة الليل هي أشد وطئا)، ويقول (علم أن لن تحصوه فتاب عليكم).
وما طلبه من قراءة القرآن هو فقط ما تيسر.
ويدرك الله أن هناك مرضى قد لا يستطيعون القيام أو القراءة، وهناك من يعملون طلبا للرزق، وهناك مقاتلون على رباط، وهؤلاء لا يريد الله أن يشق عليهم.
ونبه القرآن إلى بعض رد فعل متلقي الدعوة من الناس، من ادعاءات (هذا سحر يُؤثر)، واتهامات (هذا قول البشر)، وسخرية (إنها لإحدى الكبر. نذيرا للبشرا).
وفي مواجهة هذه الصعوبات، والاتهامات، والسخرية، وتحمل النبي لها، وحتى لا تنزع نفسه – وهو بشر – إلى المن على ربه بالتحمل، يلفت القرآن إلى سوء هذا الخلق فينهاه عنه (لا تمنن تستكثر)، وهذا من شيم الخلق العظيم الذي أكد القرآن على امتلاك محمد لزمامه.
الأحد ٤ رمضان ٢٠١٥
تثبيت قلب النبي
من حميد الخلق الذي أسبغه الله على محمد شكر المعطي والتواصل معه دوما بالدعاء، كما علمته (الفاتحة)، وهي السورة الخامسة من حيث ترتيب النزول.
ومع اشتداد عنت رافضي الدعوة الجديدة على النبي الكريم أخذ الله يثبت قلبه ويطمئنه بآيات تروي له كيف سيكون مصير عتاة الكفر، وما سيلاقونه من عذاب، كما تتوعد سورة (المسد) أبا لهب، عم محمد، وزوجته.
ويؤكد القرآن في السورة التالية (التكوير) نفي الجنون عن نبي الله عليه السلام، (ما صاحبكم بمجنون) وهي الصفة التي كان رافضو الدعوة ينعتون بها محمدا، كما رأينا في سابق السور. وينفي القرآن في السورة ذاتها أن يكون ما ينزل على محمد قول شيطان تلبسه (ما هو بقول شيطان رجيم)، بل يصفه بـ”الذكر“. ولأول مرة – منذ نزول الوحي – يتحدث القرآن هنا عن الوسيط الذي يأتي إليه بالوحي، جبريل، وبعض صفاته (إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين).
وفي السورة التالية (الأعلى) يشير القرآن إلى ”بشرية“ محمد بطريقة غير مباشرة. فمع توالي الوحي، وضرورة حفظه لإبلاغه للناس – وهو إنسان معرض للنسيان كغيره من البشر – يؤكد الله تعالى للنبي الكريم أنه هو الكفيل بذلك (سنقرئك فلا تنسى). كما يعود ويثبت قلبه بأنه معه يهون عليه الصعاب (ونيسرك لليسرى).
وتضاف في السورة ذاتها صفة جديدة للمهمة التي كلف بها محمد. فإلى جانب أنه ”رسول“، و”منذر“، و”شاهد“، فهو أيضا هنا ”مذكر“. كما جاء في قوله تعالى (فذكر إن نفعت الذكرى). ولا غرابة، ففحوى ما ينزل عليه هو ذاته فحوى ما جاء في (الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى).
ولا تزال السور التي أنزلت في تلك المرحلة الباكرة من الوحي تؤكد على بشاعة الطغيان بالمال والثراء، وتبكيت البخل وحب المال. وهي فكرة ذكرت في أول سورة (العلق)، وتكرر ذكرها فيما بعد، وأعيد مرة أخرى في سورة (الليل)، لمواجهة طغاة قريش من الأثرياء.
وتتكرر في السور في هذه المرحلة أيضا فكرة تثبيت قلب النبي الكريم في مهمته حتى لا يتزعزع أمام ما تلاقيه الدعوة من رفض. ورأينا في سابق السور كيف يطمئن القرآن قلب محمد بالحديث عما سيلاقيه المشركون من عذاب (المسد). لكنا نرى هنا في سورة (الفجر) تثبيتا بطريقة أخرى، وهي سرد قصص الأنبياء السابقين، وماذا فعل الله بأقوامهم وقد كفروا برسالتهم، مثل عاد، وثمود، وفرعون.
وذكر هذه القصص يأتي في صورة حوار مباشر موجه إلى النبي الكريم (ألم تر كيف فعل ربك ….). ويستمر توجيه الحوار خلال سرد القصة (فصب عليهم ربك …)، و(إن ربك لبالمرصاد)، و(وجاء ربك والملك صفا صفا).
الاثنين ٥ رمضان
بعض سيرة
في سورة (الضحى)، وهي السورة الحادية عشرة من حيث ترتيب النزول، جزء من سيرة محمد عليه السلام ورد خلال سرد هدف إلى طمأنته بعد انقطاع الوحي فترة من الزمن. ويأتي هذا في حوار موجه مباشر موجه إلى النبي الكريم.
إذ تؤكد السورة أن الله تعالى لم يترك محمدا ولم يهجره (ما ودعك ربك وما قلى)، ويعده بأن قابل الأيام أفضل من سالفها (وللآخرة خير لك من الأولى)، وأن عطاء ربه له سخي مُرضٍ (لسوف يعطيك ربك فترضى).
ولتأكيد هذا تستند السورة إلى سابق عهد محمد في صباه وشبابه، وقد فقد أباه فآواه الله تعالى (ألم يجدك يتيما فآوى). وكان تائها يبحث عن سبيل الرشاد فهداه (ووجدك ضالا فهدى).
ومن حظي بإيواء ربه عندما كان يتيما، وهداه حينما كان ضالا، حفي به أن يعامل اليتيم برفق (أما اليتيم فلا تقهر)، وأن يحنو على السائل وإن ألحف في السؤال (أما السائل فلا تنهر). وليكن ذكورا لنعم ربه شكورا له (أما بنعمة ربك فحدث).
وتستمر مرحلة تثبيت قلب النبي وطمأنته في سورة (الشرح). ويتلقى محمد من ربه في حوار مباشر هذا السؤال التقريري القوي الممتد على مدى أربع آيات (ألم نشرح لك صدرك)، و(وضعنا عنك وزرك)، و(رفعنا لك ذكرك). فقد تكفل الله تعالى به فشرح صدره إلى الإيمان، وبالنبوة، وخفف عن كاهله ثقل هذا العبء، ورفع مقامه بين قومه وبين الناس.
وتبشر السورة النبي بأنه مهما لاقى من عسر وصعاب من المشركين فسوف يعقبه فرج ويسر (إن مع العسر يسرا). وتلفت السورة انتباه النبي في آخر آيتين إلى مواصلة الدعاء والتضرع إلى الله شكرا.
ويتكرر نصح النبي بالتزام التصبر في سورة (العصر)، وتذكيره بعطاء الله في (الكوثر).
الثلاثاء ٦ رمضان ٢٠١٥
”قل“ وفحوى الرسالة
في السورة الثامنة عشرة (الكافرون)، ومرورا بالسورتين العشرين والحادية والعشرين (الفلق) و(الناس) وحتى السورة الثانية والعشرين (الإخلاص) تبرز ظاهرة جديدة وذات شأن في خطاب الله تعالى لمحمد عليه السلام، ألا وهي افتتاح الخطاب المباشر له بفعل الأمر ”قل“، (قل يا أيها الكافرون)، و(قل أعوذ برب الفلق)، و(قل أعوذ برب الناس)، و(قل هو الله أحد).
وقد تكرر هذا الفعل في القرآن الكريم كله ٣٣٢ مرة، ووروده في معظم تلك المرات جاء في سياق حوار يرد فيه القرآن على استفسار أو سؤال. وكم من مرة جوبه النبي الكريم في تلك المرحلة المكية من الدعوة بأسئلة يرمي بعضها إلى إحراجه، أو ربما تعجيزه، أو ربما التعرف على حقيقة نبوته. وما كان بوسع محمد عليه السلام أن يرد قبل أن يأتيه الوحي، فهو ليس مخولا إلا بالبلاغ.
وتسجل جميع الآيات الكريمات التي ورد فيها فعل الأمر ”قل“ هذه الحوارات جميعا، مصحوبة بأمر الله له ”قل“ كذا وكذا. ووجود هذا الفعل في القرآن الكريم أكبر تأكيد على حدود مهمة الرسول المكلف بإبلاغ رسالة للناس من رب العالمين، ولا يستطيع تجاوز تلك الحدود. وهو كذلك أكبر حجة على أن محمدا عليه السلام كان شديد الالتزام بما يوحى إليه يبلغه كما بلغه.
وليس معنى توجيه الخطاب في ”قل“ إلى محمد عليه السلام، أن بوسع أحد من اللاحقين حذف الفعل، بعد وفاة النبي.
وجاءت سورة (الإخلاص)، أو (التوحيد) كما سميت أيضا، ملخصة لفحوى الرسالة، وهو الوحدانية، فـ(الله أحد)، (لم يلد)، و(لم يولد)، وليس له نظير أو شبيه (لم يكن له كفوا أحد).
وبذلك أصبحت الدعوة الجديدة التي بلغ بها النبي واضحة الأساس، متميزة من غيرها. ولذلك ما كان يستطيع مبلغ الرسالة أن يهادن، فيقبل أي عرض، من الكافرين أو من غيرهم (قل يا أيها الكافرون …)، (لا أعبد ما تعبدون)، فأنتم في اتجاه وأنا في طريق آخر جد مختلف، (ولا أنتم عابدون ما أعبد)، (ولا أنا عابد ما عبدتم).
ونلاحظ هنا كيف فصل خطاب الله تعالى للنبي محمد عليه السلام دعوة الإسلام عن أي معتقد آخر، لكنه لم يفعل ذلك بقتال المخالفين له، بل بالقول الحسن.
بقيت السورتان المعروفتان بالمعوذتين. وفيهما أيضا خطاب للنبي الكريم باللالتجاء دوما إلى ربه احتماء به من شرور الخلق ومن شرور الشياطين والجن.
الأربعاء ٧ رمضان ٢٠١٥
ما ينطق عن الهوى
في سورة (النجم)، وهي السورة الثالثة والعشرين بحسب ترتيب النزول المتداول، يُوجَه معظم الحديث – بعد القسم – إلى أهل مكة حيث أنزلت تلك السورة المكية. ثم يخاطب القرآن الكريم محمدا عليه السلام، ليعود ويختتم السورة بخطاب أهل مكة مرة أخرى.
ويتركز خطاب القرآن الكريم مع أهل مكة على “صاحبهم” محمد، الذي هو واحد منهم عرفوه وخبروه، وعلى صفاته، ورسالته، وعلى جبريل عليه السلام، وهو من اختاره الله تعالى من الملائكة ليبلغه الرسالة.
ويجب أن أشير هنا إلى التشابه الموجود بين سورة (التكوير) وسورة (النجم) من حيث القسم بآيات الله تعالى في السماوات العلى (الشمس، النجوم، النجم). وتتشابه السورتان أيضا في ذكر صفات النبي الكريم، وذكر جبريل وصفاته أيضا.
غير أن سورة (النجم) تمتاز من غيرها بأن القرآن الكريم يذكر فيها لأول مرة أسماء الأصنام التي كان يعبدها مشركو مكة. وفي السورة إشارة إلى المعراج، الذي قد يكون فيه وفاء بما وعد الله به نبيه الكريم في سورة (الضحى) بأن قابل الأيام سيكون خيرا من سالفها، بعد فترة انقطاع الوحي.
وكان القرآن الكريم قد نفى عن محمد عليه السلام في سورة (التكوير) صفة ”الجنون“ التي نعته بها رافضو الدعوة، وهو هنا ينفي صفة أخرى عن شخصه الكريم، هي صفة الضلال وخيبة السعي، (ما ضل صاحبكم وما غوى). ووصف ”صاحبكم“ الذي استخدمته الآية الكريمة ذو دلالة عميقة، فهو منكم ويعيش بينكم، فكيف تحكمون عليه بـ(الضلال وخيبة السعي) وأنتم تعرفونه.
فمحمد عليه السلام رجل من البشر ذو عقل سليم، هداه الله تعالى إلى طريق الإيمان والرشاد، وكان سعيه مفلحا في البحث عن الهداية.
وهنا تضيف السورة صفة أخرى ذات شأن عظيم في فهم شخصية محمد الرسول المبلغ عليه السلام. فبالرغم من أنه بشر، فإنه عندما ينطق بآيات الوحي المنزل، فإنه (ما ينطق عن الهوى)، فلا يتبع أهواء نفسه عندما يلفظ ما يبلِّغ به.
ثم يؤكد الله تعالى أن هذا القرآن الذي يُنزّل على محمد عليه السلام (إن هو إلا وحي يوحى)، رادا بذلك على تكذيب أهل مكة وادعاءاتهم بأنه إفك، أو أنه اكتتبه. ولا بد أن أشير هنا إلى أن الضمير ”هو“ في (إن هو إلا وحي) يعود على القرآن الكريم. ويؤكد ذلك الآيات التالية التي تتحدث عن جبريل عليه السلام. فهو من علَّم النبي الكريم هذا القرآن (علمه شديد القوى).
وقد فسر بعض المفسرين هاتين الآيتين (ما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى) تفسيرا نحوا فيه نحوا غريبا. إذ قالوا إن ”كل ما ينطق به الرسول من قرآن و(سنة) وحي“. ومن باب هذا التوسع في دلالة الآية يدخلون أحاديث ظنية في باب الوحي، فيسبغون عليها قدسية تعادل قدسية القرآن الكريم، فيحرم المساس بها، أو مناقشتها. ثم يبنون عليها من بعد نتائج خطيرة يتعلق بعضها بعقيدة المسلم وشعائره.
ولا يدعم السياق الذي وردت فيه الآية الكريمة، ولا تركيبها اللغوي هذا المنحى في تفسيرها. فالآية نزلت لترد على افتراءات أهل مكة وتكذيبهم للقرآن الكريم، والضمير فيها لا يعود إلا على القرآن الذي كُلف محمد عليه السلام بإبلاغه للناس. ثم إن الآيات التالية تعضد هذا الفهم، لأنها في جملتها تدور على القرآن الذي يوحى به إلى محمد عليه السلام بواسطة جبريل عليه السلام، الذي تتحدث الآيات التالية عن صفاته.
وثمة خطورة كبيرة في تبني نهج توسيع دلالة اللفظ، وغض النظر عن سياق الآيات السابقة واللاحقة والتركيب اللغوي. وهو من أسف منهج شائع بين ثلة كبيرة من المسلمين، في تناول آي القرآن الكريم. وبتطبيق النهج نفسه يستطيع أي مغرض الافتراء والطعن في كتابنا الكريم.
وفي ختام السورة – وبعد حديثها عن أصنام أهل مكة – يتوجه القرآن الكريم إلى النبي بالحديث، ناصحا له بالإعراض عمن تولى عن ذكر الله تعالى. وفي الحديث تأنيب لطيف لمحمد (فبأي آلاء ربك تتمارى)، حتى لا يتشكك.
ثم يرد تقرير يؤكد أن هذا القرآن ”نذير“، مثل النذر الأولى التي قد يكون قد سبق ذكرها، (هذا نذير من النذر الأولى)، وهي صفة لمهمة النبي الكريم سبق ورودها من قبل.
الخميس ٨ رمضان ٢٠١٥
للفقير والغني
في السورة الرابعة والعشرون (عبس) نواجه لأول مرة في خطاب القرآن الكريم للنبي بعتاب محمد. لكن صيغة العتاب ليست مألوفة.
إذ تبدأ السورة بسرد يحكي عن شخص غائب: (عبسَ) تجهمَ و(تولى) وازورَّ والتفت وابتعد بنفسه، عندما جاءه رجل أعمى (قيل إنه عبد الله بن أم مكتوم).
ثم يوجه القرآن الخطاب إلى محمد مباشرة في الآية التالية، (وما يدريك؟)، وقد عاتبه بلطف وكأنه يتكلم عن شخص ثالث هو الذي توجه إليه بالعتاب.
ولكن لماذا يعاتب الله تعالى محمدا؟ لأنه – كما تقول الروايات – تجهم لما رأى هذا الرجل الأعمى، وكان يحاور – عند قدومه – بعض كبراء وأثرياء مكة محاولا إقناعهم، فأعرض عن هذا الأعمى، وظل ملتفتا إلى كبراء قريش.
وما كان ينبغي على النبي الكريم أن يُعرض عن الأعمى – لفقره ووضعه – ويُولي اهتمامه لهؤلاء الأثرياء لأن في إقناعهم نصرة وعزا للدين الجديد! فليس هكذا يكون مسلك النبي الذي يرعاه ربه بالتربية، وهو بشر قد يخطئ وقد يصيب، ولذلك وجب توجيهه، لأنه بشر.
وربما يجد بعض المسلمين في ذلك أمرا لا يقبلونه على النبي الكريم، الذي يجلون قدره، ويعلون شأنه، ويصعب عليهم قبول فكرة معاتبة الله له. ولهذا السبب ذهب بعض المفسرين إلى أن العتاب في مفتتح السورة، لم يكن موجها لمحمد، بل كان موجها لشخص آخر، قالوا إنه عمر بن الخطاب.
لكني أعتقد أنه لهذا السبب عينه عاتب الله تعالى النبي، ليؤكد لتابعيه وأنصاره أنه بشر، قد يخطئ، وإن أخطأ في التصرف وجب لفت انتباهه لأنه رسول كريم، خلقه رفيع.
وتختتم السورة مقطع العتاب بكلمة ردع (كلا)، حتى لا يقع محمد في مثل هذا التصرف مرة أخرى، (كلا، إنها تذكرة)، فهذه تذكرة لك.
وإلى جانب بشرية النبي التي يدور هذا المقطع الأول من السورة عليه، يلفت خطاب الآيات للنبي الكريم إلى نقطة جوهرية في مهمته التي كُلف بها، وهي أنه فقط مذكر ومنذر للفقير والغني، وليس عليه التحقق من النتيجة، (ما عليك ألا يزكى).
السبت ١٠ رمضان ٢٠١٥
ليلة ذات قدر والمرويات الظنية
قد لا يوجد في كثير من سور هذه المرحلة المكية التي لما نزل نتابعها حتى الآن خطاب موجه للنبي الكريم، أو آيات فيها بعض من وصف القرآن الكريم له. غير أن في كثير من سور تلك المرحلة حديثا عن آيات الله الكونية، وحديثا عن الآخرة، والقيامة، وفيها أيضا بعض من قصص الأنبياء السابقين، وأحوال أقوامهم معهم، يهدف إلى تثبيت قلب النبي الكريم عندما يواجه من قومه عنتا أو إيذاء ليقوى على التصبر فيما كلف به.
وينطبق هذا الذي وصفت هنا على السور من الخامسة والعشرين (القدر)، ومرورا بالسادسة والعشرين (الشمس)، والسابعة والعشرين (البروج)، والثامنة والعشرين (التين)، والتاسعة والعشرين (قريش)، حتى السورة الثلاثين (القارعة).
لكن تلك السور مع ذلك، لا يزال الحديث فيها موجه إلى محمد عليه السلام، بل إن القرآن كله من أول آية فيه وحتى آخر آية فيه، موجه إليه. لكن توجيه الخطاب للنبي يظهر بجلاء عند الحديث – مثلا – عن أمور ترد لأول مرة وليس للنبي علم بها. ففي سورة (القدر) وعند الحديث عن ”ليلة القدر“، يقول الله تعالى (وما أدراك ما ليلة القدر)، وفي (القارعة)، (وما أدراك ما القارعة)، لأن تلك أوصاف لا يدري عنها النبي الكريم شيئا، ولابد من إعلامه بها.
ويتجه القرآن كذلك بالخطاب للنبي عليه السلام في بعض من تلك السور عند الحديث – مثلا – عن عذاب الكافرين يوم القيامة، وما سيلاقونه من مصير، لتثبيت قلبه. ففي سورة (البروج) يتوجه القرآن بالخطاب إلى محمد عليه السلام – خلال الحديث عن أصحاب الأخدود، وعمن فتنوا المؤمنين، والفوز الكبير للمؤمنين – لافتا نظره إلى عذاب الكافرين ليطمئن قلبه، (إن بطش ربك لشديد)، ثم ينبهه إلى ما دار في الماضي من قصص الأنبياء السابقين (هل أتاك حديث الجنود).
وقبل أن أترك هذه المجموعة من السور، لابد من وقفة عند سورة (القدر)، التي تتحدث عن نزول القرآن الكريم فيها (إنا أنزلناه في ليلة القدر). إذ إن القرآن الكريم – كما تقول المرويات – أنزل في تلك الليلة من اللوح المحفوظ، ولنلاحظ استخدام القرآن الكريم للفعل (أنزلناه) الذي يدل على الإنزال مرة واحدة. ثم أخذ جبريل من بعد ينزّل الآي منجمة بحسب الأحداث. ولنلتفت إلى الفعل ”نزَّل“- مثلا – في (إنا نحن نزَّلنا الذكر وإنا له لحافظون)، الذي يدل على تعدد الإنزال.
ومن هنا يأتي ”قدر“ تلك الليلة التي أنزل فيها القرآن كله، والتي هي أكثر خيرا من ألف شهر.
غير أن من بين المرويات – خاصة في باب أسباب النزول الذي ينبغي أن نأخذه بحيطة شديدة جدا لأن فيه كثيرا من الروايات الظنية – أمورا تثير الضحك، ولا يقبلها العقل على الله جل شأنه، ولا على نبيه المكرم. من ذلك ما قاله بعض المفسرين في سورة (القدر) من أن ”رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر، فتعجب المسلمون من ذلك. فأنزل الله تعالى إنا أتزلناه في ليلة القدر …“، ناسبا تلك الرواية إلى النبي عليه السلام، الذي يختتمها – كما يقول رواة الحديث – بقوله ”قال خير من التي لبس فيها السلاح ذلك الرجل“.
الأحد ١١ رمضان ٢٠١٥
مشاهد !
في السورة الحادية والثلاثين (القيامة)، بحسب ترتيب النزول الذي نتبعه في هذه اليوميات، يذكر القرآن القيامة بالاسم للمرة الثانية. وقد سبق وذكر ”يوم القيامة“ في السورة الثانية (القلم)، لكن سورتنا هذه فيها تفصيل لهذا اليوم، يهدف إلى إقناع المشككين في البعث.
ويرسم القرآن الكريم صورة لمشهد هذا اليوم ترى فيها القمر والشمس، خسفا وجمعا، ثم يخاطب القرآن محمدا عليه السلام وكأنه جزء من المشهد (إلى ربك يومئذ المستقر). ثم تنقلنا الآيات إلى مشهد آخر، هو مشهد الاحتضار واقتراب الموت، ومحمد أيضا حاضر يشاهد ما يحدث (إلى ربك يومئذ المساق).
ومع نزول هذه السورة، كانت آيات الله قد أخذت تتوالى على النبي الكريم، فكثرت عليه، وربما خشي – وهو بشر – أن يتفلت منه شيء من القرآن، فكان فيما يبدو حينما يأتيه جبريل يعجل في القراءة. وفي سورتنا هذه يطمئنه الله تعالى بقوله (لا تحرك به لسانك لتعجل به)، إذ عليه أن يتمهل في القراءة. وكان الله تعالى قد طمأنه من قبل في السورة الثامنة (الأعلى) بأنه (سنقرئك فلا تنسى، إلا ما شاء الله).
وتعود الآيات لتؤكد للنبي الكريم – مرة أخرى- أن الله سبحانه متكفل بجمع القرآن في صدره ومنحه القدرة على قراءته (إن علينا جمعه وقرآنه). ثم إذا أنزله تعالى عليك فاستمع له وأنصت (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه).
وقد يكون في تلك الآيات إشارة إلى ما تذكره بعض المرويات، وهي أن القرآن الكريم عندما أنزل من اللوح المحفوظ كله مرة واحدة إلى السماء الدنيا – كما رأينا في سورة (القدر) – أودعه جبريل صدر النبي الكريم. ثم كان يأتيه عند كل حادثة بالآية، أو الآيات، المناسبة للحادثة، فيقرأها عليه. ولعل في الآية الكريمة (إنا علينا جمعه) إشارة إلى ذلك، وكأنه مجموع بالفعل في صدر النبي الكريم.
وتستكمل الآيات طمأنة محمد عليه السلام بالقول (ثم إن علينا بيانه). وهنا يتجه المفسرون اتجاهين مختلفين في تفسير هذه الآية.
يقول بعضهم إن النبي الكريم كان يتعجل في سؤال جبريل عن بيان المعاني، كما كان يعجل في القراءة. ويقول آخرون إن المقصود بالبيان هنا هو بيان الحلال والحرام في الآيات.
أما أنا فأذهب مذهبا مختلفا عن هذين الرأيين في تفسير الآية، في اجتهاد لي أرجو أن يكون صائبا.
أقول إن في الآيات الثلاث خطابا مباشرا من الله تعالى إلى نبيه الكريم، يطمئنه فيه بأنه جل شأنه سيعطي محمدا القدرة على حفظ القرآن (إن علينا جمعه)، والقدرة على قراءته أمام تابعيه (وقرآنه)، كما أقرأه إياه جبريل. وليس على النبي إلا اتباع ما قرئ عليه بالاستماع والإنصات.
ولنلاحظ هنا أولا استخدام القرآن للتأكيد بـ”إنَّ“ في الآية الأولى (إن علينا جمعه وقرآنه)، ثم استخدام حرف العطف (ف) الدال على الترتيب من حيث الحدوث (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه). أما الآية الثالثة فسبقت بحرف العطف (ثم) الدال على التراخي، أو مرور فترة من الزمان (ثم إن علينا بيانه).
ولا أعتقد أن لجبريل عليه السلام شأنا في بيان القرآن، بحسب الآية. ولا أظن أن البيان متعلق بالحلال والحرام. لكني أعتقد أن في الآية إشارة إلى أن ما يلي من آيات الكتاب نزولا سيتكفل ببيان معانيه، فالقرآن الكريم يفسر بعضه بعضا.
وفي الآية أيضا – بتركيبها اللغوي المؤكد، باستخدام إنَّ، والمسند إلى صيغة ضمير الجمع في (علينا)، تعظيما لشأن الله تعالى الذي تكفل وحده بالبيان (ثم إنَّ علينا بيانه) – إشارة مهمة، ألا وهي أن بيان معاني القرآن ليس جزءا من مهمة محمد عليه السلام، بل هو مسند إلي الله تعالى وحده. ولذلك لم يخض النبي الكريم – بحسب علمي وفهمي للآية – في هذا الباب.
الاثنين ١٢ رمضان ٢٠١٥
ما أنت عليهم بجبار !
ما زلنا نتابع سور القرآن الكريم بحسب ترتيب نزولها بحثا عن صورة النبي فيها: كيفية مخاطبة الله تعالى له، وتحديد مهمته، وأوصافه.
وهنا نتوقف عند السورة الثانية والثلاثين (الهمزة) التي ليس فيها خطاب موجه إلى النبي الكريم إلا من خلال تعريفه بصفة جديدة من صفات النار التي يهدد القرآن الكريم بها كل (هُمزة)، (لُمزة)، من (جمع مالا وعدده). وهذه صفات ذميمة قد تكون تجسدت في أشخاص عند نزول السورة، عرفوا بكثرة الغيبة للناس، والعيب فيهم، وتكديس المال دون إنفاقه. ومآل هذا النوع من الناس هو النار التي تحطم كل ما يقع فيها، الحُطمة. و(ما أدراك ما الحطمة)، (نار الله الموقدة).
أما السورة الثالثة والثلاثون (المرسلات)، فتدور – بعد القسم في مطلعها – على نذر القيامة، عندما تطمس النجوم، وتشقق السماء، وتنسف الجبال، ويجمع الرسل للفصل بينهم وبين أقوامهم. وهذا هو (يوم الفصل)، وهو وصف جديد من أوصاف يوم القيامة يعرف القرآن محمدا عليه السلام به مخاطبا إياه (وما أدراك ما يوم الفصل).
غير أن السورة الرابعة والثلاثين (قاف) تبدأ – بعد القسم بالقرآن المجيد – بوصف مهمة النبي الكريم (بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم)، المتمثلة في أنه ”منذر“. وتقص السورة ما لاقاه الرسل السابقون، مثل نوح عليه السلام، من عنت من أقوامهم، لتثبت قلب محمد عليه السلام.
ثم تأمره الآيات بالصبر (فاصبر على ما يقولون). وتتابع السورة هنا نهج التربية الروحية للنبي الكريم الذي رأيناه من قبل في سور سابقه، فتنبهه إلى أهمية ذكر ربه وتسبيحه سبيلا لهذه التربية الروحية المهدئة للنفس، في أوقات مختلفه، (سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه، وأدبار السجود). ولنلتفت إلى تلك الأوقات:
* في هدأة الكون بعيد الفجر، وقبل طلوع الشمس (في أول النهار)
* وقبل غروب الشمس، عند اقتراب (انتهاء النهار)
* وعند مولد الليل
* وعقب الصلوات
وفي مشهد من مشاهد يوم القيامة، التي تصفها السورة، عندما ينادى المنادي، نجد محمدا عليه السلام جزءا من المشهد بتوجيه الخطاب إليه (واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب).
ثم تختتم السورة بصفتين مهمتين من صفات هذا النبي الكريم. أما الصفة الأولى فهي الدعوة إلى الله بلا إجبار (ما أنت عليهم بجبار). والصفة الثانية هي – كما رأينا من قبل في سورة (عبس) – أنه ”مُذكّر“، (فذكر بالقرآن من يخاف وعيد).
فلم يكن نبينا الكريم – بحسب وصف القرآن المجيد هنا – إلا ”مُذكّرا“ للناس، ومن خاف اتبع وانصاع، ومن تجبر فليس لمحمد من سبيل عليه.
ولم يكن نبينا الكريم أبدا مُجبِرا أحدا على الدعوة، بل داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة، والموعظة الحسنة.
وأين هذه الصورة الكريمة مما نراه اليوم من أقوام غلاظ، أفظاظ، ما تدبروا كتاب الله.
الثلاثاء ١٣ رمضان ٢٠١٥
(العقبة): مفهوم جديد
عرفنا من سابق السور التي تناولناها في هذه اليوميات، كيف نشأ محمدا عليه السلام يتيما فكان له من ربه خير إيواء، وكيف كان يبحث عن الهداية وسط أجواء يتعبد فيها قومه حجارة تقربهم بزعمهم إلى الله تعالى، فهداه الله. وكيف كان فقيرا فأغناه الله تعالى.
وهنا في سورة (البلد)، وهي السورة الخامسة والثلاثون من حيث ترتيب النزول، نتعرف على موطن النبي الكريم ومكان إقامته، مكة، من خلال القسم في بداية السورة (لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد).
وفي السورة أيضا تعبير بلاغي جميل يصور مكابدة الإنسان لنوازع النفس، ونزغ الشيطان، بحال شخص يجاهد لاقتحام طريق وعر (عقبة). ثم تُسائل الآيات النبي الكريم (وما أدراك ما العقبة؟).
مثل هذا السؤال، بمثل هذه الصيغة، باستخدام الفعل (أدراك)، يعني أن القرآن الكريم سيعرض في عقبه جوابا، أو تعريفا، جديدا، أو غير مألوف، على النبي، وهذا هو المفهوم القرآني للكلمة قيد التساؤل. وقد رأينا من قبل مفهوم القرآن لـ”القارعة“، و”الحطمة“، و”يوم الفصل“.
فما هو إذن المفهوم القرآني لـ”العقبة“، بعيدا عن هذه الصورة البلاغية التي عرضتها الآيات الكريمات؟
إنه مفهوم يقتضي سلوكا عمليا، يعود بالنفع على الجماعة، ويتمثل في:
* (فك رقبة)، عتق رقبة وإنقاذها من العبودية.
* (إطعام في يوم ذي مسغبة)، إطعام نفس جائعة في وقت ضيق أو شدة. وهنا تفصيل لأولويات في هذا المسلك العملي في تقديم الطعام: إما لـ(يتيما ذا مقربة)، من ذوي القربى، وأما لـ(مسكينا ذا متربة)، لرجُل لا يمتلك وسيلة لكسب العيش يعاني من شدة الفقر.
* (ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة)، وأن يسبق هذا وذاك إيمان بالله تعالى، وتمسك بفضيلة الصبر على ما يواجهه، وفضيلة الرحمة في التعامل مع الآخرين ومواساتهم.
وتصوروا معي مجتمعا يحرص أفراده – في معاركتهم للحياة ومجاهدة النفس – على إنقاذ العبيد وتحريرهم، حتى يصبح كل أعضائه أحرارا. ويحنو فيه كل واحد منهم على اليتامى والمساكين فيطعمونهم إن كانوا بحاجة إلى إطعام. ويتصف أفراده بالإيمان الذي يتذرع بالصبر، ويجمُل بالرحمة.
ترى كيف سيكون ذلك المجتمع؟ هذا هو المفهوم القرآني لـ(العقبة)، الذي علمه الله تعالى لنبيه الكريم، الذي رباه فأحسن خلقه.
لكن أين نحن اليوم من هذا المفهوم السمح الحاني المتعاطف المتكاتف؟
الأربعاء ١٤ رمضان ٢٠١٥
فضيلة الصبر، مرة أخرى
في سورة الطارق، وهي السورة السادسة والثلاثون من حيث ترتيب النزول، خطابان موجهان إلى النبي الكريم، في أول السورة وفي آخرها.
أما أولهما ففيه لفت لنظر النبي الكريم إلى كلمة جديدة يريد القرآن التوقف عندها. إذ يساءل القرآن محمدا عليه السلام – بعد بدء السورة بالقسم بالسماء، وبالطارق – (وما أدراك ما الطارق؟)، ليعرّفه بأنه (النجم الثاقب) الشديد البريق واللمعان.
والقسم في القرآن الكريم لا يكون إلا بشيء عظيم ذي شأن وتأثير في حياة البشر.
أما الخطاب الثاني في نهاية السورة ففيه دعوة للنبي – بعد أن طمأنه الله تعالى بأن الله سيرد عنه كيد المشركين (يكيدون كيدا وأكيد كيدا)، إلى أن يتصبر على ما يواجهه منهم، ويمهلهم قليلا (فمهل الكافرين، أمهلهم رويدا).
وفي هذا درس للنبي الكريم، ودرس لأتباعه من بعدُ، بأن يتحلى بالصبر في الدعوة إلى الرسالة الجديدة، وأن يتحمل مشاقها. وهذا جزء من التربية الروحية التي أخذ القرآن الكريم ينشئ عليها محمدا عليه السلام منذ أول آية نزلت عليه، وحتى الآن.
فلم تكن تعاليم الرسالة الجديدة التي لا يزال يحملها الوحي إليه جزءا جزءا، تشمل فقط ما ينبغي أن يبلغه قومه، بل كانت تضم في طياتها دليلا للنبي الكريم – ولأتباعه من بعده – في كيفية التعامل مع الناس، وما يحتاجه خلال ذلك من فضائل تُربّيه عليها الآيات رويدا رويدا.
وهكذا تعهده الله تعالى منذ اختياره للمهمة وتكفل بتنشئته، على الخلق العظيم، وجميل الصبر، والتحمل من أجل الوصول إلى تحقيق مهمة الدعوة إلى الله.
الخميس ١٥ رمضان ٢٠١٥
هل من مدكر؟
تبدأ السورة السابعة والثلاثون (القمر)، بحسب ترتيب النزول، بحديث عن الساعة، أو يوم القيامة، لكنه حديث في أسلوب سردي في صيغة الماضي (اقتربت الساعة وانشق القمر)، ولم يأت – كما رأينا من قبل في أسلوب قسم، مثل (لا أقسم بيوم القيامة).
وقد يفهم من الآية الكريمة أن ما تتحدث عنه قد وقع بالفعل، لأنه جاء في صيغة الماضي. وهذا ما فهمه بعض المفسرين الذين تحدثوا عن حدوث انشقاق للقمر في حياة النبي عليه السلام. وقالت روايات إنه وقع بالفعل في السنة الخامسة قبل الهجرة.
لكن صيغة الماضي في الآية الكريمة ليست دليلا على حدوث انشقاق القمر بالفعل، لأن استخدام الماضي هنا – من الناحية البلاغية – يدل على تأكيد اقتراب حدوث الفعل، وكأنه قد وقع وانتهى.
ولذلك أقول إن من علامات اقتراب الساعة، التي تتحدث عنها السورة، انشقاق القمر. ولعل في ورود فعل (اقتربت) بالنسبة إلى الساعة، وفعل (انشق) بالنسبة إلى القمر، معطوفين في جملة واحدة تأكيدا على تلازمهما عند الحدوث، وهو أمر لا يعلم به النبي الكريم بعد، فأراد الله تعالى أن يعرفه به.
لكن موقف المكذبين بيوم القيامة لا يتغير حتى مع رؤيتهم لآياتها عندما تحدث، بل سيرون في ذلك سحرا. ولذلك يأمر الله تعالى محمدا عليه السلام – في خطاب مباشر – (فتول عنهم)، بأن يعرض عنهم، ولا يجادلهم، حتى يأتي يوم القيامة الذي سيكون عليهم يوما عسيرا. وهذا الأمر هنا يذكرنا بما أمره به الله تعالى في سورة (الطارق) من إمهال (فمهل الكافرين، أمهلهم رويدا).
ولا بد أن نؤكد هنا على أمر الله سبحانه لنبيه الكريم بالإعراض عن المكذبين، وعدم مجادلتهم، وإمهالهم، إنما يهدف إلى التأكيد على أن مهمة النبي ليست إلا أن يذكر قومه، وينبههم، وليس عليه أن يؤمنوا.
ومن أساليب الإقناع العقلي التي يستخدمها القرآن الكريم – خاصة في العهد المكي – سرد قصص الأنبياء السابقين، وحال أقوامهم معهم. وفي ذلك طمأنة وتثبيت لقلب النبي الكريم، كما أن فيه دعوة للمشركين والكافرين إلى التفكير في حال من سبقوهم، وكيف كان مصيرهم، عساهم أن يرعووا ويرجعوا، ويؤمنوا في نهاية المطاف. وتلك مهمة هذا السرد في تلك القصص.
وهذا هو الأسلوب الذي تستخدمه الآيات في سورة (القمر) في وضوح وجلاء.
إذ تورد السورة قصة نوح عليه السلام، ثم قصة عاد، ثم قصة ثمود، ثم قصة لوط، ثم قصة فرعون.
وتستخدم الآيات الكريمات في هذه السورة طريقة سردية فريدة في رواية تلك القصص. إذ تفصل بين كل قصة وأخرى بفاصلة تؤكد الهدف من وراء سرد القصة. وهذه الفاصلة تأتي عقب نهاية السرد، وقبل بدء القصة التالية، وهي (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟).
واستخدمت هذه الفاصلة الهادفة في السورة أربع مرات، عقب القصص الأربع الأولى. ولم تستخدم عقب قصة فرعون. وقد سبقت هذه الفاصلة في تلك المواضع بآيات متشابهة تنبه السامعين إلى التفكر في العذاب الذي لحق بالقوم في القصة.
ففي عقب قصة نوح تقول الآيات (فكيف كان عذابي ونذر). وعقب قصة عاد، (فكيف كان عذابي ونذر)، وفي نهاية قصة ثمود، (فكيف كان عذابي ونذر)، وفي أعقاب قصة لوط (فذوقوا عذابي ونذر)
وبعد سرد تلك القصص، تتوجه الآيات بالخطاب مباشرة إلى كفار قريش، (أكفاركم خير من أولئكم، أم لكم براءة في الزبر) حتى لا يأخذهم الغرور، بكثرتهم، مهددة إياهم بالساعة التي بدأت بها السورة الكريمة، (بل الساعة موعدهم، والساعة أدهى وأمرّ).
ثم يبدأ وصف مشهد من مشاهد القيامة عندما يلاقي الكافرون مصيرهم، ويسحبون في النار. ثم مشهد المتقين في جنات ونَهر.
وكم يحس قارئ السورة، ومستمعها، بجمال التركيب اللغوي فيها، حيث التزمت السورة بفواصل تنتهي كلها بصوت (الراء) في ختام كل آياتها من أولها إلى آخرها.
وهذا من خصائص سور العهد المكي التي تتسم بقصر الآيات، والحفاظ على فاصلة صوتية يتكرر فيها صوت أو صوتان، لأن القرآن الكريم كتاب أنزل ليُقرأ. وهذا واضح من اسمه (قرآن)، وتؤدي فيه موسيقى الأصوات دورا أساسيا، خاصة في السور المكية.
الجمعة ١٦ رمضان
حوار وحوار
تحفل السورة الثامنة والثلاثون (صاد) بالكثير من ”الحوار“:
* حوار بين مشركي قريش بعضهم بعضا.
* وحوار أو خطاب من الوحي إلى محمد عليه السلام.
* وحوار بين داوود عليه السلام والخصمين اللذين تسلقا سور مكان تعبده.
* وحوار بين سليمان عليه السلام ومن حوله.
* وحوار بين أيوب عليه السلام وربه تعالى.
* وحوار بين أهل النار بعضهم بعضا.
* وحوار بين محمد عليه السلام وقومه.
* ثم حوار بين الخالق سبحانه وتعالى والملائكة، وبينه وبين إبليس.
وتهدف هذه الحوارات جميعا إلى دعم النبي الكريم في دعوته، وإثبات صدقه وأنه يبلغ عن ربه ولا يختلق ما يقوله لقومه، وتثبيت قلبه في مواجهة طغاة قومه وعنتهم، بسرد قصص بعض من سبقوه من الأنبياء، وكيف كان مصير أقوامهم. ثم التعرف على الطبيعة البشرية لهؤلاء الأنبياء وما قد يقعون فيه من أهواء، وتنبههم إلى ذلك وإنابتهم إلى الله تعالى.
وفي السورة تأكيد على أن مهمة محمد عليه السلام إنما هي التذكير والإنذار، وأنه لا يعلم إلا ما يبلغه به ربه.
ومن هذا الباب بدء السورة بـ”الذكر“، في أولها (صاد والقرآن ذي الذكر)، أي الذي أصبح الآن بعد مرور فترة من نزوله على النبي الكريم، ذائعا معروفا ومذكورا في حوارات القوم، ثم ختامها أيضا بالذكر، في نهايتها (إن هو إلا ذكر للعالمين)، أي تذكير لهم.
وبين هذا وذاك وردت في السورة مشتقات ”الذكر“ غير مرة، في ”أنزل عليه الذكر“، و”هم في شك من ذِكرى“، و”اذكر“ التي استخدمت أربع مرات في السورة، صيغة أمر للنبي الكريم، وفاصلة أسلوبية بين كل قصة وأخرى من قصص الأنبياء.
* (واذكر عبدنا داوود …)
* (اذكر عبدنا أيوب …)
* (واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق …)
* (واذكر إسماعيل واليسع …)
ولايزال القرآن الكريم حتى هذه اللحظة من نزول الوحي، يحث محمدا عليه السلام – في خطاب مباشر – على التحلي بالصبر، (اصبر على ما يقولون)، معضدا ذلك بتذكيره بالسابقين من الأنبياء.
وفي السورة ذكر لنوح، ولوط، وداوود، ابنه سليمان، وأيوب، وإبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، وإسماعيل، واليسع، وذي الكفل عليهم السلام.
ومن بين الأساليب التي توظفها الآيات الكريمات في مخاطبة النبي، لاستثارة انتباهه (هل أتاك نبأ …).
وفي تلك القصص – خاصة قصص داوود، وسليمان، وأيوب – إشارات مهمة يلفت القرآن من خلالها نظر النبي إليها، ليعلمه بعضا من خصائص الخلق العظيم.
فقصة داوود مع الخصمين اللذين طلبا منه الحكم في نزاعهما، تهدف إلى أن تعلم محمدا ومن يتبعونه ألا يتسرعوا في الحكم، إلا بعد سماع حجة الخصمين، وألا يحكموا متأثرين بهوى، (يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله).
وفي قصة سليمان تنبيه إلى ألا يكون في حب خيرات الدنيا، وما بها من ملك، مدعاة لنسيان ذكر من أعطاك الخير، وضرورة الاستغفار، حتى ممن حظوا بمرتبة النبوة.
أما قصة أيوب ففيها درس مهم للنبي في الصبر على البلاء، وهنا الابتلاء بالمرض.
ثم يتكرر في السورة – مرة أخرى – الأمر لمحمد بالفعل ”قل“، ثلاث مرات:
* (قل إنما أنا منذر …)، محددا مهمته في ”الإنذار“، في أسلوب قصر مؤكد لهذا.
* (قل هو نبأ عظيم …)، محددا خطورة القرآن التي لا يدركها قومه المنذرين به.
* (قل ما أسألكم عليه من أجر، وما أنا من المتكلفين). نافيا أي مأرب مادي لمحمد من وراء الرسالة. ونافيا أيضا أن يكون محمد مختلقا، أو متصنعا لما يبلغ قومه به، بل هو بلاغ من الله، وليس لمحمد أي مطمع من ورائه.
السبت ١٧ رمضان ٢٠١٥
وهم ”الحور“ في الجنة!
من صفات النبي الكريم الجديدة – المؤكدة على بشريته – التي وردت في السورة الثامنة والثلاثين (صاد)، ولم ترد من قبل، نفي علمه بالغيب.
فهو عليه السلام لا يعرف ماذا دار عند بدء الخلق من حوار بين الله تعالى والملائكة، وبين الله وإبليس، لكنه أُبلغ به فبلّغه لقومه. وهو لا يعرف ماذا يدور من تحاور بين أهل النار، لكنه أُبلغ به فبلّغه.
وتحسم الآيات ذلك في السورة ذاتها قائلة (ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون)، (إن يوحى إلي إلا أنما نذير مبين).
فالصورة التي ترسمها السورة هنا لمحمد عليه السلام أنه بشر، يُوحى إليه، وما يُبلغ به قومه، ليس إلا ما يأتيه به الوحي، وهو ليس إلا منذرا لقومه.
وتأتي هذه الأوصاف لترد على ما كان ينعته به قومه، من أنه (ساحر كذاب) مما يورده القرآن الكريم في السورة كما هو، ودون أي حكم مسيء أو مشين لهم.
بقيت كلمة أخيرة عن وصف الجنة ومن فيها وما فيها من نعيم، ووصف النار ومن فيها وما فيها من عذاب.
إذ إننا لو تدبرنا آي القرآن الكريم تدبرنا دقيقا، لأدركنا أن جميع أوصاف الجنة ونعيمها يتعلق بالمكان وما فيه من بساتين وأنهار وعيون، وما سينعم فيه أهلها من أرائك، وما يلبسونه من ملابس من زخرف وإستبرق، ثم ما فيها من طعام وشراب، من خمر ولبن وعسل، وفواكه، ولحم طير.
وكذلك وصف النار وعذابها، يتعلق بالمكان وما فيه من درجات من العذاب، وما يلبسه أهلها فيها من سراويل من قطران، ثم ما يأكلون فيها من ضريع (طعام خبث منتن)، أو غسلين (صديد)، وما يشربون فيها من حميم (ماء حار) وغساق (صديد).
أما الفكرة السائدة التي يتعلق بها كثير من الناس من محبي الشهوات، من إشباع للجنس وما يصورنه بشأن ”الحور“ من أوصاف، فلا أظنه يتماشى مع صفات نعيم الجنة كما وصفها القرآن الكريم.
وإنما هي جميعا – في رأيي – صفات للفواكه الموجودة في الجنة والتي أفاض الكتاب الكريم في أوصافها.
ثم إن وصف الله تعالى لما في الجنة يصحبه عادة تعبير ”الرزق“، والرزق في القرآن الكريم يتعلق – بحسب فهمي – بالشراب والطعام والأموال (كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا). ويتعلق أيضا بالإنفاق.
وفي سورة (صاد) يقول تعالى عقب وصف نعيم الجنة (إن هذا لرزقنا ما له من نفاد).
ولم يرد استخدام تعبير الرزق في الكتاب الكريم مقترنا بالمرأة، أو النساء، بحسب علمي.
ثم أليس غريبا أن يصف الله تعالى الشهداء – وهم من يتوهم المتوهمون أنهم أول من يحظى بهذه ”الحور“ عقب الشهادة، وأنهم سيقابلون أول ما يقابلون بهن – فلا نجد في الوصف أي ذكر لهؤلاء ”الحور“؟
بل يقول الله تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون).
ولا يقولن أحد إن من بين الرزق النساء، سواء أكن حورا أم لا.
آمل ألا نرفض ما أُبدي هنا من رأي واجتهاد، قبل أن نراجع في أناة وروية وعقل منفتح آيات الجنة في القرآن الكريم، وأن نعمل عقولنا في فهمها بما يتوائم ومبدأ القرآن في العدل بين الرجل والمرأة، وطبيعة الجنة – الموصوفة في الكتاب الكريم – وطبيعة من يعيش فيها.
ولنا في الفترة التي عاشها آدم عليه السلام وحواء فيها عبرة، قبل أن يهبطا منها وينجبا أولادهما.
الأحد ١٨ رمضان ٢٠١٥
وهم ”الحور“ مرة أخرى
علق الصديق العزيز عدنان الشريف على يومية السبت ١٧ رمضان التي تناولت فيها سورة (صاد) متحدثا عن نعيم المتقين في الجنة. وأشار إلى الآية الكريمة (مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ). وتعميما للفائدة رأيت أن أضع تعليقي في يومية الأحد.
الآية التي ذكرها جاءت في السياق التالي، وأنا أذكره هنا لأَنِّي لا أحب اقتطاع الآية عن سياقها لأن هذا يؤدي إلي كثير من الخلط وسوء الفهم.
(إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كُنتُم تعملون. متكئين على سرور مصفوفة، وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون) سورة الطور ١٧-٢٢.
كما ورد التعبير نفسه في سورة الدخان (إن المتقين في مقام أمين. في جنات وعيون. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين) ٥١-٥٥.
واضح من الآيات في السورتين سياق الأكل والشراب الذي ينعم به المتقون.
في سورة الطور سبقت آية (وزوجناهم بحور عين) بـ(كلوا واشربوا)، ثم أتبعت بأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون.
وفي سورة الدخان سبقت بالحديث عن الملبس، ثم أتبعت بـ(يدعون فيها بكل فاكهة آمنين).
ونحن هنا بحاجة إلى فهم معنى حور عين، ومعني زوجناهم، بحسب الاستخدام القرآني، لأن الدلالة اللغوية وحدها – أي البحث في معاجم اللغة عن المعنى – قد تكون غير كافية، والأولى الاستخدام القرآني.
ويجب أيضا عند تفسير القرآن عدم إغفال المبادئ العامة التي يلتزم بها القرآن ذاته، ومنها هنا مبدأ عدل الله تعالى بين الرجل والمرأة.
وفي ضوء ذلك، وفي ضوء السياق الذي شرحته، نفهم أن الحور معناها الفاكهة التي تعود كما كانت بعد قطفها، من فعل “يحور” أي يعود، (إنه ظن ألن يحور) أي ظن أن العذاب لن يعود ويرجع.
وهذا المعنى تسانده آيات أخرى، (فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة)، و(كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها).
وهذه الفواكه المتجددة متاحة للرجال والنساء على السواء، (جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم).
أما العين فهي كالعين التي تسيل دائما بلا انقطاع لتجددها (اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا)، و(ترى أعينهم تفيض من الدمع).
أما زوجناهم، فتعني جعلناهم معها مقترنين، متلازمين، فأينما حلوا وجدوا تلك الفواكه.
وهذا الفهم – في رأيي وإن خالف المألوف في كتب التفسير – يتماشى مع عدل الله تعالى بين الرجل والمرأة، ويتماشى مع سياق الآيات التي تدور على الجنة وما فيها من نعيم يتركز على الطعام والشراب، واللباس، وليس للجنس فيه ذكر.
كما أنه يتماشى مع استخدامات القرآن الكريم للمفردات، وليس الاستخدام المعجمي الذي نقحمه أحيانا على النص القرآني.
وفي نهاية المطاف هذا اجتهاد، لأي شخص رفضه أو قبوله، ولكن ليس من حق أحد أبدا أن يغلق على عقولنا فلا نُعملها فيما نقرأ، لنظل أسارى كتب القدماء التي كتبها بشر مثلنا تأثروا ببيئاتهم وعصورهم.
الاثنين ١٩ رمضان ٢٠١٥
المفهوم القرآني لـ”النبي الأمي“
في السورة التاسعة والثلاثين من القرآن الكريم بحسب ترتيب النزول، وهي سورة (الأعراف) حديث مفصل عن أهل الجنة، وأهل النار، وأهل الأعراف، الواقفين على سور فاصل بين الجنة والنار، وما يدور بينهم من حوار، أوحى به الله لمحمد عليه السلام.
وفي السورة أيضا وصف مطول لخلق آدم، وللحوار الذي دار بين الله تعالى وإبليس، ثم حوار إبليس مع آدم وحواء لإغوائهما هما الاثنان، وخطاب من الله تعالى لبني آدم بعد أن هبط آدم وزوجه إلى الأرض.
وتحفل السورة كذلك ببعض من قصص الأنبياء السابقين، خاصة قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، التي تحتل حيزا كبيرا فيها.
وخطاب الوحي للنبي الكريم في السورة يرد في غير موضع منها، مضيفا الكثير مما يلقي الضوء على صورة النبي الكريم التي نحاول تتبعها في هذه اليوميات من خلال سور القرآن الكريم بحسب ترتيب النزول، حتى نرى تطور ملامح هذه الصورة. وسنقف عند هذه النقطة فيما يلي من سطور.
بدأت السورة الكريمة بوصف القرآن بأنه (كتاب)، وهذه أول مرة يُستخدم فيها هذا الوصف لما ينزل من الوحي منذ بدئه. إذ أصبح ما أنزل منه حتى هذه السورة التاسعة والثلاثين يشكل كتابا. وهدف هذا الكتاب المنزل – والخطاب هنا موجه إلى محمد عليه السلام في مطلع السورة – (لتنذر به، وذكرى). وفي هذا تأكيد لصفتين من صفات النبي الكريم، هما الإنذار (فهو منذر)، والتذكير (لأنه مُذكّر)، اللتين سبق ورودهما في سور أخرى.
وربما أحس محمد بشيء من الضيق في صدره بسبب ما يلاقيه من قومه عند إبلاغهم بالدعوة، ولهذا تحثه الآية الثانية من السورة قائلة (فلا يكن في صدرك حرج منه)، مذكرة له بأن ربه يعلم ما يعتلج في صدره.
وفي هذه السورة يستخدم القرآن لأول مرة وصف محمد بـ(الرسول) وبـ(النبي الأمي) في قوله تعالى (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل). ثم في قوله أيضا (يا آيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي).
وهكذا أخذت مهمة محمد عليه السلام تتأكد بعد فترة من بدء دعوته ليحظى بوصف (نبي) عقب مكابدته الدعوة إلى الله تعالى، ثم وصف (رسول) لأنه يوحى إليه.
ولنلاحظ تلازم ذكر وصف (كتاب) للقرآن الكريم، مع ذكر وصف (رسول) لمحمد عليه السلام في السورة نفسها، لأنه رسول أنزل معه كتاب.
أما وصف (الأمي) المقترن بلفظ (نبي)، فهو يرجع – بحسب سياق آيات السورة حيث يتوجه الله تعالى بخطابه إلى أهل الكتاب (ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون، ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل) – إلى نسبه إلى قوم لم ينزل عليهم كتاب من قبل.
فقد تحدث القرآن الكريم عن (أهل كتاب)، هم اليهود والنصارى، الذين سبق وأنزل عليهم التوراة والإنجيل. أما من لم ينزل عليهم كتاب من قبل، مثل العرب الذين بعث فيهم محمد عليه السلام، فهم (أميّون).
وليس لهذا الوصف – كما أفهمه من سياق آيات القرآن الكريم – صلة بأمية التعلم، أو عدم القدرة على القراءة والكتابة، كما نعرفها في أيامنا هذه. فقد كانت القراءة والكتابة معروفة بين العرب، حتى بين من أصبحوا من صحابة النبي الكريم فيما بعد، وكان محمد نفسه يعمل للسيدة خديجة بالتجارة، ولا يتصور أنه يؤدي مهمة كهذه دون علم بالقراءة والكتابة.
ولا يطعن أبدا في إعجاز القرآن – كما يظن بعضنا – معرفة نبينا الكريم بالقراءة والكتابة. إذ إن معجزة القرآن ليست في أنه أنزل على رجل ”أمي“، كما يحلو لبعضنا أن يتصور هذا، بل معجزة القرآن معجزة في الكتاب ذاته: اتساقه وعدم تناقضه، وفي تركيبه اللغوي والأدبي، وفي دلالاته التاريخية والعلمية الصادقة، وغير ذلك من جوانب الإعجاز.
أما آية ٤٨ من سورة العنكبوت (وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون)، والتي سبقت بالآية القائلة (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون) فالمقصود منها لا يعني عدم معرفته عليه السلام بالقراءة والكتابة، بل يعني أنه لم يكن يعرف التوراة ولا الإنجيل، ولا تلاوتهما. ولم يكن أيضا ممن يعملون في نسخهما. وإلا لارتاب فيه قومه.
ويدل على هذا التوجه سياق الآية السابقة، آية ٤٧، حيث يدور الحديث عن ”أهل الكتاب“ (اليهود والنصارى)، من أصحاب التوراة والإنجيل. إذ إن بعضهم – كما تقول الآية الكريمة – يؤمن بالكتاب الذي أنزل على محمد. وهناك قسم آخر يؤمن به، من هؤلاء، أي من قومه ممن لم ينزل عليهم كتاب من قبل.
(((( للحديث بقية ))))
الثلاثاء ٢٠ رمضان ٢٠١٥
”علم الساعة“، وترهات المرويات
ما زلنا نتابع خطاب الله تعالى للنبي الكريم في السورة التاسعة والثلاثين (الأعراف) من حيث ترتيب النزول.
وقد رأينا أن وصف محمد عليه السلام بـ(الرسول النبي الأمي) استخدم أول مرة فيها.
وفي السورة أيضا بيان مهم يشير إلى أن الرسالة التي كلف بها محمد ليست للعرب فقط، بل للناس كافة، (قل: يا آيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا).
وفعل الأمر (قُل) – الذي تحدثنا عن أهميته في رسم الصورة التي يرسمها القرآن الكريم للنبي – استخدم في السورة عشر مرات.
ويأتي استخدام الفعل – كما أشرت من قبل – في معظم الأحيان في سياق رد الوحي على تساؤل ربما طرحه أهل مكة على النبي الكريم، أو في سياق خطاب الوحي المباشر مع من اتبعوا الرسالة الجديدة أو مع الكافرين، يُحمَّل فيه محمد دور المُبلّغ عن ربه.
١- (قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء)، ويأتي هذا البيان من الوحي عقب قول الكافرين حينما كانوا يرتكبون فاحشة (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، والله أمرنا بها).
٢- (قل: أمر ربي بالقسط)، أما هذا البيان ففيه تأكيد مُثبت، بعد نفي ما زعمه الكافرون على الله تعالى.
٣- (قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، والطيبات من الرزق)، ويجيء هذا البيان في سياق رد على من يحرم ما أحله الله تعالى، وعقب أمر الله تعالى في خطابه المباشر لبني آدم (خذوا زينتكم عند كل مسجد). ولنلاحظ استخدام القرآن الكريم للفظ (زينة) موصوفا بـ(التي أخرج لعباده)، أي التي يستخرجها الناس من الأرض أو البحر، من ذهب وفضة ولؤلؤ، وغيرها.
٤- (قل: إنما حرم ربي: الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم، والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)، ويجيء هذا البيان في سياق الرد القرآني على من يتجرأون ويحرمون ويحللون – بحسب هواهم – ليحدد ما حُرم فعلا.
٥- (قل: يا آيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا)، ويأتي هذا البيان – كما قلت – لتحديد نطاق مهمة النبي الكريم، وأنها للناس جميعا.
٦- (قل: إنما علمها عند ربي)، ويجيء هذا البيان ردا على من سألوا محمدا عليه السلام عن الساعة، (يسألونك عن الساعة أيان مرساها).
٧- (قل: علمها عند الله، لكن أكثر الناس لا يعلمون)، استمرار في تأكيد الحقيقة القرآنية، وهي أن محمدا لا يعلم وقت قيام الساعة، إذ إن علمها عند الله تعالى وحده فقط.
ومع هذا البيان الواضح الدامغ، هل يكون ثمة مجال للحديث عن ”علامات الساعة“، أو ”أشراط الساعة“، وما يزعمونه من ”علامات صغرى“، وأخرى”كبرى“ مما يستفيض فيه بعض الدعاة – معتمدين على مرويات ظنية تعارض – بجلاء قول الله تعالى (قل علمها عند ربي). إذ ينفي الوحي تماما علم محمد عليه السلام بالساعة، أو بوقتها.
ونحن هنا أمام سبيلين: إما أن نتبع ما قاله الله تعالى في كتابه الكريم بشأن هذه القضية الواضحة البينة، وإما أن ندع كلام الله تعالى، لنأخذ مرويات، ما أظن أبدا أن النبي الكريم تفوه بحرف منها، وما أحسبه أبدا – وقد رباه ربه وعلمه – يخوض فيما يخالف ما يقوله له الوحي الكريم.
ولايمكن – فيما أعتقد – الجمع بين السبيلين.
وما شاعت تلك المرويات وذاعت إلا لأنها تستخدم أداة في ثقافة التخويف التي تعد بابا مهما من أبواب الدعوة الدينية في أيامنا هذه.
٨- (قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، إلا ما شاء الله،
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء.
إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون). وهذا بيان جلي لبشرية النبي الكريم، وتحديد مهمته. فهو لا يملك حتى نفع نفسه، ولا ضرها، وهو لا يعلم الغيب، وهو ليس إلا نذيرا، وبشيرا.
ولا بد أن أشير هنا إلى أن وصف (نذير) جاء من قبل، أما وصف (بشير) فهذه هي أول مرة يستخدم فيها في هذه السورة.
٩- (قل: ادعوا شركاءكم ثم كيدون، فلا تنظرون)، ويجيء هذا البيان عقب محاججة الله تعالى للمشركين، وأن من أشرك به الكفار ليس إلا عبادا أمثالهم.
ويعقب هذا الأمر من الله تعالى لنبيه الكريم أمر آخر لدعمه وطمأنته لأن الله يسانده (إن وليي الله).
ويعقب ذلك عدة أوامر أخرى تدخل في باب التربية الخلقية للنبي الكريم.
* (خذ العفو)، خذ الناس في دعوتك بالسهل الذي لا كلفة فيه.
* (أمر بالعرف)، أأمرهم بكل ما هو مستحسن تعرفه عقولهم، وتدركه أفهامهم.
* (أعرض عن الجاهلين)، تجنب الجاهلين.
* (إما ينزغنك من الشيطان نزغ باستعذ بالله)، وإن استثار الشيطان غضبك ليصدك عن الإعراض عن الجاهلين، فاستجر منه بالله تعالى.
١٠- (قل: إنما أتبع ما يوحى إلى من ربي)، ويأتي هذا البيان عقب تساؤل الكفار (وإذا لم تأتهم بأية قالوا لولا اجتبيتها)، أي لماذا لا يطلب محمد من ربه الآيات ليروها، أو لماذا لا يختلقها ويكتبها هو إن تأخرت؟ ولا يجرؤ محمد عليه السلام أبدا على ذلك، لأنه يتبع ما يوحي إليه ربه.
ثم تختتم السورة بشيء من التربية الروحية في ذكر الله تعالى وكيفية أدائه، وفي أي وقت (واذكر ربك في نفسك تضرعا، وخيفة، ودون الجهر من القول، بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين)
الأربعاء ٢١ رمضان ٢٠١٥
الغيب والعالم الموازي
سورة (الجن) هي السورة الأربعون من حيث ترتيب النزول. وهي سورة فريدة لأنها في مجملها خطاب يبلغه محمد عليه السلام من الوحي لقومه عن عالم آخر مواز لعالم البشر. وهي أيضا خطاب يشارك الجن فيه بالرواية، فيتحدثون عن عالمهم هذا الخفي لإجلائه للنبي الكريم، ثم لقومه.
وتصور السورة هذا العالم الموازي تصويرا دقيقا، وربما يكون في هذا التصوير دعم ومساندة للنبي الكريم الذي كان يواجه من قومه الكثير من العنت وسوء المعاملة، لأن هناك في هذا العالم الموازي من يؤمن برسالته (وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به). ولا ريب أن في هذا ما يثلج قلبه عليه السلام.
وتبدأ السورة بفعل الأمر (قل) – الذي تردد غير مرة في السورة السابقة (الأعراف) كما رأينا في يومية الأمس.
ويطلب الوحي من محمد عليه السلام أن يُعلم قومه (أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا).
ونعرف من خلال الآية الكريمة أن محمدا لم ير الجن، فهو لا يمتلك سوى ما يمتلكه غيره من البشر من قدرات. لكنه أُبلغ عن طريق الوحي بأنهم استمعوا له وهو يتلو القرآن الكريم.
وفي السورة يرد وصف جديد للنبي الكريم بأنه (عبد الله)، (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا). وقد مر بنا من قبل وصف النبي بـ”صاحبكم“، في خطاب الوحي لقريش بأن هذا النبي واحد منكم.
وفيها أيضا تحديد لمهمة النبي الكريم:
* (إنما أدعو ربي)، فمهمته الدعوة إلى الله تعالى.
* (ولا أشرك به أحدا)، ولعل في هذا إجابة لقريش حينما تعجبوا مما جاءهم به محمد، وطلبوا منه أن يرجع عنه، وهم كفلاء بنصرته. لكن محمدا أُمر برفض هذا العرض، وإعلان عدم إشراكه بالله تعالى.
وفي تطوير لصورة الرسول البشر (عبد الله) الذي يدعو إلى ربه (أدعو ربي)، يُؤمر النبي الكريم بإعلان عدم امتلاكه أي قوة أو سلطان ليدفع عنهم ضرا، أو يجلب لهم نفعا (قل: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا). فهو بشر، ليس بيده نفع ولا ضر.
كما أنه ليس هناك إنسان بشر يستطيع أن يُجير محمدا من الله إن أراد به سوءا، ولا يستطيع أحد نصرته، ولن يجد لدى أحد ملجأ من الله تعالى وقدره، (قل: إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا).
ولا يملك محمد إلا التبليغ عن ربه سبحانه وتعالى (إلا بلاغا من الله ورسالاته).
ثم تؤكد السورة – مرة أخرى – على عدم معرفة النبي الكريم بموعد عذاب الله الذي توعّد به الكفار، لأنه بشر، لا يعلم الغيب (قل:إن أدري أقريب ما توعدون، أم يجعل له ربي أمدا). فالله وحده هو الذي يعلم الغيب (عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدا).
فعلم الغيب أمر موكول إلى الله تعالى وحده. ولا يستطيع نبي أو رسول الخوض في هذا المجال، إلا إذا أراد الله تعالى إبلاغه بأمر من أمور الغيب ليبلّغه لقومه، (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا من ارتضى من رسول).
وهذا الاستثناء في الآية الكريمة لا يعني أن هناك رسولا يعلم الغيب – كما قد يفهم بعض قارئيها – لكنه، في رأيي، يعني أن الله تعالى قد يختار رسولا ليبلغه من أمور الغيب ما يريد ليحدث به قومه.
الخميس ٢٢ رمضان ٢٠١٥
”لا يحزنك قولهم“
تبدأ السورة الحادية والأربعون (يس)، بحسب ترتيب النزول بقسم بالقرآن الحكيم. وهذه هي المرة الثالثة التي يقسم فيها الله تعالى بكتابه. فقد سبق ذلك قسم في السورة الرابعة والثلاثين (ق)، والسورة الثامنة والثلاثين (ص).
أما في سورة (ق) فقد كانت صيغة القسم بـ(والقرآن المجيد)، وكانت في سورة (ص) بـ(والقرآن ذي الذكر).
والقسم في الحالات الثلاث مرتبط بمهمة النبي عليه السلام، المتمثلة في إنذار قومه، والتي قوبلت منهم إما بالتعجب والاندهاش، وإما بالاتهام لمحمد بأنه (ساحر كذاب).
غير أن ما يميز القسم في سورة (يس) هو ذكر جواب القسم، أو المقسَم عليه، عقب المقسَم به مباشرة. وهو هنا (إنك لمن المرسلين)، تأكيدا على أن محمدا عليه السلام واحد من الرسل.
أما وصف القرآن في الحالات الثلاث ففيه لفت إلى خصائص هذا الكتاب العظيم.
ففي سورة (ق) يصف الله تعالى القرآن بـ(المجيد)، أي الرفيع القدر والعالي الشأن. وهي صفة لم تستخدم في آي الكتاب إلا لوصف الله تعالى (حميد مجيد).
وفي سورة (ص) يصفه بـ(ذي الذكر)، أي التذكير، إذ إن آياته مُذكّرة لقارئها بآيات الله في الكون التي قد يغفل عنها. وهي أيضا مُذكّرة بأن محمدا عليه السلام رسول من عند الله. ولذلك يُستخدم وصف (الذِّكر) اسما من أسماء القرآن، كما في قوله تعالى (وقالوا يأيها الذي أُنزل عليه الذكر).
أما وصف القرآن في سورة (يس) بـ(الحكيم)، أي المحكمة آياتُه، أو ذاتُ الحكمة، فقد استخدم في آي الكتاب لوصف الله تعالى وجل شأنه، (الر، كتاب أحكمت آياته من لدن حكيم خبير)، (وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم)، (إنه أنا الله العزيز الحكيم).
وتُلقي السورة خلال آياتها الضوء على جهد النبي الكريم في محاولة إقناع كبراء قريش، بالرغم من لجاجهم. وهنا يُوجهه الله تعالى إلى تركيز دعوته على من قد ينفعه الذِكرُ ويُؤثر فيه، (إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب).
ويبدو أن مهمة النبي الكريم كانت لاتزال شاقة عند نزول السورة، تُواجَه بالرفض، وبالتكذيب، وبالإصرار على الشرك بالله، وإنكار البعث. ولذلك تدور آياتها جميعا على معالجة هذه القضايا عن طريق سرد قصص الأقوام السابقين مع رسلهم، والتذكير بآيات الله تعالى في خلق السماوات والأرض، وخلق الإنسان، وتسخير البحار لبني آدم، ثم وصف مشاهد أصحاب الجنة، وأهل النار في الآخرة.
كان ذكر قصص الأولين في السور السابقة يُستخدم لطمأنة النبي الكريم، وتثبيت قلبه. غير أن الأمر الملاحظ هنا في سورة (يس) هو أن سرد ذلك القصص أصبح يُستخدم في تلك المرحلة وسيلةً مباشرة لإقناع أهل مكة. إذ إن محمدا عليه السلام نفسه – بعد أن أكدت السورة في أولها (إنك لمن المرسلين) – أُمر بدعوة قومه إلى الاستماع إلى ما حدث مع غيرهم في سابق العهود حينما كذّبوا رسلَهم، (واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون).
ويبدو أن قلوب أهل مكة – بعد هذه الفترة غير القصيرة من نزول الآيات على النبي الكريم – أخذ بعضها يميل لسماع آي القرآن، التي كانت تمتاز في تلك المرحلة المكية التي لا نزال نعيشها حتى نزول سورة (يس)، بقصر تراكيبها، وفواصلها الموسيقية المؤثرة، والمشاهد الواصفة فيها التي تصور القيامة، وحال أصحاب الجنة وأهل الجحيم.
لكن لجاجة الكفر تمنع صاحبها من مسايرة قلبه، فيعود مرة أخرى إلى عناده. ومن هنا أخذ أهل مكة في دفع قلوبهم بعيدا عن التأثر بما يتلو محمد عليهم: فوصفوا ما يسمعون – في المرحلة الأولى – بأنه (سحر)، ووصفوا محمدا نفسه بأنه (ساحر)، بل غالوا فقالوا إنه (لمجنون)، بالرغم من أنه واحد منهم ويعيش بينهم. ثم وصفوه بأنه (شاعر)، يُحكم رصف الكلم.
لكن الآيات الخاتمة لسورة (يس) ترد تلك التهمة بشدة:
* (وما علمناه الشعر)،
* (وما ينبغي له)
* (إن هو إلا ذكر، وقرآن مبين)
* (لينذر من كان حيا)
ثم تُهدئ الآيات من روع النبي الكريم الذي قد يضايقه مثل تلك الاتهامات، فتقول (فلا يحزنك قولهم)، لأن الله تعالى يعلم بما يسرون وما يعلنون.
الجمعة ٢٣ رمضان ٢٠١٥
درس في الحوار !
في السورة الثانية والأربعين، بحسب ترتيب النزول، (الفرقان)، حديث مطول عن النبي محمد عليه السلام، وعن طبيعة الوحي الذي ما زال يُنزّل عليه، ورد فعل أهل مكة على ذلك كله.
ويُقربنا الحوار في السورة أكثر مما كان يجري في الوقت الذي كُلف فيه النبي الكريم بالدعوة، وكيف كان قومه ينظرون إليه، ويناظرونه ويجادلونه، ويستهزئون به، وكيف رد القرآن المجيد على افتراءاتهم.
والسورة في هذا الباب سورة فارقة، ولا عجب أنها سميت بـ(الفرقان).
تبدأ السورة بتمجيد الله تعالى الذي أنزل على (عبده) الفرقان. وهذا وصف جديد للقرآن لم يرد من قبل في السور السابقة. ولعل فيه إشارة إلى أن ما يُنزل من الوحي أصبح بالفعل فارقا بين حق، يدعو إليه النبي، وباطل يستميت أهل مكة في الدفاع عنه والإبقاء عليه.
وتلقي آيات (الفرقان) مزيدا من الضوء على افتراءات أهل مكة حيال هذا النبي، وحيال الوحي الذي أخذت آياته تتوالى، وأخذ يُحدث – فيما يبدو – تأثيرا أهاج عقول سادة مكة الخائفين على سطوتهم وسلطانهم.
ولم يعد أهل مكة يكتفون باتهام محمد عليه السلام بأنه (ساحر)، أو (مجنون)، أو (شاعر)، بل أخذت رقعة الاتهام تتسع لتصبح مناظرة، وجدلا، كان لابد من رد الوحي ذاته عليها.
وبعد فشل محاولتهم الطعن في النبي، أخذوا يوجهون سهام نقدهم إلى الوحي ذاته. فقالوا:
* في الفرية الأولى (إن هذا إلا إفك افتراه، وأعانه عليه قوم آخرون)، مدعين أن ما ينزل على محمد ما هو إلا محض كذب واختلاق، ساعده عليه بعض أهل الكتاب من اليهود.
ورد القرآن الكريم ذلك – بعد أن عرض حجة أهل مكة بأمانة – في أسلوب راق ينبغي أن نتعلم منه في تحاورنا، (فقد جاءوا ظلما وزورا).
* أما الفرية الثانية (وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فهي تُملى عليه بكرة وأصيلا)، واصفين الوحي وما يرد فيه من قصص الأولين، بأنه من أقاصيص الأولين وخرافاتهم، طلب محمد ممن يعينه، كتابتها له، فراح يُمليها عليه صباح مساء.
وجاء رد القرآن على ذلك – مرة أخرى – في أسلوب أَمْر راق إلى محمد (قل: أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض).
وفي هذا الأسلوب السردي الذي يعرض – بكل دقة وصراحة – رأي الآخر المُهاجم، ثم رد القرآن عليه، درس أخلاقي لمحمد – ودرس لنا أيضا من بعده – في قواعد الحوار مع المخالفين. لكنا – من أسف – لا نتدبر آيات كتابنا الحكيم، ولا سيرة نبينا الكريم.
(((( للحديث بقية ))))
السبت ٢٤ رمضان ٢٠١٥
الرسول في تصور قريش الـ”رأسماليّ“ !
عقب طعن كبراء مكة في الوحي، عادوا إلى الطعن في محمد من جديد. لكنهم هذه المرة – كما ترسم سورة الفرقان ملامح الصورة – يعجبون من أنه بشر، يسلك مثلهم مسالك البشر.
* (وقالوا: مال هذا الرسول يأكل الطعام، ويمشي في الأسواق)، فهو يأكل الطعام مثلهم، ويمشي في الأسواق مثلهم. ولنلاحظ هنا كيف أقر أهل مكة دون أن يدروا بأن محمدا رسول (مال هذا الرسول).
لكن تعجبهم هذا يكشف اللثام عن تصورهم لطبيعة ”الرسول“، فهو – من وجهة نظرهم لا ينبغي أن يكون رجلا مثلهم، يأكل ويمشي، بل يجب أن يكون شيئا آخر.
* (لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا)، فهم ينكرون على محمد أن يكون رسولا، بل يستكثرون ذلك عليه، لأنه رجل فقير، وليس من أثريائهم. وكان من الأولى – بالنسبة إليهم – أن ينزل إليه ملَك يؤدي هو عنه مهمة الإنذار.
ويتضح تصورهم أكثر في تالي الآيات.
* (أو يُلقَى إليه كنز)، أي ينبغي أن يكون (هذا الرسول) ثريا من السادة، يُنزل ربه عليه ذهبا وفضة.
* (أو تكون له جَنة يأكل منها)، أي يمتلك بستانا يأكل منه فيغنيه عن غيره. وهذا هو تصور ”رأسمالي“ صورته الآيات بدقة، كما تتخيله عقول الأثرياء الذين يخشون على سلطانهم.
ثم لما يئسوا، حاولوا زعزعة إيمان تابعي محمد، فقالوا:
* (وقال الظلمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا)، واصفين النبي الكريم بأنه مسلوب العقل مسحور.
وهنا يتدخل الوحي بالرد، لافتا انتباه محمد عليه السلام، إلى ضلال قومه.
* (انظر كيف ضربوا لك الأمثال، فضلوا، فلا يستطيعون سبيلا). وتستكمل الآيات رسم ملامح هذا التصور ”الرأسمالي“ لطبيعة الرسول، وتبين أن الله تعالى قادر – إن شاء – على أن يمنح النبي أفضل من ذلك كله، لكن ترى هل ستكون النتيجة مختلفة؟
* (تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك)
* (جنات تجري من تحتها الأنهار)
* (ويجعل لك قصورا)
وحتى لو تحقق ذلك، فستكون النتيجة هي ذاتها، إذ إن لب الأمر كله هو تكذيب كبراء مكة للنبي وكفرهم بالبعث، (بل كذبوا بالساعة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا).
وحتى يخفف الوحي من ضيق محمد بما يقوله قومه، تؤكد له السورة في سياق آياتها أنه ليس بدعا من الرسل، بل هو مثلهم بشر.
* (وما أرسلنا قبلك من المرسلين، إلا إنهم ليأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق)، فهكذا هي طبيعة الرسل. إنهم جميعا بشر، يسلكون مسالك البشر.
* (وقال الذين لا يرجون لقاءنا: لولا أنزل علينا الملائكة)، لتُثبت صحة نبوة محمد،
* (أو نرى ربنا)، ليُؤكد لنا أن محمدا مرسل من لدنه.
ويرد القرآن الكريم – مرة أخرى على هؤلاء المستكبرين – بالقول:
* (يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين)، إنهم سيرون الملائكة – يوم القيامة – لكن هؤلاء المستكبرين المكذبين سيكونون حينئذ في عداد المجرمين، وقد فات الأوان.
وتنتقل السورة في سلاسة من مشهد الملائكة يوم القيامة، (يوم تشقق السماء بالغمام، ونُزّل الملائكة تنزيلا)، إلى مشهد الحساب.
وتصف آي السورة مشهد ذلك اليوم من وجهة الكافرين، فتقول:
* (كان يوما على الكافرين عسيرا)
* (يوم يعض الظالم على يديه)
ونتلفت في المشهد، فنجد الرسول الكريم، عاتبا على قومه:
* (وقال الرسول: يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا). أي أن تعاملهم مع القرآن الكريم – الذي أمروا بتلاوة ما تيسر منه، وبتدبره – هو فقط بالهجران.
وأحسب أن هذا لا يزال ديدن المسلمين اليوم مع الكتاب الكريم، فهم – وإن لم يهجروا حينا قراءته – قد هجروا تدبره، ثم هجروا السير على نهجه القويم، مُؤثرين عليه – وبدلا منه – اتباع أقوال ”إمام“، أو ”أمير“، أو ”مرشد“، أو ”داعية“.
ثم تعود سورة الفرقان – مرة أخرى – إلى تصوير أمانيّ الكفار الذين أغاظهم متابعة القرآن والوحي لكل حدث، فقالوا:
* (وقال الذين كفروا: لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة)، وكأن لسان حالهم يقول: لماذا لم ينزل هذا الكتاب مرة واحدة، وننتهي منه؟
ويرد الوحي على ذلك مبينا حكمة تنزيل القرآن ”مُنجّما“:
* (كذلك، لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا). فالهدف من تنزيله هكذا، هو تثبيت قلب النبي عند كل حدث، ثم ليسهل من بعد على النبي الكريم حفظه واستيعابه، لأن الله فرّق آياته تفريقا يساعد في ذلك.
ويعاود الكفار الكَرَّة على النبي مستهزئين به، هذه المرة.
* (وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا)
* (أهذا الذي بعث الله رسولا؟)
* (إن كان ليضلنا عن آلهتنا، لولا أن صبرنا عليها)
وكان رد القرآن عليهم راقيا، مشركا محمدا في الحوار:
* (أرأيت من اتخذ إلهه هواه)
* (أفأنت تكون عليه وكيلا)
ثم تتحدث السورة في نهاياتها عن آيات الله تعالى في مدّ الظل، وفي الليل والنهار، والشمس والقمر، والريح، والمطر، الذي يسوقه الله تعالى من بلد إلى بلد بعينه دون غيره. لكن العناد والكفر والتكذيب لا يزال هو هو من جانب الناس في كل مكان.
وكان الله سبحانه قادرا على أن يرسل في كل قرية نذيرا، لكنه آثر محمدا وقومه بالرسالة. كما ينزل المطر فوق بقعة بعينها دون غيرها.
* (لو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا)
وفي أسلوب نهي جازم يقول الله تعالى لنبيه:
* (فلا تطع الكافرين)
ثم في أسلوب أمر جازم أيضا، يدعوه إلى التمسك بالقرآن، ومجاهدة الكفار به:
* (وجاهدهم به جهادا كبيرا)، وهذه هي المرة الأولى التي يُستخدم فيها تعبير ”الجهاد“، منذ نزول الوحي.
ثم تختتم السورة بالتذكير بمهمة النبي المحصورة في التبشير والإنذار:
* (وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا)
دون سعي إلى مأرب مادي:
* (قل: ما أسألكم عليه من أجر)
وتدعو الآيات النبي الكريم – وسط هذا الجهاد في أداء مهمة الدعوة – إلى ألا يغفل تريض الروح بالاعتماد على الله تعالى، وتسبيحه، والتضرع له بالدعاء:
* (توكل على الحي الذي لا يموت)
* (وسبح بحمده)
* (قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم)
الأحد ٢٥ رمضان ٢٠١٥
”لاتذهب نفسك عليهم حسرات“
مازلتُ في هذه اليوميات أتابع صورة النبي الكريم في سور القرآن بحسب ترتيب النزول، من خلال ما توجهه الآيات المنزلة في خطاب مباشر إلى محمد عليه السلام، يوضح له المهمة التي كُلف بها، ويرشده إلى كيفية التعامل مع من يدعوهم، وينشئه تنشأة روحية بما فيه من هدي في ذكر الله تعالى وتسبيحه. ومن خلال ما ترويه الآيات من قصص المرسلين السابقين لتؤازره وتثبت به قلبه.
ونرسم ملامح الصورة أيضا من خلال ما تذكره الآيات الكريمات عن محمد: حياته وصفاته وأخلاقه، وردود فعله التي يرصدها الوحي.
وفي بداية السورة الثالثة والأربعين (فاطر) نلحظ الربط بين مفتتحها وحديث السورة السابقة، (الفرقان) – كما ذكرت في يومية أمس – عن الملائكة التي كان كفار مكة يؤثرون أن يرسلها الله تعالى على محمد لإثبات نبوته، وتولي مهمة الإنذار بدلا منه.
* (الحمد لله فاطر السموات والأوض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع).
وتُبْرز السورة خلال آياتها فكرة أن محمدا ليس بدعا من الرسل، بل هو مثل غيره من الرسل السابقين، من حيث ما يلاقيه من معاناة في الدعوة إلى الله تعالى، وتكذيب أقوامهم لهم، وإنكارهم للبعث، بالرغم من آيات الله حولهم في السماء وفي الأرض، وفي خلق الليل والنهار، والشمس والقمر، والبحار وخيراتها.
وتتكرر في السورة الكريمة فكرة تكذيب أهل مكة للنبي الكريم مرتين:
* (وإن يكذبوك، فقد كُذب رسل من قبلك)
* (وإن يكذبوك، فقد كَذب الذين من قبلهم)
ويبدو أن النبي الكريم – كما تصور آي السورة – كان يجاهد بالفعل نفسه في الدعوة إلى الله تعالى، وكان يبذل في ذلك جهدا، من أجل إقناع قومه. بل إنه – عليه السلام – كان فيما يبدو يحزن لما يراه من عناد وعتو من الكفار. ولذلك تهون عليه الآيات قائلة:
* (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون)
وحتى لا يزداد ضيق صدرك النبي الكريم، ولا يشتد حزنه لما يلاقي، تعيد آيات (فاطر) تأكيد تحديد المهمة التي كُلف بها:
* (إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، وأقاموا الصلاة، ومن تزكّى فإنما يتزكّى لنفسه).
بل توجه له – عليه السلام – خطابا مباشرا حاسما، حتى لا يجهد نفسه ويُحملها أكثر مما تطيق:
* (وما أنت بمسمع من في القبور)
وتعود لتؤكد مهمة الإنذار وليس الهداية:
* (إن أنت إلا نذير)، ولست في ذلك بدعا.
* (إنا أرسلناك بالحق، بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير)
وستسمر آيات (فاطر) في التسرية عن النبي، وتثبيت فؤاده بأنه منذر، وقد بُعث من قبله رسل إلى أقوامهم فكذبوا. ولا يطعن تكذيب السابقين للرسل في الرسالة ذاتها، إذ إنها حق (إنا أرسلناك بالحق). وتعود السورة لتكرر ذلك مرة أخرى، حتى يطمئن قلب محمد عليه السلام، في قوله تعالى:
* (والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق)
وهذا الحق الذي أنزل على النبي الكريم لا يختلف عما سبقه من بينات، أو كتب، بل هو مصدق لها
* (والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، مصدقا لما بين يديه)
ثم تتحدث الآيات بعد ذلك عن أحوال المتلقين للرسالة – حتى تثبّت قلب النبي ولا يبتئس فواده – وأنها دوما مختلفة، فمنهم مُقصر، ومنهم مقتصد متوسط الحال، ومنهم مؤمن سباق في عمل الخيرات.
* (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات).
وتلخص نهايات السورة الحال التي واجهها النبي في آية بليغة تهدف إلى طمأنته عليه السلام، بأن ما يلاقيه من قومه ليس بسبب تقصير منه، بل بسبب ما طبع الكفار عليه من استكبار وعناد وتكذيب.
* (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم)
* (فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا).
الاثنين ٢٦ رمضان ٢٠١٥
”اصطبر .. ولا تعجل عليهم“
في سورة (مريم) – وهي السورة الرابعة والأربعون من حيث ترتيب النزول – يدور الحديث في معظم الآيات على قصص الرسل السابقين، زكريا، وعيسى بن مريم، وإبراهيم، وموسى، وإسماعيل، وإدريس، عليهم السلام.
وقصة سيدنا عيسى عليه السلام هي المهيمنة على السورة، التي سميت باسم أمه ”مريم“ عليها السلام، دون أي غضاضة في نسبتها إليها.
والخطاب في السورة، من بدايتها، موجه إلى النبي محمد عليه السلام (ذكر رحمت ربك عبده زكريا). ثم يتكرر الأمر فيها (واذكر في الكتاب …) قبل كل قصة من القصص التي تحتويها.
وإن كان في سرد قصص الرسل السابقين على النبي الكريم – كما ذكرنا من قبل مرارا – تطمين وتثبيت لفؤاده عليه السلام خلال مسيرة الدعوة الشاقة، فإن في قصتي زكريا وعيسى عليهما السلام خاصة دعما معنويا شديدا. إذ إن القصتين تُبرزان قدرة الله سبحانه في الخلق: في حمل وولادة زوجة النبي زكريا – بالرغم من أنها كانت عاقرا، وأن زوجها رجل كبير، وحمل مريم بعيسى دون زوج.
وفي القصتين أيضا – خاصة قصة عيسى عليه السلام – سرد لرأي القرآن الكريم الفصل في قضية ربما أثارها أهل الكتاب مع محمد عليه السلام للتشكيك في نبوته.
والسورة – مرة أخرى – مليئة بالحوار: حوار بين زكريا وربه، وحوار بين السيدة مريم والملك الذي جاءها، وحوار مريم مع أهلها، ثم حوار الطفل عيسى – وهو في المهد – مع أهل مريم، وحوار إبراهيم مع أبيه.
وتظهر ملامح الصورة التي ترسمها آيات السورة ما كان يعانيه النبي الكريم خلال تعبده من شدة من قومه، ولذلك تحثه الآيات على التصبر.
* (رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته).
ثم تعلمه الآيات الكريمة ألا يدفعه عنت قومه والعناء الذي يلاقيه منهم إلى الدعاء عليهم، واستعجال العذاب لهم. فليس هذا من الخلق العظيم.
* (فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا)، فإن لهم موعدا محددا سيلاقون فيه هذا العذاب.
وتذكره نهاية السورة بأن لب مهمته هو التبشير والإنذار، وأن جريان آيات القرآن الكريم على لسانه طوال تلك الفترة الفائتة من الوحي، إنما كان بعون من ربه الذي يسر له مهمة حفظه.
* (فإنما يسرناه بلسانك لتُبشر به المتقين، وتُنذر به قوما لدا).
الثلاثاء ٢٧ رمضان ٢٠١٥
صَبرٌ واصطبارٌ
سورة (طه) هي السورة الخامسة والأربعون من حيث ترتيب النزول. وهي سورة فريدة، سبكها السردي محكم، وتركيبها الموسيقي مؤثر في الأسماع، ومشاهدها – وكأني أراها معروضة أمامي عند قراءتها – سريعة، متداخلة، تتنقل بك من مشهد إلى مشهد، بل من منظر إلى منظر، وكأنك تشاهد الوقائع أمام ناظريك.
بداية السورة، ليست بالجديدة، فهي تبدأ بحرفين مقطّعين هما (ط) و (هـ)، وقد رأينا مثل ذلك من قبل في سورة (يس) التي تبدأ بـ(ي) و (س).
وكان ارتباط تلك البداية في السورتين بخطاب موجه إلى محمد عليه السلام بشأن القرآن دافعا لبعض المسلمين إلى الظن بأن (طه) و(يس) اسما علم يشيران إلى النبي الكريم. ولذلك تسمى بهما كثير من المسلمين تيمنا.
لكنا لم نسمع عن أحد سمي بـ(حم)، مثلا. ولعل ذلك راجع إلى أن الحديث بعد هذين الحرفين المقطعين (ح) و(م) – في السور التي تبدأ بهما – لم يكن فيه خطاب مباشر لمحمد عليه السلام.
ويواصل الوحي في (طه) تهوينه على النبي الكريم – الذي كان يشق على نفسه في الدعوة إلى الله تعالى – فيقول في بدايتها قولة حاسمة دالة.
* (ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى)، فليس الهدف من نزول القرآن الكريم أن يشق محمد على نفسه. وليس الهدف من القرآن – أبدا، كما أفهم الآية الكريمة – أن يشق الله بالقرآن أو بالدين على الناس، وهو الذي يقول في موضع آخر من كتابه الكريم (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
لكن الهدف – والخطاب هنا موجه إلى محمد عليه السلام – هو تنبيهه إلى أن لب تكليفه هو التذكير (إلا تذكرة لمن يخشى).
وما أجمل اللفتة الكريمة في الآيات التالية التي تتحدث عن التنزيل، وأنه ممن خلق الأرض والسماوات العلا، حينما يصف الله جل وعلا نفسه هنا بـ(الرحمن). وكيف يُنزل (الرحمن) ما قد يُشقي؟
ولست أدري لماذا أحس أن في الخطاب الموجه إلى النبي الكريم عقب ذلك، (وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى) توددا إلى محمد وتهوينا عليه، بألا يجهر بالتلاوة إن كان ذلك سيعود عليه بالمشقة، فالله سبحانه وتعالى (يعلم السر وأخفى)، وما هو أشد خفاء من السر.
وتنقلنا السورة – بفاصلة خطابية مررنا بها من قبل في سور أخرى – إلى قصة موسى عليه السلام، وأخيه هارون، مع فرعون. هذه الفاصلة هي (وهل أتاك … ؟)
ثم تتوالى مشاهد القصة، واحدا تلو الآخر، فنسمع فيها حوار موسى مع ربه. وعن طريق الحوار تستكمل القصة أحداثها – وكأننا في مسرح تُعرف الأحداث كلها فيه من خلال الحوار. وعبر نقلة عابرة بواسطة (ولقد مننا عليك مرة أخرى)، تعود أحداث السرد إلى مشهد من الماضي حينما كان موسى رضيعا وألقت أمه به في اليم.
ويعود الحوار مرة أخرى بين موسى ربه، ثم بين موسى وأخيه هارون، ثم بين الاثنين وفرعون. ويتطور الحدث – عبر الحوار – إلى الحديث الذي دار بين موسى وسحرة فرعون، ليقطعه سرد يرينا خوف موسى من المواجهة معهم. ويرجع حوار موسى مع ربه لطمأنته. ثم ينتقل الحوار إلى ما دار بين السحرة – الذين آمنوا لموسى – وفرعون الغاضب.
وهكذا … يستمر الحوار المفعم بالأحداث والمشاهد، المتسارعة.
وتعود السورة من جديد إلى خطاب النبي الكريم:
* (كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق)
* (وقد آتيناك من لدنا ذكرا)
* (من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا)
وهنا تصف الآيات القرآن بالـ”ذكر“، وسبق أن وصفته في مطلع السورة بالـ”تنزيل“. وتعود الآي لوصف القرآن مرة أخرى في نهاياتها بالقول:
* (وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا)، مؤكدة على صفته العربية، ردا على بعض الادعاءات بأن قوما آخرين كانوا يُملونه على محمد.
* (وصرفنا فيه من الوعيد)، وهنا يتحدث القرآن ذاته عن بعض محتويات آياته – خاصة في العهد المكي الحافل بالوعيد ومشاهد القيامة والعذاب.
وتطمئن الآيات التالية محمدا عليه السلام بأنه لن ينسى ما يوحيه الله إليه، ولذلك فلا مدعاة للتعجل قبل أن يستكمل الوحي المهمة:
* (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضَى إليك وحيه)
ثم تختتم تلك الآية السابقة بجملة ذات دلالة قوية – بحسب فهمي لسياق الآيات – تدعو النبي الكريم إلى أن يدعو ربه (وقل: رب زدني علما). فما يأتيه به الوحي كل مرة، إنما هو ”علم“ جديد بالنسبة إلى محمد، وعليه أن يطلب من ربه تضرعا أن يزيده علما به، فلا ينساه.
ولعل الآية التالية لهذه الآية مباشرة تؤيد ما أذهب إليه، إذ ينتقل سياق السرد مباشرة إلى قصة آدم عليه السلام، ونسيانه عهد الله، (ولقد عهدنا إلى آدم من قبلُ فنسي ولم نجد له عزما).
وكما بدأت (طه) بالتهوين على محمد عليه السلام، بأن القرآن لم ينزل لشقائه، تختتم بدعوته إلى الصبر:
* (فاصبر على ما يقولون)، والصبر رياضة روحية عظيمة، تحتاج دوما إلى التدريب والتطهر الروحي. ولا يتحقق ذلك إلا بذكر الله سبحانه ليل نهار.
* (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار)
وهذا التسبيح والذكر يعود على المتبتل به بالسكينة والرضا.
* (لعلك ترضى).
وبعد تلك الشحنة الروحية أصبح النبي الكريم مهيأ لتنبيه الوحي له، ألا ينظر إلى ما منحه الله تعالى للآخرين من متع الدنيا، التي لا تطول حياتها، لأن رزق ربه إليه أفضل وأبقى.
* (ولا تمدنّ عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى).
وكما أمر محمد بدعوة قومه إلى الإسلام، كُلف أيضا بدعوة أهله. ويبدو أن الصلاة كانت قد فرضت عند نزول آي السورة، إذ تختتم بأمر النبي بقوله تعالى:
* (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها).
ولكن لماذا استخدم القرآن الكريم فعل (اصطبر) هنا مع أمر أهله بالصلاة، كما استخدم الفعل ذاته في سورة (مريم) التي تحدثنا عنها في اليومية السابقة عندما قال (رب السماوات والإرض فاعبده واصطبر لعبادته)؟
في آية سابقة حث الله تعالى النبي على الصبر على ما يقوله قومه (واصبر على ما يقولون) فاستخدم الفعل (اصبر). أما العبادة – ومنها الصلاة – ففيها مكابدة ومعاركة مع النفس ومجاهدة، ولا يمكن أن تتحقق هذه الصفات إلا بـ(اصطبر) الذي يدل على اتخاذ الصبر ديدنا له، وأن هناك مشاركة بينه وبين الصبر، أو مشاركة بينه وبين نفسه في حالات مختلفة بسبب نوازعها التي تركن إلى الراحة. وفي العبادة – وعلى رأسها الصلاة – مكابدة للنفس، ولذلك كان استخدام القرآن المجيد للفظ (اصطبر) في هذين السياقين في السورتين.
الأربعاء ٢٨ رمضان ٢٠١٥
”اخفض جناحك لمن اتبعك“
ليس في السورة السادسة والأربعين (الواقعة) – من حيث ترتيب النزول – شيء متصل بحديث هذه اليوميات عن صورة النبي محمد عليه السلام في القرآن الكريم. إذ إن السورة في مجملها تتحدث عن علامات يوم القيامة، وأقسام الناس حينئذ، ووصف مشاهد الجنة والنار، وطعام وشراب أهل كل منهما فيها.
لكنا نجد في السورة السابعة والأربعين (الشعراء) قسطا وفيرا من الخطاب المباشر الموجه إلى النبي الكريم، ووصفا دالا للقرآن الذي يُنزّل عليه.
فما زال محمد عليه السلام يكابد نفسه، ويقسو عليها في الدعوة من أجل أن يؤمن قومه. لكن ربه تعالى لا يريد له ذلك.
* (لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين)، فليس هناك ما يدعو إلى أن تعرض نفسك للغم وتهلكها ليؤمن قومك. بل كن على نفسك شفيقا، فليس عليك إلا البلاغ. ولقد علم الله تعالى أن القوم مصرون على عنادهم وإعراضهم وتكذيبهم، فلن تنفعهم حتى أي آية تنزل عليهم، سواء أكانت مشاهدة بأعينهم أو مقروءة مسموعة بآذانهم.
* (إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين)
* (وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين)
* (فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون)
وما زال الوحي يشير إلى ما ينزل على النبي الكريم هنا بأنه (ذكر)، جاء به ليذكرهم، وبأنه (مُحدث) يحدث وينزل أمامهم.
وتعود السورة قرب نهايتها إلى وصف القرآن مرة أخرى، مؤكدة على أنه منزل من الله تعالى، بواسطة جبريل عليه السلام بلغة عربية واضحة.
* (وإنه لتنزيل رب العالمين)
* (نزل به الروح الأمين)
* (على قلبك لتكون من المنذرين)
* (بلسان عربي مبين)
وتشير الآيات أيضا إلى أن هذا القرآن ورد ذكره في الكتب السابقة، وأن من علامات صدقه أن علماء أهل الكتاب من بني إسرائيل – الذين يعيشون بين ظهراني أهل مكة – يعلمون به، لأنه مذكور في التوراة. ولكن أهل مكة مع ذلك لا يزالون يكذبون به بسبب تكبرهم وعنادهم. وهذا هو أيضا موقفهم حتى لو لم ينزل هذا القرآن على محمد، وهبه أُنزل – وهو كتاب عربي بلغة عربية واضحة – على أعجمي فأحسن قراءته، لما صدق قومك به بسبب تكبرهم وعنادهم. ولن يصدقوه إلا عندما يرون العذاب، حين يكون الأوان قد فات.
* (وإنه لفي زبر الأولين)
* (أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل)
* (ولو نزلناه على بعض الأعجمين)
* (فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين)
* (كذلك سلكناه في قلوب المجرمين)
* (لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم)
وتردّ السورة – بعد ذلك – تهم الكافرين لمحمد بأنه ”كاهن“، وأن ما يأتيه هو ما تأتي به الشياطين الكهنةَ.
* (وما تنزلت به الشياطين)
* (وما ينبغي لهم وما يستطيعون)
* (إنهم عن السمع لمعزولون)
ولا يمكن أن تتنزل الشياطين إلا على المكذبين الآثمين، (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم).
وكما أُمر محمد بأمر أهله بالصلاة والاصطبار عليها – كما رأينا في سورة (طه) – فإنه يؤمر هنا في (الشعراء) بإنذار عشيرته. لكنه يؤمر أيضا بأن يكون لين الجانب رقيق المعاملة مع من اتبعه. أما من عصاه، فما عليه إلا أن يتبرأ من فعلهم، ولا يفعل ما هو أكثر من ذلك.
* (وأنذر عشيرتك الأقربين)
* (واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين)
* (فإن عصوك فقل: إني بريء مما تعملون)
وهكذا يتابع الوحي – من أول السورة لآخرها – محمدا آخذا بيده مرشدا له، مشفقا عليه حتى لا يجهد نفسه ويهلكها فيما كلف به، ولافتا نظره إلى طيب المعاملة مع من آمنوا بدعوته، وحتى مع من رفضوها.
إذ ترشده الآيات الكريمات إلى الخلق الكريم في مثل هذا الموقف، ألا وهو أن يتبرأ مما أقدموا عليه. وليس له أبدا أن ينهرهم، أو يستهزئ بهم، أو يقاتلهم، حاشاه وقد تربى على خلق عظيم.
الخميس ٢٩ رمضان ٢٠١٥
”النبي الإنسان“
عشتُ معكم في هذه اليوميات خلال شهر رمضان في صحبة النبي الكريم كما وصفته آي القرآن المجيد، وكما حددت له مهمة التكليف بالدعوة، ورسمت له سبل التعامل مع قومه. وانتهى الشهر الكريم ولما تنته رحلتنا بعدُ في صحبة صورة محمد عليه السلام كما رسمها القرآن.
بيد أني عازم بمشيئة الله تعالى على استكمال تلك الرحلة حتى تتضح لي معالم تلك الصورة.
إن ما دفعني إلى خوض هذا النوع من الحديث – خلال يومياتي في رمضان – هو ما لمسته في قراءاتي، ومشاهداتي عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، من تباعد بين صورتين: صورة النبي الكريم في القرآن، وصورته في أذهان الناس الآن.
ولن تتضح ملامح هذا التباعد بين الصورتين إلا بتركيز الضوء على كل منهما على حدة.
وآثرت أن أبدأ بالمصدر الأصلي الأول لتتبع قسمات الصورة الأولى، صورة النبي في القرآن، على أن انتقل من بعد إلى الصورة الأخرى، في مصادرها، التي تتصدرها الأحاديث والمدائح النبوية.
وقد لسمت خلال يومياتي بعضا من ملامح الصورة الأولى، في السور التي تمكنت من قراءتها حتى هذا اليوم. واعتمدت في تتبع تلك الملامح ترتيب السور بحسب النزول، حتى نرى معا تطور الخطاب القرآني لمحمد عليه السلام، وخطابه عن محمد، من العصر المكي عند بداية الوحي إلى العصر المدني بعد ذلك.
ولعل أهم تلك الملامح التي أبرزتها رحلتي حتى الآن هو ”النبي الإنسان“، الذي تعهده الوحي بالتهيئة والتربية الروحية والأخلاقية للمهمة التي كُلف بها.
وهو بشر، لكنه يتميز من غيره من البشر، بصلته بالسماء وبالوحي. وكم كان هذا النبي الكريم حريصا على أداء المهمة حتى وإن جار على نفسه في سبيل إقناع قومه. ولذلك دعاه الوحي غير مرة إلى الترفق بحاله وألا يشق على نفسه.
وتظل ”بشرية“ محمد عليه السلام ملمحا جوهريا في الصورة، فهو بشر يُوحى إليه، لكنه – مثل غيره من البشر، لا يعلم الغيب في السماوات وفي الأرض. ولا يعلم بموعد قيام الساعة، الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
(((( وللحديث بقية إن شاء الله تعالى ))))