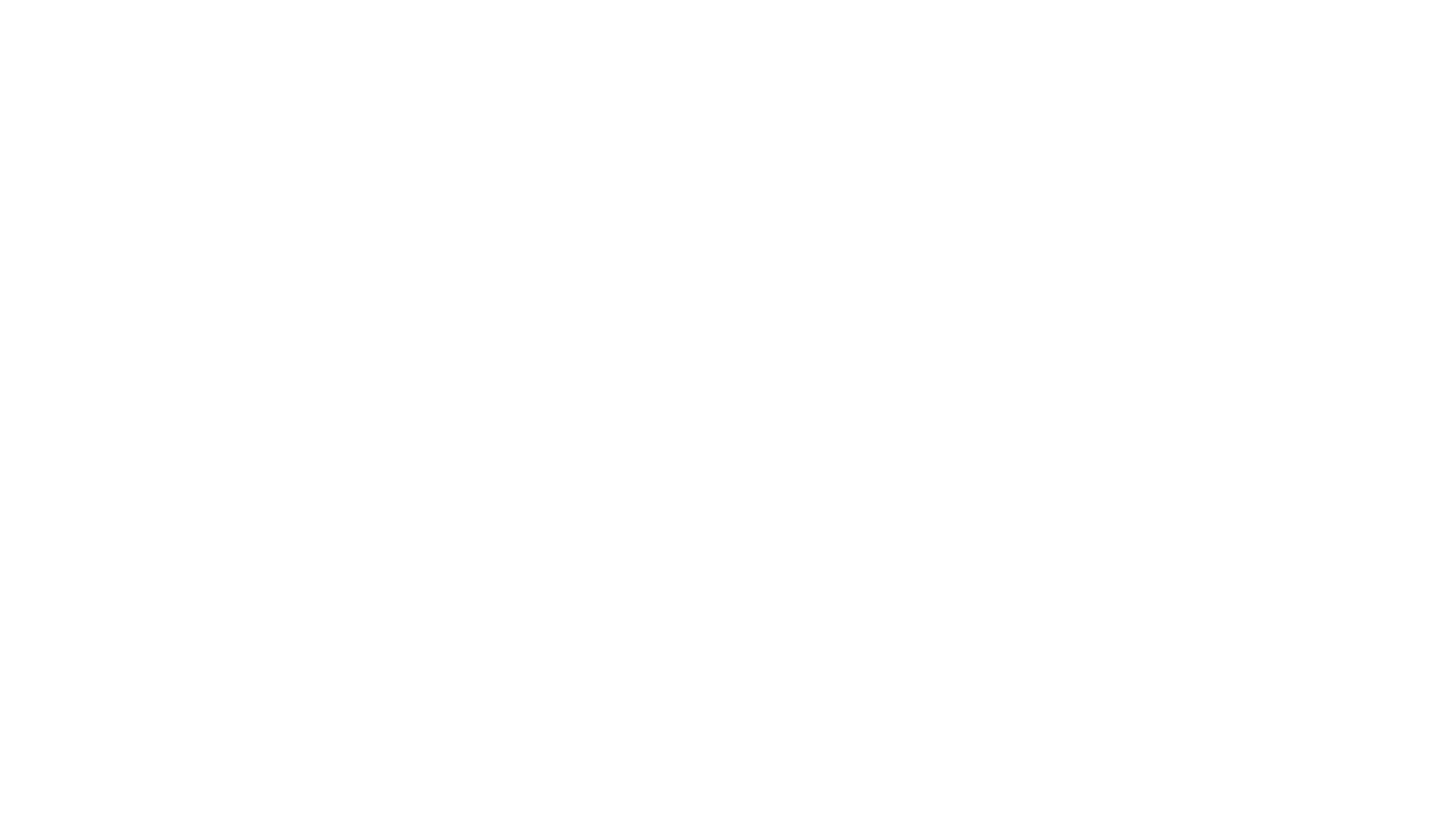آخر شعبان
”غبش المسلمات“
عود مرة أخرى إلى هذا الصائم ويومياته، بعد مرور عام – هجري على الأقل – على يوميات صائم التي بدأتها العام الماضي.
وما دفعني إلى العودة إلى كتابة يوميات صائم هذا العام أمور عدة، أذكر منها أن ”المسلمات“، أو ما يميل بعضنا – وربما كثير منا – إلى أخذه مأخذ المسلمات يزداد يوما بعد يوم، حتى صار غبشها يغطي الحقيقة. ولقد أفضى هذا بدوره إلى تزايد عدد ”أضرحة“ المقدسات التي لا يجرؤ أحد على دخول محاريبها، ولا يملكون إلا النظر إليها من بعيد، من وراء أبواب وأسوار حديدية، أصبح لمسها بركة.
ثم إن حال العرب والمسلمين اليوم مزر، ولا سبيل – في رأيي – إلى الإصلاح إلا بالانكفاء على النفس، وتشخيص المرض، ثم السعى إلى العلاج. وأنا أحسب أن خطابنا الديني بحاجة ملحة إلى التغيير.
في هذه اليوميات سأعرض – بإذن الله سبحانه – لبعض الأفكار في الدين والحياة بصفة عامة. وأنا مهموم بحال العرب والمسلمين، وما سأعرضه ليس سوى ”آراء“ تهدف إلى إثارة راكد الفكر في حياتنا، وخلع أستار التقديس عما ليس بمقدس، وإقحام العقل – هبة الله إلينا – فيما نأخذه مأخذ ”المسلمات“.
ولنبدأ بما يبدأ به الشهر الكريم دوما، وهو خلاف المسلمين في أصقاع الأرض حول أول أيامه، ومتى يبدأ. وهذه المسألة في القرآن الكريم ذاته موكولة إلى ”المشاهدة“، إذ يقول سبحانه في آيات الصيام (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، ويتسع لفظ (شهد) ليدل أيضا ”من حضر، ووجد خلال فترة حلول الشهر“. ونحن ندرك أن وسائل ”مشاهدة الهلال“ متغيرة من عصر إلى عصر، فإن كانت العين المجردة في زمن، فهي التليسكوب في زمن آخر، وهي الفلك في زمننا.
ولكن المسلمين لا يزالون يصرون على اعتماد الحديث النبوي (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)، ولا يزالون يصرون على أخذ ”الرؤية“ بمعناها الحسي – أي بالعين المجردة، أو بالاستعانة بالتليسكوب في أحسن الأحوال – الذي لا يعترف بتغير الأزمنة، ولا يعير الفلك المبني على العلم والحساب الدقيق أي اهتمام. ومن هنا ينشأ الخلاف بينهم على بداية الشهر دوما.
وهذه القضية تبين – من وجهة نظري -:
* أن منشأ الخلاف بين المسلمين هو ”الاعتماد على حديث“،
* وأخذ ”المعني الحرفي“ لما ورد في ذلك الحديث، دون التزحزح عنه، حتى وإن ضربوا خلال ذلك بالعلوم – ومنها الفلك – عرض الحائط،
* ويوحي هذا بأن ذاك الحديث ”مقدس“ لا ينبغي الحيد عنه، لا تفسيرا ولا تأويلا،
* ثم إنهم يوقعون أنفسهم – بفعلهم هذا – في تنافض كبير. ففي الوقت الذي يقبلون فيه بنتائج علم الفلك في تحديد مواقيت الصلاة لسنوات وسنوات، فهم يزورون عنه ازورارا شديدا في تحديد بدايات الشهور القمرية، وبخاصة شهر رمضان. وهم في ذلك – وهذا رأيي مرة أخرى – ينأون عن القرآن الكريم الذي أرشدنا إلى أن من آيات الله الكونية، حركة الكواكب والنجوم المبنية على حساب دقيق، كما يقول تعالى في سورة الأنعام آية ٩٦ (فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم).
وكم رأينا مسلمين ينتمون إلى عدد من الطوائف، ولكنهم يعيشون في مدينة واحدة من مدن بريطانيا يحتفلون بمقدم الشهر الكريم، وبقدوم عيد الفطر من بعده، في ثلاثة أيام مختلفات.
وهذا مثال واحد فقط على خطابنا الديني وما فيه من تهافت.
ورمضان كريم
١ رمضان ١٤٣٥
أفلا يتدبرون القرآن؟
في رمضان يكثر توافد المسلمين على المساجد، لأداء الصلوات ولقراءة القرآن الكريم. ويجاهد كثيرون منهم لختم القرآن. وأنا أريد أن أتوقف قليلا هنا عند تعاملنا مع القرآن خلال حياتنا، وبخاصة في رمضان.
أول المظاهر التي تلفت من يعيش بين المسلمين هو مشاهدة المصحف مهجورا – وإن كان مزينا محفوظا في علب صدفية وكأنه تحفة من التحف – في أركان البيوت، وفي السيارات، وفي المكاتب.
وقليل من المسلمين من يداوم على قراءة الكتاب الكريم، أما معظمهم فقد لا يقربونه إلا في رمضان لختمه، أو لقراءة قدر منه، كل بحسب مقدرته.
وينحو كثير من المسلمين عند قراءة القرآن إلى إتمام القدر الذي فرضوه على أنفسهم، أو تفرضه عليهم ”أحاديث“ يتبعون تعاليمها، دون كبير تدبر – كما أزعم – لما يقرأون.
وقد أخذ عدد غفير من المسلمين في العقود الأخيرة يقبلون على تعلم قواعد تلاوة القرآن، أو تجويده، وزاد بسبب ذلك عدد معاهد ومراكز تعليم قواعد التجويد.
ويكشف هذا القدر من الصورة – صورة تعاملنا مع كتاب الله تعالى – عن نهج شكلي، نزين فيه بالمصاحف أماكننا، ونزين فيه بالقراءة أصواتنا، ونهتم أيما اهتمام بـ”ختمه“، وبتعلم قواعد تجويده.
ولكن، هل نحرص على ”فهمه“ و“تدبره“، وفهم دوره في حياتنا،؟ وهل نعلم أولادنا قواعد فهم القرآن وتفهيمه؟
الجواب – من أسف – بالنفي، في معظم الأحوال.
ولهذا السبب عينه يجد المفتون والمهرفون، والمضللون، في فضائيات غطت سماءنا، أبوابا مفتّحة يدخلون منها إلى عقولنا التي اعتادت على الثقافة السمعية وتربت عليها، دون تساؤل أو معارضة، وتشيع من ثم مفاهيم خاطئة ومغلوطة عن الدين، وعن الرسول، وعن القرآن، وعن الجهاد، وعن اللباس والزي، وغيرها.
ولمواجهة هذا علينا أن نتمعن في آي القرآن، وكيف تحدثت عنه. ولهذا حديث آخر.
ورمضان كريم
٢ رمضان ١٤٣٥
القرآن في القرآن
القرآن الكريم كتاب أنزل ليُقرأ، ولفظ ”القرآن“ ذاته يدل على ذلك. ولهذا السبب – في رأيي – نزلت آي الكتاب منجّمة، أي في أوقات مختلفة، وليس مرة واحدة، حتى يسهل على العرب – وكانوا أمة ثقافة شفوية يقرض شعراؤها الشعر فيحفظه رواته عن ظهر قلب ليرووه من بعد في الأسواق والمحافل.
وذكر الله تعالى هذه السمة للكتاب في سورة القيامة حيث قال ”فإذا قرأناه فاتبع قرآنه“. وروى القرآن عن القسيسين والرهبان من النصارى أنهم ”وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق …“. فقد كان القرآن يُتلى فيستمع له الناس.
ولأنه كتاب أنزل ليقرأ فقد أرشد الله تعالى الداخلين في هذا الدين الجديد إلى السبيل التي يجب أن يقرأ بها، وإلى أدب الاستماع إليه.
ففي بداية القراءة وجب على القارئ الاستعاذة من الشيطان الرجيم ”فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم“ (النحل:٩٨).
وحثهم على قراءته وتلاوته ”فاقرؤوا ما تيسر من القرآن“ (المزمل: ٢٠)، وقوله تعالى ”وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن“ (النمل:٩٢). ولم يحدد الكتاب الكريم ”ختمة“ علينا إنجازها لأنه يعلم ما يشغل الناس في حياتهم، كما توضح آيات المزمل ”علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه“.
وخلال القراءة ينبغي أن يقرأ على مهَل ”وقرآنا فرقناه لتقرأه علر الناس على مكث“ (الإسراء ١٠٦)، وقوله تعالى ”ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيه“ (طه ١١٤).
ولا شك أن التمهل في القراءة يساعد على تدبر المعاني، ولم يدع الكتاب هذه النقطة لاستنتاجنا، بل ذكرها في غير آية بجلاء، كما في قوله تعالى ”أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها“ (محمد:٢٤). وقوله تعالى ”ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر“ (القمر:١٧).
ويساعد على التدبر أيضا حسن الاستماع، ”وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون“ (الأعراف:٢٠٤).
وآمل أن نضع هذه الآداب في التعامل مع القرآن نصب أعيننا ونحن نتعامل معه في حياتنا.
ورمضان كريم
٣ رمضان ١٤٣٥
لأمر أجل وأعظم
استكمالا للصورة التي رسمتها آي القرآن الكريم عن القرآن وتحدثتُ عنها في يومية الأمس، أود أن أشير إلى جانب آخر من الصورة نشاهده في حياتنا ونلمسه في تعاملنا مع كتاب الله العزيز، ألا وهو هجر القرآن.
وقد شكا الرسول عليه السلام إلى ربه قومه وتصرفهم مع القرآن ”وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا“ (الفرقان:٣٠).
ونحن أيضا في عصرنا ابتلينا بمثل هذا الهجر، كما وصفت ذلك في يومية الأول من رمضان، لكن هجرنا نحن أنواع:
* هجر القراءة، وثلة كبيرة منا تفعل ذلك مع اجتياح قنوات التليفزيون، وانشغال الناس الآن أكثر بالتواصل الاجتماعي عن بعد عبر مواقعه العديدة
* هجر التدبر، فمنا من يقرأ القرآن – أو أجزاء منه – ليزيح عن كاهله وردا ألزم نفسه به، لكنه – مع ذلك – لا يزال – في رأيي – هاجرا لتدبر معانيه وتفهمها حق فهمها.
* هجر المسلك، فمنا من يقرأ آي القرآن ويتدبر معانيها، لكنه يتوقف عن تبني القرآن وآيه في مسلكه اليومي. ويكاد هذا الهجر يعم المسلمين جلهم.
وثمة جانب آخر من الصورة عرضته آيات الله في قوله تعالى ”كما أنزلنا على المقتسمين. الذين جعلوا القرآن عضين“ (الحجر:٩٠-٩١)
وقيل في التفسير إن ”المقتسمين“ هنا هم أهل الكتاب، إذ آمنوا ببعض القرآن، ولم يؤمنوا ببعضه الآخر، فجعلوه ”عضين“ أي أجزاء. وقيل إن المقصود بهؤلاء من اقتسموا طرق مكة ليصدوا الناس عن الإسلام، وقال بعضهم القرآن سحر، وقال آخرون هو شعر، وقال بعضهم كهانة.
وأحسب أنه لا يزال يعيش بين ظهرانينا صنوف من هؤلاء. فمنهم من يستخدم القرآن وآياته في علاج السحر، أو في علاج أمراض بعينها. بل جعلوا لكل سورة أحيانا – أو آية، أو مجموعة آيات – خاصية علاج مرض بعينه، وأخرى لعلاج مرض آخر.
وهناك عشرات الأحاديث المنسوبة للنبي عليه السلام في فضائل كل سورة، وتأثير عدد مرات قراءتها. بل إن بعض من يؤمنون بهذا الباب، يفعلون شيئا عجبا، فإذا فقدوا شيئا، أخذوا يرددون وهم يبحثون عنه سورة ”الضحى“. وياليتهم محقون، ولو كانوا لاسترجعنا دولا فقدناها.
ليس من أجل ذلك أنزل القرآن العظيم، بل لأمور أجل وأعظم من ذلك في حياة بني البشر.
ورمضان كريم.
٤ رمضان ١٤٣٥
صورتان
في الوقت الذي يطلع علينا فيه أبو بكر البغدادي مطالبا أتباعه – في خلافة وهمية – بالقتال ”السلاح السلاح يا جنود الدولة، والنزال النزال“، وداعيا المسلمين في العالم إلى الهجرة إلى فسطاط الإسلام تاركين فسطاط الكفر، جمع اتحاد الجاليات العربية في جنوب إفريقية في اليوم الثالث من رمضان – بالتعاون مع المنتدى الإفريقي للأعمال – أكثر من مئتي شخص ما بين مسلم ومسيحي وهندوسي على الإفطار، ليشيع روح الود والتآخي بين أفراد المجتمع الواحد.
كانت دعوة الإفطار في حي ماي فير في جوهانسبيرج حيث تقطن أغلبية مسلمة، في بلد يبلغ فيه تعداد المسلمين حوالي مليوني شخص من بين ٤٩ مليون نسمة.
صورتان متباينتان، تبعد الشقة بينهما بُعد جنوب إفريقية عن العراق والشام جغرافيا، وتفرقهما رقعة شاسعة من الاختلاف الفكري.
في الأولى أناس يعيشون في ماض نسجوه في خيالهم ورسموا هم ملامحه بأفكار ومفاهيم خاطئة مخطئة وكأنهم سائرون نياما.
يتزيون بزي ليس من لباس عصرهم، ويبدون في مظهر يشبه صور ممثلي مسلسل تاريخي لمخرج مبتدئ.
ويتكلمون بمفردات ليست من كلام الناس، بل تعود لمعجم عصر قديم، ينتمي إليه ابن تيمية، تتردد فيها ألفاظ الجهاد، والقتال، والحرب، والشهادة، والدار الآخرة، والجنة، وفسطاط المسلمين، وفسطاط الكفار، وأهل العقد والحل .. إلخ.
والعالم لديهم قسمان فقط: فسطاط المسلمين، وفسطاط الكفار، والعلاقة بين الفسطاطين هي الحرب والقتال حتى ينتصر فسطاط على آخر. وبنو الإنسان في تلك الحرب أدنى من الحيوان، يقتلون ويذبحون ويصلبون، دون اعتبار لأي شيء.
وهم عندما يتعاملون مع القرآن الكريم، يجعلونه ”عضين“، فيأخذون منه ما يرضي عقولهم وأهواءهم، ويدعون غيره، ويبتسرون الآي من سياقها، مستشهدين بآيات مبتسرات تضيع معها معاني الكتاب الكريمة.
ثم يطلع هؤلاء علينا وينسبون أنفسهم إلى الإسلام. وهذا إسلام لم أعرفه.
أما الصورة الثانية، فيزينها مسلمون سمحاء يطبقون مبادئ دينهم السمحة، وهم في الوقت ذاته يعيشون عصرهم، يلبسون كما يلبس أبناء بلدانهم، لأنهم يؤمنون أن الزي وليد البيئة، ولو نشأ النبي محمد عليه السلام في المكسيك للبس لباسهم ولتزي بزيهم.
ويظهرون بمظهر ذويهم من أبناء وطنهم.
كلامهم هو كلام من يعاشرونهم، والعالم لديهم هو العالم الذي يعيشونه، تتعدد فيه العقائد والأعراق والميول، دون أن تفصل مواطنا عن آخر. وهم يقرأون القرآن الكريم فيفهمون مقاصده وما يرومه من المؤمنين.
وهؤلاء يُظهر مسلكهم، قبل مظهرهم وملبسهم، أنهم مسلمون حقا.
ولكن وسائل الإعلام من أسف لا تسلط الضوء إلا على ما ”يفرقع“ ومن ”يفرقع“.
ورمضان كريم
٥ رمضان ١٤٣٥
سؤال وحملة
يؤرقني دوما – عندما أشاهد زعماء الجماعات المتطرفة المنسوبة إلى الإسلام ادعاء – سؤال هو: هل هناك شيء أفاد به هؤلاء، الإسلام، أو المسلمين، أو العرب، أو الإنسانية؟
قد يبدو السؤال ساذجا، إذ إن إجابته لدى معظم المهتمين بهذا الشأن متوقعة. لكنه مع ذلك وفي رأيي سؤال ذو أهمية.
فإن كانت إجابته بالنفي، كما أحسب، أي لا يمكن أن نضع أيدينا على شيء يمكن أن تكون تلك الجماعات قد أفادت به مواطنيها، أو عالمها الصغير أو الكبير، فإن تلك الإجابة ذاتها تواجهنا باحتمالين: فإما أن تكون تلك الجماعات قد تعرت وبان زيفها وزيف ادعاء انتسابها إلى الإسلام، لأن البشرية جمعاء تعرف حقيقة الإسلام وإسهامه لحضارة الإنسان، وإما أن يكون ما تنتهجه وتدعو إليه غير صالح للبشرية ولا يعود عليها إلا بالإضرار.
إن الإنجاز الوحيد الذي حققته تلك الجماعات المدعية هو تشويه صورة الإسلام في عيون العالم، وبخاصة العالم الغربي.
فقد قدمت – عبر وسائل الإعلام – صورة بشعة، همجية، بربرية، عنصرية، لـ”دين“ لا يمت إلى الإسلام أبدا بصلة. والتصقت تلك الصورة الوحشية البشعة – من أسف – بالإسلام في أذهان كثير من الغربيين، أناسا، وكتابا، وسياسيين.
وهكذا أخذت سهام الانتقاد تطلق – بجهالة – على الإسلام والمسلمين. وكان آخر ما قرأته في هذا الصدد ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية.
إذ شنت منظمة تديرها سيدة مناهضة للإسلام تدعى باميلا جيلر حملة على جنبات عشرين حافلة من حافلات واشنطن العامة تستمر شهرا، وضعت فيها إعلانا استخدمت فيه صورة قديمة للقاء هتلر بمفتي القدس أمين الحسيني في برلين عام ١٩٤١ للتحريض على وقف المساعدات الأمريكية للدول الإسلامية لأن الدين الإسلامي – في رأيها – يحرض على كراهية اليهود.
وكانت باميلا قد شنت من قبل حملة على محطات الحافلات كتبت في ملصقها ”في أي حرب بين الإنسان المتحضر والمتوحش، أيدوا الإنسان المتحضر. أيدوا إسرائيل. اهزموا الجهاد“.
والعالم لدى باميلا هو فسطاط إسرائيل حيث الإنسان المتحضر من جهة، وفسطاط المسلمين حيث الإنسان المتوحش، من جهة أخرى.
والمحمود أن هيئة المواصلات الأمريكية في واشنطن اعترضت على صياغة الملصق، خاصة استخدام كلمة ”متوحش“، لأنها تنتهك سياسة الهيئة التي تنص على عدم استخدام ألفاظ محقرة في الإعلانات. فرفعت باميلا الأمر إلى القضاء، وجاء حكم المحكمة لصالحها.
فماذا قالت المحكمة؟ لقد بررت حكمها بـ”حماية حرية التعبير السياسي“. وظل الملصق بصياغته العنصرية.
فمن هو الذي ولد هذه الكراهية ضد الإسلام سوى أولئك المتطرفين المنتسبين ادعاء لإسلامنا السمح، وهو منهم براء.
ورمضان كريم.
٦ رمضان ١٤٣٥
من تحفة الأطفال إلى إتحاف فضلاء البشر
في قسم اللغة العربية واللغات الشرقية – حيث أنهيت دراستي الجامعية الأولى – بجامعة الأسكندرية، كنا ندرس مادة ”الدراسات الإسلامية“. وفيها درسنا قسطا لا بأس به عن القرآن الكريم وتاريخه، وتفسيره، وعلومه، والحديث وتاريخه وعلوم مصطلحه. لكنا لم ندرس قواعد تجويد القرآن.
ولما أنهيت دراستي أحسست بنقص في تحصيلي العلمي في هذا الباب، وأردت سد هذا النقص.
كان يوجد في حارتنا مسجد صغير – كنا نسميه ”زاوية“ – كنا نصلي فيه صلاة الجمعة، وبعض الصلوات الأخرى إذا تيسر لنا ذلك. كان يدير المسجد ثلاثة: إمام، ومقيم شعائر، ومؤذن. وكان الإمام رحمته الله عليه رجلا دمث الخلق، وذا ثقافة رفيعة. ولم يكن مبصرا من بين الثلاثة إلا المؤذن.
وذات يوم – وبعد صلاة المغرب – عرضت على الإمام، وكان اسمه الشيخ سليمان، أن أقرأ عليه كتابا في قواعد تجويد القرآن. فرحب الشيخ وفي اليوم التالي أحضرت كتاب ”تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن“ للجمزوري. والكتاب منظومة مختصرة في قواعد التجويد، وكان بها شرح موجز لكل بيت من المنظومة. كنت أقرأ والشيخ يشرح، ويعطينا – أنا والمؤذن الذي كان يداوم على حضور جلساتنا تلك – أمثلة للقاعدة من القرآن. وأنهيت معه قراءة التحفة، ثم بدأنا بقراءة المقدمة الجزرية.
وتوسعت دائرة درس المغرب، فقرأت عليه أيضا متن العشماوية في فقه الإمام مالك، وجزءا من حكم ابن عطاء الله السكندري. وتوفي الشيخ وظللت أحمل له في صدري جميلا لن أنساه ما حييت.
ثم انطلقت بعد ذلك إلى أمهات الكتب في قواعد التجويد – بعد الانتهاء من مرحلة الأطفال والغلمان – فتعرفت على كتاب ”النشر في القراءات العشر“ لابن الجزري، وهو أشهر الكتب في هذا المجال العلمي، وكتب أخرى مثل كتاب ”إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر“ للشيخ أحمد بن محمد البنا الدمياطي. وتعرفت مع تلك الكتب على نبع ثر من المعرفة قد لا يدرك أهميته كثيرون.
فمع حفظ ذلك التراث لقواعد التجويد، وكيفية قراءة الأولين للقرآن الكريم، والقراءات المختلفة التي عرفنا منها سبعا، ثم زادت إلى عشر، ثم بلغت أربع عشرة، حفظ أيضا لنا تراثا يمكننا أن نتعرف بواسطته – مع غياب التسجيلات الصوتية – على تغير الأصوات في اللغة العربية.
فمن خلال تلك القواعد عرفنا – مثلا – أن أصواتا مثل ”القاف“، و”الضاد“، و”الجيم“، لم تكن تنطق كما ننطقها نحن اليوم. ولا غرابة في ذلك إذ إن اللغة بأصواتها المختلفة، وبني كلماتها، وتراكيب جملها، ودلالات مفراداتها يعتورها التغير عبر العصور وعبر البيئات.
وقضية حفظ القرآن الكريم للعربية التي يثيرها بعضنا في هذا السياق، تعني حفظ تداولها واستخدامها، إذ يحتاج إليها كل مسلم لقراءة قسط من القرآن في صلواته. لكنها لا تعني أبدا حفظ اللغة – بمكوناتها المختلفة – جامدة دون أن يطرأ عليها تغير.
ولنأخذ هنا مثالا واحدا فقط للتدليل على التغير الذي طرأ على أصوات العربية، وهو صوت ”الجيم“.
والجيم صوت أصفه بأنه ”قلق“ لأنه تعرض لتغيرات كثيرة، فهو في جنوب اليمن ومناطق من الحجاز وعُمان ومصر ينطق مثل صوت الـ”g“، وفي بلاد الشام الكبرى ”j“، وفي الأردن ”dj“، وفي بعض دول الخليج ”y“.
وتدلنا قاعدتان من قواعد التجويد، هما قاعدتا اللام الشمسية والقمرية، والقلقلة – دون أن أخوض في تفصيل ذلك هنا – على أن ”الجيم“ العربية الأصلية هي الجيم كما ينطقها أهل القاهرة. وهذا استنتاج تدعمه حقيقة لغوية معروفة وهي أن اللغات السامية – ومنها العربية – لم تعرف صوت الـ”dj“، بل عرفت صوت الـ”g“.
ولهذا فإن قواعد تجويد القرآن الكريم من هذه الوجهة جديرة فعلا بالدرس المتأني.
ورمضان كريم
٧ رمضان ١٤٣٥
لعنة ضمير الغائب
كنا نتحلق في بيتنا في تلهف قبيل غروب الشمس حول ”طبلية“ خشبية مستديرة انتظارا لصوت مدفع الإفطار. كنا أسرة صغيرة فقدت ربها في حادثة، فأصبحت ترعاها الأم التي ربت ثلاث بنات وولدين. وضحت أمنا بكل شيء في سبيل تلك الرعاية والتربية.
وكلما يهل رمضان أتذكر جمعنا ذاك.
أما اليوم فقد تفرقت بنا السبل، فأصبحنا أسرا أصغر. فارقتنا أمنا وكان فراقها مؤلما، شعرت أنا معه كطفل كان يجلس في حجر أمه، ثم جاء من انتزعها منه انتزاعا فوقع الوليد على الأرض باكيا، يتلفت يمينا ويسارا بحثا عن دفء الحجر الذي فقده.
ثم لحقت بأمي شقيقتنا الكبرى التي كانت لنا أما، تحب وتحنو، وفي الوقت ذاته نشعر في معاملتها لنا فخرها واعتزازها بنا. وكان لنا في أختنا الوسطى عزاء. فقد كانت طيبة القلب، غير أن القدر لم يمهلنا طويلا لنغرف من براءتها وصفو طيبتها، فآثر أن يطوي صفحتها ليخفف عنها آلام المرض الذي ألم بها.
واليوم هُجر بيتنا، ورفعت الطبلية إلى ركن قصي، فلم تعد توضع في وسط غرفتنا، كما كانت عند تناول الطعام. واستقر المقام بنا، كل في مدينة، بل ربما كل في بلد.
لم يعد رمضان كما كان. لقد فقد من حلاوته وفرحته الكثير. بل لم تعد للمناسبات – معظمها أحيانا – طعمها القديم المقطّر. ولم تقتصر معاناتي على ألم فقد الأحبة: أبي، وأمي، وأختيَّ، وغيابهم عن جمعنا على طبلية الطعام، بل تمادى الألم حتى إلي الكلام، بالنسبة إليّ على الأقل. فقد تفشى في أحاديثي الفعل الماضي اللعين، كان، وكُنا، وكُنتُ، وكانوا. وأصابتني لعنة ضمير الغائب، فهو الضمير الوحيد الذي لم يعد منه فكاك عند الحديث عنك يا أبي ويا أمي، ويا أختيَّ.
رحمكم الله فهو أرحم الراحمين.
ورمضان كريم.
٨ رمضان ١٤٣٥
أمر عجاب
أثار أحد الأصدقاء في مدينة برمنجهام البريطانية هذه الأيام مسألة اتباع بعض أئمة المدينة التي تعيش فيها غالبية مسلمة تنتمي إلى أصول من جنوب شرق آسيا لقاعدة تعرف بقاعدة نزول الشمس إلى الدرجة ١٨ تحت مستوى الأفق لحساب وقت صلاة الفجر، ووقت الإمساك عن الطعام والشراب في رمضان.
وكانت نتيجة تطبيق هذه القاعدة أن حدد هؤلاء الأئمة موعد صلاة الفجر عند الساعة الواحدة والنصف صباحا. وفرضوا بذلك على المسلمين في مناطقهم صوم إحدى وعشرين ساعة.
وهذا في عرفي أمر عجاب.
وقد غفل هؤلاء الأئمة – خلال جدالهم حول المسألة الذي يدور في معظمه على أحاديث منسوبة للنبي الكريم – عن أصل جوهري من أصول القرآن الكريم، في زحمة التوهان بين ”الأحاديث“. وهذا الأصل هو ”التيسير“.
ويتضح هذا الأصل في غير آية في كتاب الله تعالى. أذكر منها هنا:
* ”ما جعل الله عليكم في الدين من حرج“
* ”إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر“
* ”لا يكلف الله نفسا إلا وسعها“
* ”ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى“
وجميع هذه الآيات ترمي إلى معنى واحد مهم، وهو أن دين الله يسر، وليس عسرا. وجميعها أيضا يجب أي قاعدة، وأي ”حديث“، ورأي أي متنطع.
وكثيرا ما تثار في رمضان – خاصة خلال حلوله في فصل الصيف في دول أوربية مثل بريطانيا – مسألة عدد ساعات الصوم، وبعض الفتاوى التي تحاول التخفيف عن الصائمين بنصح من تزيد ساعات الصيام في بلده على ١٨ ساعة، بتبني توقيت أقرب بلد إليه، أو توقيت مكة.
وأحيانا يتوسم بعض الأصدقاء فيّ خيرا فيلقون بالقضية على، لأقول رأيي. ورأيي هنا واضح وصريح.
وأنا أُقيمه على قاعدة ”التيسير“ التي أشرت إليها. لكنني أردف ذلك بالقول بأن جميع الشعائر الدينية فيها مكابدة للنفس، في الصلاة مكابدة، وفي الصوم، وفي الحج، وحتى في دفع الزكاة.
لكن إذا بلغت المكابدة حد المشقة على النفس فتؤدي إلى الإضرار بها، أو تهلكتها، يجب اللجوء إلى استعمال ”الرخص“، والتيسير لأن النفس البشرية عند الله تعالى والحفاظ عليها أهم من أداء الشعيرة.
ثم إن هناك جانبا نفسانيا لا ينبغي أن نغفله، وهو أن التشدد على النفس، مرة بعد مرة، قد يفضي بصاحبه إلى ”النفور“ من الدين، وربما الانفضاض عنه كلية. وصدق القول المأثور ”لن يشادّ الدين أحد إلا غلبه“.
ورمضان كريم
٩ رمضان ١٤٣٥
الإعلام والجانب المظلم
ليس ثمة نشرة أخبار، أو برنامج إخباري في معظم وسائل الدولية والعربية تخلو من صور المتطرفين المنتسبين ادعاء إلى الإسلام، وآخر ما فعلوا. ولابد أن نقر بأن هؤلاء المدعين، خاصة أعضاء تنظيم العراق والشام، أحسنوا استغلال مواقع التواصل الاجتماعي، في نشر ما يريدون نشره. وجرجروا وراءهم جميع وسائل الإعلام – تقريبا – فرددت وبثت ما نشروه، وكانت لهم بوقا.
إن وسائل الإعلام – في رأيي – تتحمل مسؤولية ضخمة في نشر الفكر المتطرف، فهذا الفكر – بالنسبة للإعلام هو الذي يصنع العناوين، وهو الذي ”يفرقع“، وهو الذي يرفع عاليا أعداد المشاهدين والمستمعين والقراء.
وما إن يقع حادث أو هجوم، حتى تتابعه وسائل الإعلام لحظة بلحظة، ويتهافت المحللون على غرف الأخبار والاستوديهات لتحليل الخبر، وإلقاء الضوء عليه. ثم يكتب الكتاب نبذا عن هذه الجماعة أو تلك، أو هذا الزعيم المتطرف أو ذاك، ويظل الخبر هو الشغل الشاغل لوسائل الإعلام قاطبة.
وأخذ عدد المحللين المتخصصين في الجماعات الإسلامية يزداد ويزداد.
وعلى هذا النحو يتوفر للجماعة ولأعضائها منبر مجاني، يبث الرعب بين الأفراد، وينشر رسالتها.
وكان عاقبة ذلك – من أسف – تركيز الأضواء على جانب واحد مظلم، مهما كانت تلك الأضواء، ينسبه الجاهلون للإسلام زورا. وغفل الإعلاميون وعميت وسائلهم عن الإسلام الأصيل الحقيقي، وجوانبه.
من منا يسمع عن التصوف والصوفية من المسلمين الذين يمثلون حركة روحية مشرقة كان لها تأثير كبير في الفكر الغربي. وكم من برنامج يتحدث عن هذا الجانب الروحي الزاهد في الإسلام؟
وأين المسلمون التقدميون، الذين يوجدون – بحمد الله – في كل أرجاء العالم تقريبا، في أمريكا، وأوروبا، والعالم العربي، بجميع أركانه، حتى وسط بيئات عرفت بنهجها المتشدد، تعرفهم قاعات الدرس في الجامعات، ولهم كتب ودراسات حافلة بآراء تقدمية نيرة، وتفسيرات جديدة معاصرة، تكشف جانبا مضيئا ومشرقا لا تسلط وسائل الإعلام الضوء عليه؟
وعلى الرغم من ذلك لا تراهم على شاشات التليفزيون إلا قليلا. ولا ترى – مثلا – محللين يتخصصون في الخطاب التقدمي الإسلامي. وإن كتب أحد هؤلاء التقدميين أو تحدث، وصم بأنه ”علماني“ أو ”ليبرالي“، وهاتان الصفتان في عرف كثيرين في مجتمعاتنا مساوية لوصف ”ملحد، أو كافر“.
ولا أريد أن أجاري سوء ظني فأقول إن بعض وسائل الإعلام ربما تعمد إلى هذه التركيز على الجانب المظلم المنتسب زورا إلى الإسلام، وإلى التغافل عن جوانب الإسلام المضيئة، لتشويه الصورة. وإن لم يكن ذلك صحيحا، فلماذا لا تركز الضوء نفسه على ديانة مرتكبي الهجمات من الأوربيين أو الأمريكيين، ومذاهبهم؟ بل تكتفي بذكر اسمه، دون إشارة إلى دينه أو مذهبه.
أفلا يعرّف العربي، أو الأفغاني، أو النيجيري، إلا بدينه، وبخاصة إذا كان مسلما؟
ورمضان كريم
١٠ رمضان ١٤٣٥
”عش الحدث“ وموضوعية الإعلام
لا أعتقد أنه من المناسب أن أواصل كتابة يومياتي هذه اليوم على ما اعتدت عليه مع ما يجري في غزة من عدوان إسرائيلي على الفلسطينيين.
ولقد صدمني أمران وأنا أشاهد الأخبار، وكذلك وأنا أتصفح موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
أما الأخبار فقد شاهدتها في محطة تدعي الحيادية، وتدرب صحفييها على الموضوعية.
ونعم الموضوعية!
كان خبر غزة هو الخبر الثاني في موجز النشرة. وقال المذيع إن التوتر يتصاعد وإسرائيل ”ترد“ على صواريخ أطلقت من غزة. والفلسطينيون يقولون إن الغارات الإسرائيلية قتلت …
فأنت في الموجز عرفت من صيغة الخبر ”إسرائيل ترد“ أن هناك اعتداء على إسرائيل، وعرفت أيضا موضوعية المحطة في قولها ”الفلسطينيون يقولون“ عند ذكر قتلى الفلسطينيين: عددهم وسبب قتلهم، فصياغة الخبر توحي بأن المحطة ”تشكك“ في سبب القتل، وعدد القتلى فتنسبه لمن ذكره.
وأنت الآن مهيأ لسماع الخبر ذاته.
وقد قسمت المحطة الخبر إلى قسمين: الأول عن صواريخ حماس على عسقلان، ومتابعة مراسل المحطة للإسرائيليين وسيره معهم وهم يتزاحمون على باب أحد المخابئ، فهو ”يعيش“ الحدث، تطبيقا لشعار المحطة. ولا يعاني الإسرائيليون من الصواريخ فقط، بل هناك ”مصيبة“ أخرى تتمثل في مسلحين حاولوا التسلل إلى داخل إسرائيل وبث الرعب بين الأبرياء.
وهكذا اكتملت لديك أيها المشاهد الصورة التي لابد أن ينفطر بعدها قلبك على الإسرائيليين الذين يلاحقهم الضرب من السماء بالصواريخ، ومن الأرض بالمسلحين المتسللين.
وما أتي بعد ذلك في نصف الخبر الثاني، وصور وضع الفلسطينيين وسط الغارات الإسرائيلية التي ليست سوى ”رد“، ربما لن يلفت انتباهك وقد وضعك نصف الخبر الأول في ”إطار“ ذهني من الصعب الخروج منه.
أما ماجاء في فيسبوك فقد ورد في بعض التعليقات العاطفية المتحمسة التي – للأسف – بدت وكأنها تبدي شماتة فيما تلاقيه ”حماس“.
وهنا لا بد من وقفة.
فقد أخذت تظهر في الشهور الماضية موجة غضب وكره وبغضاء وهجوم بغيض على إيران بين الشباب – وربما الكبار أيضا – في الخليج، تصور إيران وكأنها العدو الأوحد للأمة. يغذي هذه الموجة فكر متعصب ضد الشيعة. ويغالي أصحاب هذا الفكر في عدائهم لإيران إلى الحد الذي يتسامحون فيه مع إسرائيل، بل يعرضون عليها المبادرات – التي ترفسها ولا توليها أي اهتمام – ويكادون يتوسلون إليها للتفاوض معهم. ولكن هل عرض أحدهم على إيران أي مبادرة؟
وفي الفترة ذاتها برزت في مصر موجة مماثلة من البغض والرفض للإخوان المسلمين، وبلغ حد الرفض لهم مبلغا مدمرا، يتحدث معه بعض المصريين عن الإخوان وكأنهم ”أجانب“، أو ينتمون إلى شعب آخر. وظهر هذا جليا في بعض الأغاني الباعثة على الكراهية والفرقة بين أبناء الشعب المصري الواحد.
ودفعت كراهية الإخوان كثيرا من المصريين – بغباء للأسف – إلى قبول ما هبت ثورتهم في الخامس والعشرين من يناير لرفضه والتخلص منه. ولست أرى في ذلك ألبتة أي ممارسة صحية أو صحيحة للديمقراطية.
بعض الإخوان المسلمين المصريين أخطأ، فلماذا لا ندع القضاء يقضي في أمرهم، إن كان نزيها؟
وحدث الشيء نفسه مع حماس والفلسطينيين، بعد أن ترددت أقوال عن أن لبعض أعضاء حماس دورا في بعض الأعمال خلال فترة الثورة. وطغت على بعض المتسرعين موجة كراهية ورفض للفلسطينيين.
ومن هنا وجدت تلك التعليقات الشامتة سبيلا لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التعميم الأعمى الذي لا يسمع لصوت العقل، ولا يهمه أن ينتظر حكم القضاء.
ونسي هؤلاء الرافضون للفلسطينيين برمتهم، ونسي من رفضوا إيران وأشاعوا الكراهية ضدها، ونسي من رفضوا الإخوان المسلمين المصريين ممن لم يقترفوا إثما أو جرما، أن المستفيد الوحيد من هذا كله: من فرقة المسلمين، وفرقة العرب، وفرقة المصريين وانقسامهم، إنما هو إسرائيل. ولا أظن أبدا أنها كانت تستطيع الإقدام على ما أقدمت عليه لولا هذه البيئة الخصبة التي وفرها لها بعضنا، من أسف.
ولنردد مع محمود درويش:
”غزة لا تتقن الخطابة، ليس لغزة حنجرة، مسام جلدها هي التي تتكلم عرقاً، ودماً، وحرائق“
ورمضان كريم
١١ رمضان ١٤٣٥
الله يرحمك يا زمان
بادرتني صديقة لي بسؤال، أحسست لأول وهلة، بأنه غريب. قالت:
– لماذا لم يعد لرمضان طعم، كأيام زمان؟
ولو كانت صديقتي تعيش في لندن لالتمست لها العذر في شعورها، وفي سؤالها. إذ إننا – نحن المقيمين في بريطانيا، أو في دول غربية بصفة عامة – نفتقد في رمضان، وفي المناسبات الدينية الأخرى التي يتجمع فيها الأهل والأقارب للاحتفال، دفء الروح الاجتماعية والجو الاجتماعي الذي يوجد في دولنا العربية، وحتى الإسلامية، ويتمثل في التزاور، واللقاء على موائد الطعام، وفي المساجد أحيانا، والحدائق أحيانا.
وهي أنشطة ربما يتعذر علينا ممارستها هنا بسبب ساعات العمل الطويلة، وبعد المسافات بين مساكن الأصدقاء، فلا يتبقى لنا من الوقت إلا القدر الذي تقضيه مع أسرتك الصغيرة. ويزيد هذا الفقد من شعورنا بالغربة أكثر.
أما صديقتي فلم تعد مقيمة في بريطانيا، بل أصبحت الآن من سكان العاصمة المصرية. فهل صحيح – كما تقول – أنه لم يعد لرمضان طعم، كأيام زمان؟
أظن أن ما قالته فيه شيء كبير من الصدق. ولهذا أسباب.
منها أن طعم المناسبات والأيام بالنسبة إلينا يختلف بحسب العمر. فرمضان أيام زمان – حينما كنا أطفالا، لا نحمل على كواهلنا الصغيرة سوى هموم صغيرة، وحينما كان أحباؤنا الذين يحنون علينا موجودين حوالينا بطلتهم، وبأصواتهم، وبحركاتهم، وبمرحهم، وبنكاتهم، وعندما كنا نلقي العبء كله عليهم، وكان حتى وجودنا، نحن الصغار، مبعث سعادة وابتهاج أينما جرينا، وأينما لعبنا، وأينما جلسنا، – كان رمضان فعلا وقتها جميلا وكان له طعم مختلف عما هو عليه اليوم.
ومن هذه الأسباب أيضا أن الناس – حتى في بلادنا – أصبحوا بسبب ما يعانونه من مصاعب ومشكلات في حياتهم اليومية أكثر فتورا، إذ فقدوا وقدة العواطف تجاه الآخرين. وأخذ كل واحد ينزع إلى الانزواء في بيته مع أسرته.
ولمست أنا هذا بنفسي عندما أنهيت دراستي في لندن وعدت للعمل في القاهرة، فلم أجد في استقبال الناس لي، وكان لي بينهم أصدقاء كنت أحسبهم من أعزهم، الحرارة التي كنت أحس بها أيام زمان. ولم يدعني أحد من هؤلاء – مثلا – إلى بيته على فنجان من القهوة أو الشاي معا.
وصدمني هذا الفتور في العلاقات، لكني لم أشكُ حتى تركت القاهرة.
كما أن مصر بوجه خاص واجهت – ولا تزال تواجه – مشكلات بسبب الثورة وما تبعها من إحباط، فأصيب الناس باكتئاب، عزفوا معه عن الحياة الاجتماعية، والانخراط مع الآخرين في أنشطة اجتماعية، قد لا يكونون مهيئين لممارستها كما كانوا في الماضي، وربما تكون أحيانا فوق طاقتهم النفسية والمالية.
فهل مع هذا سيظل لرمضان أو حتى شوال طعم. الله يرحمك يا زمان.
ورمضان كريم
١٢ رمضان ١٤٣٥
جينا والأفعى وعذاب القبر
قرأت في الصحف خبرا غريبا فحواه أن امرأة رومانية ادعت أنها تلقت اتصالاً من جدتها المتوفاة، إذ فوجئت بصورة تلك الجدة على هاتفها المحمول، وكأن حول عنقها شيء يشبه الأفعى.
وسارعت جينا ميهاي، التي لم تتعد الرابعة والثلاثين من عمرها، إلى أحد العرافين لتعرف حقيقة الأمر. فقال لها العراف إن جدتها أرسلت هذه الصورة من العالم الآخر، وقال لها إن الأفعى التي حول رقبتها تشير إلى أنها تُعذّب في الحياة الأخرى، بسبب الخطايا التي ارتكبتها في حياتها.
ولامت جينا المسكينة نفسها، وحملتها مسؤولية العقاب الذي تلقاه جدتها، إذ لم تزر قبرها منذ فترة طويلة، ولم تضع الأطعمة والحلويات عليه، كما هي عادة الرومانيين في الأعياد الدينية.
لقد أكد لي هذا الخبر أن في العالم أناسا آخرين يؤمنون بفكرة ”عذاب القبر“، هذه الفكرة التي ترهب وترعد فرائص ملايين المسلمين، ويستغلها كثير من دعاة الفضائيات في ترهيب الناس من أجل إحكام قبضتهم عليهم.
ونحن لو تدبرنا القرآن الكريم – كما أدعو دائما – لعرفنا أن هذه الفكرة منافية تماما للقرآن، ومخالفة لتعاليمه، وهي فكرة لا أساس لها فيه، بل تعتمد أساسا على ”أحاديث“ مفتراة.
وكنت قد كتبت في يومياتي العام الماضي شيئا عنها، أود أن أطرحه عليكم هنا.
ثمة كتب تغير حياة قارئيها، وسأحدثكم هنا عن واحد من تلك الكتب التي هدمت أسطورة كانت تعشش في ذهني، مثل غيري من معظم المسلمين، بل كانت تلك الأسطورة جزءا من عقيدتي، لكني – والحمد لله تعالى – برئت منها بفضل ذلك الكتاب.
الكتاب الذي أتحدث عنه هو “حقيقة عذاب القبر”، وهو من تأليف جواد موسى محمد عفانة.
وقد وقعت على هذا الكتاب في رحلة من رحلاتي إلى الأردن، حيث تكون لي دوما جولة على المكتبات فيها لأرى وأتعرف على ما لا يتوفر في مكتبات لندن من كتب عربية.
موضوع الكتاب ذو صلة بحديث يومية الأمس. فأنا أزعم أن أكثر من تسعين في المئة من المسلمين ورثوا الإيمان بفكرة “عذاب القبر”، ضمن ما ورثوه عن آبائهم، دون أن يعملوا العقل فيها. ولا أبرئ نفسي، فهكذا كنتُ.
وموضوع “عذاب القبر” من الموضوعات الأثيرة لدى كثير من خطبائنا على المنابر، وفي الفضائيات. بل يحزنني كثيرا أنه أخذ يهيمن على عقول شباب “الدعاة” أيضا. فقد شاهدت ذات مرة في قناة “إقرأ” الفضائية أحدهم وقد اصطحب الكاميرا ونزل في أحد القبور، خلال حديث عن القبر وعذابه.
ويغرق الدعاة في هذا النوع من الحديث فيطعّمونه بأساطير أخرى تصلح سيناريو جيدا لفيلم مرعب، ترى فيه “حنشا (أي ثعبان كبير) أقرع”، لكنك لا ترى “حنشا كث الشعر”، وترى “حُفرا من النار” … وهكذا.
وتكمن جاذبية الموضوع في أن فيه وسيلة سهلة لترهيب الجمهور – دينيا – وإذا خضع جمهورك بالخوف، فقد أصبحت تملك قياده.
لكن ما هي حقيقة “عذاب القبر”؟ الفكرة برمتها – لو فكرنا فيها بروية وتعقل – مخالفة للقرآن الكريم، ولفكرة البعث والحساب التي هي ركيزة ذات خطر عظيم من ركائز عقيدة المسلم.
القرآن من أوله إلى آخره مبني على عدة عقائد من بينها عقيدة البعث يوم القيامة، ثم وضع الميزان، والحساب: حساب أعمالنا في الدنيا، ثم الجزاء عليها أو الثواب، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. فهل ساءلنا أنفسنا: كيف يكون ثمة عذاب قبل الحساب؟ أليس في ذلك افتئات على الله جل وعلا، واتهامه – حاشاه – بالظلم؟ وإلا ما تظنون بحاكم يذيق الناس العذاب صنوفا وألوانا قبل التحقيق معهم، وقبل معرفة الحقيقة، ومعرفة إن كانوا جناة أو أبرياء!
إن فكرة “عذاب القبر” تهدم فكرة الحساب يوم القيامة من أساسها، التي هي عماد العقيدة الإسلامية.
وهذه الفكرة – وهنا النقطة المهمة – لا سند لها ألبتة في القرآن الكريم وآيه الكريمة. وسندها الوحيد لدى مروجيها عدد من “أحاديث” ما أنزل الله بها من سلطان، أو ربما على أكثر تقدير أسيء فهمها.
وتعالوا نسأل هؤلاء المروجين: إن كان في القبر حساب، فلماذا تروون عشرات الأحاديث عن “عذابه”، ولا تروون نصف ذلك عن “نعيم القبر”؟!
وهكذا بلبلت عقيدتنا بـ”أحاديث” مخالفة لصريح القرآن الكريم ومبادئ العقيدة. وإن جأرت بذلك انبروا باتهامك بإنكار السنة.
أفيقوا آيها المسلمون وحاذروا، فعقيدتكم على شفا جرف هار.
ورمضان كريم
١٣ رمضان ١٤٣٥
سئمتُ
لقد سئمت الكتابة، مللت رصف الكلمات، وضجرت من يومياتي، وسط ما يلاقيه شعبنا في غزة: رجاله ونساؤه وأطفاله، من قتل وإصابات وهدم وتدمير من إسرائيل، وما يلقاه من إخوانه في العالم الذي كان يعرف فيما مضى بالعربي.
سئمت الفرقة والطائفية والقبلية التي قصمت ظهورنا، فأصبحنا يتهم بعضنا بعضا، ويقاتل بعضنا بعضا، باسم ديانة ليست سماوية، وتمسحا بالديمقراطية ونتائجها.
سئمت تصريحات دول وزعماء باردة باهتة لا نفع وراءها، والسكوت عنها من ذهب.
حكومة دولة كانت قبل عقود كبرى تقول إنها ”ترفض التصعيد الإسرائيلي غير المسؤول“، مهينة ومذلة بذلك مكانة الدولة التي تتحدث باسمها وكيانها بهذا التصريح.
وتعاقب تلك الحكومة شعبا برمته فتغلق أمامه أبواب متنفس قد يكون شريان حياة له، لأنها تتخذ موقفا من إحدى حركاته.
سئمت منا، ومن غبائنا.
لقد خططت إسرائيل وأفلحت.
هاجت إسرائيل وماجت بعد توقيع اتفاق الوحدة بين الفلسطينيين، وتوعدت بإفشاله ودبرت.
دبرت عملية قالت إنها ”خطف“ لثلاثة من مستعمريها في واحدة من مستعمراتها داخل فلسطين. وبلعنا نحن الطعم.
ثم اتهمت حماس بالـ”الخطف“، وبلع بعضنا الطعم.
وخطف بعض مستعمريها صبيا فلسطينيا بريئا، وأحرقوه حيا، وقتلوه، لكن إسرئيل لا تريد لهذا الحدث أن يجبرها على تغييرها مسار خططها وعزمها، فأصدر ساساتها تصريحات لاسترضاء العالم، يستنكرون فيها ما حدث، ثم عادت إلى ما خطط له.
وحان موعد العقاب، فبدأت غاراتها على غزة،
فنسينا محمد أبوخضير، وبلعنا الطعم.
وخرجت إلى العالم تقول إنها ترد على إطلاق صواريخ حماس، وبلعت بعض وسائل الإعلام الطعم.
وما زالت ترعب الفلسطينيين ببدء اجتياح بري، وتصر على استكمال خططها، دونما أدنى اهتمام بالقانون أو العالم.
والعالم الذي يغط في غيبوبة، يفشل حتى في إصدار بيان في مجلسه الدولي.
وربما يكون اتفاق الوحدة بين الفلسطينيين يلفظ أنفاسه،
وبهذا تكون إسرائيل قد أفلحت في التدبير، وقد تكون أفلحت في التنفيذ.
يا أيها الموتى بلا موت،
تعبت من الحياة بلا حياة،
وتعبت من صمتي
ومن صوتي
تعبت من الرواية والرواةِ،
ومن الجناية والجناة،
ومن المحاكم والقضاة،
وسئمت تكليس القبور،
وسئمت تبذير الجياع
على الأضاحي والنذور”
“سميح القاسم”
ورمضان كريم
١٤ رمضان ١٤٣٥
”حديث“ ونهج فكري
يثير تعجبي دوما ”حديث“ ينسب للنبي محمد عليه السلام، ويردده كثير منا عقب الأذان، يقول: ”من قال حين يسمعُ النداءَ: اللهمَّ ربَّ هذه الدعوةِ التامةِ، والصلاةِ القائمةِ، آتِ محمدًا الوسيلةَ والفضيلةَ، وابعثْه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلَّت له شفاعتي يومَ القيامةِ“.
ووجه العجب في الحديث لدي هو عبارة ”وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته“. إذ إن كلمة ”مقام“ نكرة، ولا يمكن أن توصف النكرة بـ”الذي“، وهي اسم موصول، معرفة.
ولا أظن أبدا أن نبينا الكريم – الذي نقل عنه أنه قال ”أنا أفصح العرب، بيد أني من قريش“ – يقول كلاما فيه مثل هذا الخطأ اللغوي. ولكن لماذا بقي الحديث يروى، وتورده كتب الأحاديث – ومنها البخاري الذي يعده كثير من المسلمين أصح الكتب بعد القرآن الكريم – دون أن يصحح؟
وهنا لب القضية التي أود التركيز عليها، وهي الصراع بين ”القدسية“ وقواعد العقل، أو قواعد المنطق، أو حتى قواعد اللغة.
إذ إن نهج كثير منا – نحن العرب والمسلمين – أن نسبغ القدسية على ما روي في كتب الحديث، دون إعمال عقل، أو تدبر، لسبب واحد وهو أنه روي في كتب الحديث التي نضفي عليها قدسية كبيرة، وننحو غالبا إلى تصديق ما جاء فيها، حتى وإن خالف عقولنا.
فنحن أمة تربت على الثقافة السمعية، روى أجدادنا الشعر، وكان منهم رواة له، ونقل إلينا الحديث بالرواية، ومازلنا حتى يومنا هذا نعتد بالمرويات في جدالنا ومناقشاتنا دون تحقق أو تدقيق. فكم من متحدث يحدثك بأنه قرأ كذا وكذا، وتميل إلى تصديقه دون تشكك أو مساءلة.
كما أنا نميل إلى احترام السلف وما خلفوه، بل نقدسهم ونقدس نتاجهم، إذا كانوا من الرعيل الأول في تاريخنا.
ونربي أولادنا في دروس تعلم مهارة الكتابة – التي نسميها ”الإنشاء، أو التعبير“، على الاقتباس من الشعر والحديث والأقوال المأثورة، لدعم أفكارهم، ونوال الإعجاب.
ووسط هذا كله لا نعير العقل اهتماما، إن لم يستهجن بعضنا – بل كثير منا – استخدام العقل مع ”النص“، ومن هذا ”النص“ الأحاديث.
ولذلك ظللنا نروي هذا الحديث الذي ذكرته، بما فيه من خطأ، وما فيه من مخالفة لقاعدة من قواعد اللغة، وما فيه من تناقض للقول الآخر المنسوب للنبي ”أنا أفصح العرب“.
وأنا أعلم أن هناك من سينبري للدفاع عن الحديث بشتى الحجج. وسيسعى بعضهم إلى تأويل استخدام الاسم الموصول – أي الذي في الحديث – صفةً لكلمة نكرة.
ومسلك هؤلاء من أسف يؤكد حقيقة منهجنا الفكري في التعامل مع ”الأحاديث“، عندما تتعارض مع أي نص آخر، حتى القرآن الكريم، أو تتعارض مع أي قاعدة من قواعد المنطق أو اللغة. إذ ننحو دائما إلى الدفاع عن ”الأحاديث“، وبذل الجهد لقبولها وتقبل محتواها، ورفض ما يتعارض معها. وهذا منهج ذو خطر شديد على حياتنا.
ومن هذا الباب دخلت إلى ثقافتنا أفكار كثيرة خاطئة، وآفات عديدة، لا أحسب أنه من السهل التخلص منها.
وهذا مثال واحد فقط أردت أن أضربه لكم للضرر الذي يصيبنا من باب ”الحديث“.
وللحديث بقية
ورمضان كريم
١٥ رمضان ١٤٣٥
كأس العالم وكأس العرب
مع فوز الفريق الألماني بكأس العالم لكرة القدم لم أستطع الفكاك من التفكير في حالنا نحن العرب.
تمتع الفريق الألماني طوال مبارايات دورة البرازيل باللعب فريقا واحدا، وليس أحد عشر لاعبا يتميز كل منهم بمهارات عالية. وأحسن اللاعبون التخطيط في اللعب، وبرعوا في توزيع الكرة، خاصة في منطقة الخصم – عندما كانوا يقتربون منها – بطريقة قد لا يتوقعها الفريق المنافس، فخلقوا فرصا للتسديد نجحوا في كثير منها.
هدفُ الفريق واضح، وهو تسديد الكرة في شباك الفريق المنافس، والفوز بالمباراة، ولا تطيح برؤوس لاعبيه غواية الانفراد بتسجيل الهدف دون الآخرين، ولذلك نجحوا.
أما نحن – بني العرب – فقلوبنا شتى.
أغارت إسرائيل على غزة، وما زالت تقصف البيوت والمباني، وتقتل الفلسطينيين: أطفالهم، ونساءهم ، ورجالهم، وأسرا كاملة، دون أن يتحرك أي لاعب من الفريق العربي، كبيرهم وصغيرهم، ومؤسساتهم وحكوماتهم ومنظماتهم، وكأن الأمر لا يعنيهم، وكأنهم مغيبو الوعي، كما كان حال فريق البرازيل في مباراته مع ألمانيا.
بل أخذ بعض جمهوره في حديث يفت في عضد الفلسطينيين، في شماتة بشعة، لا تصدر إلا عن جاهل قصير النظر، لا يدري أنه إن قُتل شقيقه يوما، فسيكون هذا بعينه مصيره يوما آخر.
أين هم لاعبو الفريق العربي؟ بل هل لا يزال هناك فريق عربي؟
لا أظن أن ثمة للعرب فريقا واحدا، فقد تشتت لاعبوه وتفرقوا. بل أصبحوا يلعبون منفردين اثنين وعشرين لاعبا، أو ثلاثة وعشرين، كل في ركنه.
اللاعبون في الاتحاد المغاربي شتتتهم الفرقة، وانفرط عقد الاتحاد، وأصبح كل لاعب يلعب منفردا على الساحة الدولية، وقد يتحالف في لعبه مع من يعادي اللاعبين الآخرين في الاتحاد المنفرط.
وهذا هو أيضا حال أعضاء مجلس التعاون الخليجي، إذ أدى الخلاف بين أعضائه إلى انفراد بعضهم بقرارات سخط عليها الآخرون. وما زال في المجلس من يتصرف وكأنه هو الزعيم الذي يجب أن يطاع، يُقْدم فيتبعه بقية الأعضاء.
وتفتتت دول وانقسمت، وقصم ظهر أخرى، إما لطائفية مقيتة، أو قبلية، مهلكة، وإما لمطامع آنية مدمرة.
وانفرد الخصم باللعب داخل ساحتنا، فأخذ يعربد، ويفعل ما يريد، ولم تعد لنا سيطرة على الكرة، بل لم يعد لنا سيطرة على آمالنا وأحلامنا.
رحم الله العرب، فقد كانوا يوما أمة،
وهنيئا لبنيهم بكأس ”الذل“ العالمي.
ورمضان كريم
١٦ رمضان ١٤٣٥
”الإسلام“ كما عرفه المهاتما غاندي
مع زيادة انتشار الفكر الديني المتطرف في أرجاء العالم العربي والإسلامي، وحتى في أجزاء من دول الغرب، أتذكر كلمة كان الزعيم الهندي، داعية السلام، المهاتما غاندي، قد قالها معلقا على الإسلام، كما عرفه في عام ١٩٢٤، وأحسب أن لها دلالات عميقة على ما نمر به هذه الأيام.
يقول غاندي:
”لقد أصبحت مقتنعا أكثر من ذي قبل، بأن السيف لم يكن هو الوسيلة التي حقق بها الإسلام مكانه هذه الأيام في رسم مخططات الحياة. وإنما البساطة الشديدة، وتفاني الذات المطلق للنبي، والالتزام الصارم بتعهداته، وتكريسه الشديد لحياته لأصدقائه وأتباعه، وإقدامه، وعدم خوفه، وثقته المطلقة في الله، وفي مهمته. هذا هو – وليس السيف – ما حمل كل شيء قدما، وتجاوز كل الصعاب“.
وهذه شهادة رجل غير مسلم عن الإسلام في عشرينيات القرن الماضي.
ولو كُتب لغاندي أن يُبعث من جديد ليرى بني الإسلام اليوم، فما عساه يقول؟
ماذا سيقول غاندي عن الإسلام، لو رأي بعضا من شيوخه وفي ربوع الإسلام المقدسة، يكرسون الطائفية، ويدعون شبابه إلى ”الجهاد“، وأي جهاد؟ جهاد أبناء دينهم، وأبناء أوطانهم، الذين دُعوا أصلا إلى الصلح بينهم إن اقتتلت منهم طوائف.
ماذا سيقول غاندي عن الإسلام، لو رأي طوائفه اليوم، تكفر إحداها الأخرى، بل تعتبر كل منها الأخرى العدو اللدود، الذي تفوق عداوته عداوة أعداء الأمة الحقيقيين. فلا يقبلون مع بعضهم تفاوضا، يهرولون إليه بلا جدوى مع إسرائيل.
ماذا سيقول غاندي عن الإسلام، لو رأى ما ترتكبه تنظيمات – تُنسب زورا إلى الإسلام – بالسيف والسكين والبنادق والمسدسات والصَلب من ذبح وقتل ومجازر.
أي إسلام هذا الذي يرفع هؤلاء عقيرتهم به؟
هل هو إسلام العمامات السوداء؟ والرايات السود؟ واللحى والجلابيب؟
هذا ليس إسلامنا، الذي عرفناه في قرآننا العظيم، وقرأنا عنه في مسلك نبينا الكريم، وصحبه المخلصين.
وليس هذا هو الإسلام الذي عرفه غاندي في عشرينيات القرن الماضي.
ورمضان كريم
١٧ رمضان ١٤٣٥
الكلاب ليست نجسا
في هذه اليومية أعود إلى ما بدأته في يوميات سابقة عن عدم تدبرنا القرآن الكريم، والتعويل في فكرنا – بل حتى في عقيدتنا – على ”أحاديث“ ظنية. وهنا سأقدم مثالا واحدا فقط، وهو قضية الكلاب.
من مكارم الأخلاق حسن المعاملة حتى مع الحيوان. ومن المرويات في ذلك أنه ”بينما رجل يمشي بطريق اشتدَّ عليه العطش، فوجد بئرًا، فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ منِّي، فنزل البئر فملأ خُفَّه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له“، وسأل بعض الصحابة النبي الكريم عليه السلام، يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر.
أما عدم الرفق بالحيوان فجزاؤه عظيم، فمما روي أيضا ”دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض“.
في الوقت الذي تحض فيه هذه المرويات على الرفق بالحيوان نجد في أحاديث أخرى موقفا آخر مناقضا لهذا، خاصة إزاء الكلاب، التي لها ذكر رفيع في الشعر الجاهلي، وكان لها مكانة في حياة العرب.
فمما نسبه أبو هريرة للنبي عليه السلام قوله ”مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ“.
وفي حديث آخر ”أنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ“.
وهناك كثير من الأحاديث تحض على قتل الكلاب بدعوى أنَّ الملائكة – ومنهم جبريل – لا تدخل بيتًا فيه كلب.
والأفدح من ذلك ما يروى من أحاديث تساوي بين المرأة والكلب:
فقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية السابق – رحمه الله – ”لقد سمعنا منكم إذا مر كلب أو حمار أو امرأة أمام المصلي تبطل الصلاة فما هي المسافة التي تمر فيها هذه الأشياء؟ وهل إذا كانت هذه المرأة من المحارم أيضا تبطل الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله؟
فكان جوابه: ”ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع صلاة الرجل – إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل – المرأة، والحمار، والكلب الأسود.
هل لاحظتم أن الأمر المهم لدى طارح السؤال هو مقدار المسافة بين المصلي ومن يمر أمامه، وكأن كل شيء آخر في هذا الحديث المفترى – الذي يعلم إلا الله وحده مدى صحته – مقبول.
ومع هذا التناقض الذي لاحظناه بين الأحاديث السابقة إزاء الكلاب، نتساءل: هل الكلاب نجس؟
ماذا يقول القرآن الكريم:
لقد ورد ذكر الكلب في القرآن خمس مرات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. أهمها موضعان:
الأول في سورة الكهف:
”وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ“ (آية ١٨).
وأصحاب الكهف كما ورد في القرآن فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، وهم عندما دخلوا إلى الكهف ليحتموا من قومهم كان معهم كلبهم، فكيف يحرص فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى على اصطحاب الكلب وهو حيوان نجس، كما جاء في مرويات أبي هريرة؟
هل لم يكن الكلب آنذاك نجسا؟ وهل حلت النجاسة بالكلاب فقط مع بداية الإسلام؟
والموضع الثاني المهم الذي ورد فيه ذكر الكلب هو سورة المائدة:
”يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ“ (آية 4).
وقوله تعالى ”وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ“ أي: ما اصطدتموه بالجوارح، وهي الكلاب والصقور وأشباه ذلك.
فإن كان الكلب نجسا، فكيف يحل للمسلم – بنص القرآن الكريم – أكل ما اصطاده؟
فهل ندع بعد ذلك إرشادات ربنا تعالى في هذه الآيات الواضحة الجلية من أجل بضعة مرويات ظنية لا نعلم مدى صحتها، رواها راو لم يكن محبا للكلاب، بل كان مولعا بالقطط، ولهذا لقب بأبي هريرة.
ورمضان كريم.
١٨ رمضان ١٤٣٥
”الحوار“ القرآني
ثمة مشكلات كثيرة تعرضنا لها في وطننا العربي، وفي العالم الإسلامي، كان يمكن أن تحل لو اتبعنا هدي القرآن الكريم.
وليس هذا كلاما إنشائيا تقليديا، من قبيل ما يتردد على منابر بعض المساجد أحيانا، وعبر بعض الفضائيات أحيانا من أحاديث مرصوصة ليس وراءها فكرة ترتجى.
فنحن – كما أكرر دوما – لم نَغفل فقط عن نتدبر آي القرآن الكريم عندما نقرأه، بل أقلعنا عن هديه الكفيل بإصلاح جوانب حياتنا.
من يقرأ الكتاب الكريم من أوله إلى آخره يلحظ ملمحا مهما جدا فيه. هذا الملمح هو ”الحوار“.
والذي أعنيه هنا هو الشكل الأدبي الفني الموجود في قصص القرآن الكريم، وهو ”الحوار“ الذي يدور بين شخصيات القصة. وقصص القرآن هي جزء من نسيج الكتاب الكريم ذاته، وليست منفصلة عنه، في سورة، أو بعض سور، مثل سورة ”يوسف“، وسورة الأنبياء، وغيرهما.
وربما يفهم بعضنا ضرورة استخدام ”الحوار“ في القصص التي يقصها الكتاب الكريم على النبي عليه السلام، وعلى قارئي القرآن في عصره ومن بعد عصره، بأنه ضرورة ”فنية“ يقتضيها السرد القصصي ذاته، سواء في القرآن أم في غير القرآن.
لكنني أزعم أن ”الحوار“ في الكتاب العظيم، مقصود لذاته، سبيلا للتفاهم بين الناس، ومَعْبرا للتوصل إلى حل لمشكلاتهم، وهذا – في رأيي – هو الدرس المستفاد من استخدامه في القرآن الكريم.
لقد حاور رب العزة سبحانه وتعالى إبليس، الذي تكبر وخرج عن طاعة أوامره، ولم يأمر بنفيه، أو قتله، أو تعذيبه، وإن حدث ذلك فإنه لم يقع إلا بعد ”حوار“.
وحاور الله تعالى الملائكة قبل أن يخلق آدم، ومن بعد خلقه، ولم يكن – جل شأنه – مضطرا إلى ذلك، لكنه النهج الذي يريد القرآن تربيتنا عليه.
وحاور الله الأنبياء، آدم، ونوحا، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد، وغيرهم.
وحاور الأنبياء أهليهم وأقوامهم، كما فعل إبراهيم عليه السلام مع أبيه، ومع قومه.
ويكاد الكتاب الكريم لا تخلو صفحة فيه من ”الحوار“.
فهل فهمنا نحن الدرس؟ أم أننا نقرأ القرآن في صلواتنا دون وعي ودون انتباه، وفي غير صلواتنا من أجل ختمه، وبلا تدبر أو تمعن في الدروس والأهداف.
إن نهجنا جله اليوم مخالف تماما لروح التفاهم التي يرشدنا إليها القرآن الكريم من خلال استخدام أسلوب ”الحوار“ فيه. نهجنا اليوم فظ، ويتسم بالتسلط، والإملاء، والإكراه. ولهذا أفضى إلى الفرقة، والقتل، والإقصاء، ولم يحل مشكلة حلا جذريا طويل الأمد.
وأنا أعلم أن كلمة ”حوار“ اليوم تستخدم على ألسنة بعض شبابنا استخداما مختلفا تماما عما عنيته هنا، إذ تتردد على ألسنتهم بمعنى ”كلام“، فيقولون مثلا ”الحوار ده مش عجبني“.
وأرجو ألا يكون ”حواري“ هذا عن ”الحوار“ طاردا لهم.
ورمضان كريم
١٩ رمضان ١٤٣٥
تساؤلات عن ”الحجاب“
مواصلة لدعوتي إلى تدبر القرآن الكريم أود هنا أن أطرح اليوم تساؤلات، مجرد تساؤلات، أبحث لها عن إجابات بشأن موضوع ”الحجاب“ الذي شُغلنا به، ومازلنا، رغم أنه – في رأيي، ولا يغضبنّ أحد من كلامي – أمر شكلي، اختصرنا فيه – في غير حكمة – الإسلام كله.
١- لماذا يحاول بعضنا فرض توجهه على أمة المسلمين، بأن الحجاب ”فرض“، ونحن نعرف منذ أن ولدنا وترعرنا، أن فروض الإسلام خمسة: الشهادة، والصلاة، والصوم، والزكاة، والحج.
٢- ولو كان توجههم صحيحا، فكيف نحكم على أجيال المسلمين منذ بداية الدعوة وحتى سبعينيات القرن الماضي، الذين قصروا فروض الإسلام في خمس؟ هل كان إيمانهم منقوصا؟ وما مصيرهم؟ ومن بينهم آبائي وأجدادي، وحتى آباء تلك الثلة من المسلمين التي تحاول فرض توجهها، وأجدادها. هل سيكون مآلهم جهنم؟
٣- لماذا لا يفهم أصحاب هذا التوجه – المؤيدون للحجاب – من كلمة ”الزينة“ في القرآن الكريم، إلا ”الشَعر“؟ وكيف نفسر آيات مثل: الآية الموجهة إلى كل المسلمين عند الذهاب إلى المساجد، ”خذوا زينتكم عند كل مسجد“، والآية التي ذكر فيها قارون ”فخرج على قومه في زينته“، فهل نأخذ شعرنا أو نزينه عند الذهاب إلى المسجد؟ وهل خرج قارون على قومه، متفاخرا متباهيا بشعره؟
٤- ولماذا خص الله تعالى المرأة وحدها – بحسب هذا التوجه الأيدولوجي – بـ”فرض“ الحجاب، مع أنه جل شأنه ساوى بين الرجال والنساء في جميع الفروض الأخرى؟
٥- وإذا كان ”الحجاب“ ”فرضا“ – كما يزعمون – فلماذا لم يفرض على الإماء في الإسلام، وفرض فقط – بحسب كلام الفقهاء طبعا وتفسيراتهم المضللة – على الحرائر من النساء؟ وهل الإسلام دين عبودية يُفرق فيه بين سيد وعبد؟
في انتظار إجابات تحترم عقولنا، ولا تصد الباب بالمقولة المشهورة ”لا اجتهاد مع النص“. ولنفتح صدورنا وعقولنا للحوار، الذي لا يسعى إلا إلى الحقيقة، قدر المستطاع، دون تجريح أو إساءة أو سب.
ورمضان كريم
٢٠ رمضان ١٤٣٥
”دين“ أو ”أديان“
من يقرأ القرآن الكريم ويتدبر آياته يدرك أن الكتاب الكريم لا يستخدم إلا كلمة ”دين“، بصيغة المفرد، ولا يستخدم ”أديان“ بصيغة الجمع.
وهذا أمر منطقي، إذ إن ”الدين“ واحد، لأنه صادر عن نبع واحد. بيد أن الشرائع التي تنزّل على كل رسول أو نبي، مختلفة بحسب البيئة والزمان وحاجات كل قوم يرسل فيهم الرسول أو النبي.
فشريعة موسى عليه السلام، تختلف عن شريعة عيسى عليه السلام، وعن شريعة شعيب، ونوح، وشريعة محمد عليه السلام. لكنهم جميعا جاءوا بدين واحد.
وأهم خصائص هذا الدين هي وحدانية الله تعالى، والإيمان بالبعث يوم القيامة، والحساب، وإسلام الوجه لله سبحانه.
ولذلك فالخطاب القرآني لا يعرف ”تعدد الأديان، أو الديانات“، بل يتحدث عن دين واحد.
هذا الدين يسميه القرآن ”الإسلام“. والإسلام في الخطاب القرآني هو الدين الذي أنزل على نوح، وإبراهيم، ويعقوب، وموسى، وعيسى، ومحمد، وبقية رسل الله تعالى وأنبيائه.
وفي ضوء من هذا الخطاب، يمكن أن نفهم المقصود من قول الله تعالى ”إن الدين عند الله الإسلام“، و قوله ”ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه“. إذ ليس المقصود من هاتين الآيتين الشريعة التي نزلت على محمد عليه السلام فحسب، كما يحلو للمسلمين، من أتباع النبي، ترداده دوما، بل الدين الواحد الذي أنزل على الرسل والأنبياء جميعا، منذ بدء الخليقة وحتى خاتم الأنبياء.
فلا مجال إذن للمسلمين اليوم للتفاخر بأن ”دينهم“ هو الدين ”المختار“، أو هو ”الدين“ الوحيد الذي يقبله الله سبحانه. فهذا أيضا هو الدين الذي أنزل على إبراهيم، وموسى، وعيسى.
ولهذا أقول إن هناك مسلما يهوديا، ومسلما نصرانيا، ومسلما محمديا.
وهذه دعوة إلى التصالح بين تلك الشرائع لأنها صدرت عن نبع واحد. وتلك هي الدعوة التي ينبغي أن نتبناها، وليس دعوة التصالح، أو ”الحوار“ بين الأديان. فليس ثمة حوار إلا بين الشرائع.
ولا مبرر أبدا للاختلاف أو الخلاف مع أبناء الشرائع الأخرى، فنحن مأمورون بالتعايش معا، ولنترك الخلاف العقدي لله تعالى يحكم فيه يوم القيامة، كما أرشدنا، جل وعلا.
ورمضان كريم
٢١ رمضان ١٤٣٥
جهارة الصوت وحقوق الحمير
لفت انتباهي وأنا أقرأ في سورة ”لقمان“ من بين توجيهاته لابنه في الآية ١٩ قوله تعالى ”واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير“.
وهنا – من وجهة نظري – نقطتان جديرتان بالبحث، في هذا الجزء الأخير من الآية ”اغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير“:
١- جهارة الصوت (Sound Volume)، والمقصود بهذا ارتفاع الصوت وانخفاضه خلال الحديث.
تشير دراسات علم الأصوات اللغوية الحديثة في هذا الصدد إلى أن جهارة الصوت أمر مرتبط بالثقافة. ففي بعض الثقافات يميل المتحدثون إلى استخدام درجة منخفضة من الجهارة في كلامهم، كالإنجليز على سبيل المثال. وفي ثقافات شعوب أخرى كالعرب واليونان -مثلا- ينحو المتكلمون منحى آخر فيستخدمون درجة أكثر ارتفاعا من الجهارة.
هذه الدرجة لفتت انتباهي غير مرة خلال رحلتي اليومية بالأتوبيس العام في لندن حينما كنت أدرك عن طريق أذني فقط أن بالأتوبيس ركابا عربا من خلال ارتفاع أصواتهم ودون أن أراهم.
هذه الدرجة العالية من جهارة الصوت تدهشني لأن أرض العرب كانت مهبط الديانات وأنا أزعم أن الديانات جميعا تحث على استخدم الصوت الخفيض، والآية ١٩ من سورة لقمان في القرآن الكريم تتضمن مثل هذا التوجيه. وفي سورة الحجرات توجيه مماثل في الآية ٣ ”إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ….“.
وفي الأية السابقة عليها آية رقم ٢ نهي عن رفع الصوت ”لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ….“. والصوت الخفيض -أيضا- من سمات الخشوع، يقول الله تعالى في سورة طه في الآية ١٠٨ واصفا لمشهد من مشاهد يوم القيامة ”وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا“.
على الرغم من هذا التوجيه الصريح فإن طابع الثقافة البدوية التي تتسم فيها الأماكن بالرحابة والاتساع وتتصف فيها الحياة بالترحال والتنقل على ظهور الإبل ويتميز في غنائها حداء الأبل هو الذي ساد وتغلب حتى أصبحت جهارة الصوت ارتفاعا أمرا يمتاز به معظم العرب في كلامهم.
٢- أصوات الحمير، النقطة الثانية تتركز على الجزء الأخير من الآية ”إن أنكر الأصوات لصوت الحمير“.
قد يتوهم بعض قارئي الآية أن في هذا الجزء منها استهجانا لصوت الحمير، ولكن هل يمكن لله تعالى – وهو خالق كل شيء: البشر والدواب والبغال والحمير …. إلخ – أن يصف أيا من خلقه بالقبح والإنكار؟
المقصود من هذا الجزء من الآية هو استهجان درجة جهارة الصوت المرتفعة زيادة عن الحد، وهذه هي الدرجة التي يُعرَف بها صوت الحمير الفطري.
هناك إذن سمة جامعة بين صوت الحمير وبني البشر ممن لا يغضون أصواتهم في الكلام وهي تلك الدرجة العالية من الجهارة في الكلام.
والحمير – وحقوقها هنا محفوظة فلا إغماط لها – لا تُلام على استخدام تلك الدرجة من الجهارة لأنها فطرة فيها. أما بنو البشر الذين خُلقوا في أحسن تقويم فلا ينبغي لهم رفع الصوت لأن في رفعه إيذاء ماديا لأذن السامع، وربما أيضا إيذاء معنويا لمشاعر السامع.
ورمضان كريم
٢٩ رمضان ١٤٣٥
مدافع غزة
لقد أصبحت وأضحت وأمست وباتت مدافع غزة أعلى من مدافع الإفطار والإمساك في رمضان. لكن يبدو أن في مصر – ممن بهم صمم – من لا يسمعها، بل يسعى إلى سد آذانه عنها وآذان العالم من حوله، بزعاق ينهش به جلد فلسطين، وهي تقاوم الغول، بلا هوادة.
آه يا مصر، كم أحس بألمك، وكم أسمع أناتك، وكم أرى من أسى في عينيك، من بعض أبنائك الأغرار، الذين نسوا تاريخك، وأهانوا هيبتك، ولطخوا اسمك في تراب عزلة قميئة سقيمة.
أين هؤلاء الأغرار العمي من شاعرك العظيم على محمود طه الذي صرخ في رائعته (أخي جاوز الظلمون المدى):
أَخِي، إِنَّ فِي القُدْسِ أُخْتَاً لَـــــنَــا أَعَـــدَّ لَهَا الذَّابِـحُونَ المُــدَى
صَبَرْنَا عَلَى غَـدْرِهِمْ قَــــادِرِيـنَ وَكُنَّا لَهُمْ قَــــــــدَرَاً مُرْصَــدَا
طَلَعْنَا عَلَيْهِمْ طُلُـــــــوعَ المَنُــونِ فَطَارُوا هَبَاءً، وَصَارُوا سُدَى
أَخِي، قُمْ إِلِى قِبْلَةِ المَشْرِقَــيْـــــن ِ لِنَحْمِي الكَــنِيسَةَ وَالمَسْجِـدَا
يـسوع الشهيــــد على ارضـــها يعانق، في جـيــشه، احمدا
أَخِي، قُمْ إِلَيْهَا نَـشُـقُّ الـغِمَـــــارَ دَمَاً قَـانِيَاً وَلَـظَىً مُـــــرْعِــدَا
وأين هؤلاء الأغرار من ابنك جمال عبد الناصر، الذي حارب في أرض الشقيقة، والذي قال مرة قبل عدوان ١٩٥٦ وهو يزور غزة:
”إننى أطلب منكم – يا أهل غزة – ثلاثة أشياء: الأمل، والصبر، والإيمان، إن الأمل والصبر والإيمان هى طريقنا إلى الانتصار على جميع القوى التى تتآمر ضدنا. وإننى أريدكم أن تعرفوا حقيقة هامة وهى أن نظرتى إلى غزة هى نظرتى إلى مصر، وما يصيب غزة يصيب مصر، وما يوجه إلى غزة يوجه إلى مصر“.
لا تجزعي يا مصر فهكذا كان أولادك، بيد أن الحال تبدل غير الحال، واستطاع الغول أن يشق الصف. وماتت مفاهيم وحلت محلها مفاهيم: ماتت ”القومية العربية“، ومات ”الوطن العربي“، وحل محلها ” بلدي أولا“ و”الشرق الأوسط“، و”الشرق الأوسط الجديد“، ليتوغل الغول بيننا وينسل فلا نشعر، لأنا فتحنا له أبوابنا على مصارعيها.
لكن أبناءك الشرفاء يا مصر مخلدون ولا يموتون، مهما علت أصوات الزاعقين يوما أو بعض يوم.
وأصغ يا مصر إلى صوت ابنك البار، أمل دنقل الذي رفض التصالح، وبث فينا من جديد روح المقاومة.
”لا تصالح على الدم .. حتى بدم !
لا تصالح ! ولو قيل رأس برأسٍ
أكلُّ الرؤوس سواءٌ ؟
أقلب الغريب كقلب أخيك ؟!
أعيناه عينا أخيك ؟!
وهل تتساوى يدٌ .. سيفها كان لك
بيدٍ سيفها أثْكَلك ؟
سيقولون :
جئناك كي تحقن الدم ..
جئناك . كن – يا أمير – الحكم
سيقولون :
ها نحن أبناء عم.
قل لهم : إنهم لم يراعوا العمومة فيمن هلك“.
وليهنأ ابنك الذي عاد فارتمى إلى أحضانك، يقبل ترابك الزكي، فقد تحدث وكفاك وكفانا الكلام، إنه ولدك أحمد فؤاد نجم، في ”غنوة لغزة“، التي كتبها في ٢٠٠٨.
”شى لله يا الغزاوية
يا وجع الأمة العربية
لا انتو حماس
و لا عباس
فلسطين..هي القضية
شى لله يا الغزاوية
شى لله و على دلعونا
حكمونا ولاد الملعونة
والآخر خانم و باعونا
للنخاس والصهيونية
شى لله يا الغزاوية
شى لله وانتوا لوحديكو
الله ينصركو ويهديكو
ويدمر دولة أعاديكو
والأيام أهي رايحة وجاية
شى لله يا الغزاوية
شى لله ولا عادش رجوع
ويالخاين والجربوع
الأطفال ماتت م الجوع
والعطشان مش لاقى الميه
شى لله يا الغزاوية
شى لله على أحلى كلام
ناس تصحى
والأمة تنام
يعنى قفاك يصبح قدام
يا العربى
وتركب عربية
شى لله يا الغزاوية“
لا تجزعي يا مصر، فأبناؤك الشرفاء لا يموتون، أما الزاعقون فسيخرسون ولو بعد حين.
ورمضان كريم
يوميات صائم (أنهى صيامه)
١ شوال ١٤٣٥
مشهد
المشهد يبدو بعيدا، والرؤية غير واضحة، لكنني متأكد مما أرى، ومن أرى.
إنها أمي، تقف هناك، لكنها تبدو مشغولة في إعداد حقيبة. ملامح وجهها وقوامها هي هي كما أعرفها أيام الصبا. ولفت نظري أنها تلبس ثوبا أبيض جميلا، وأنا لا أذكر أنني رأيتها في ثياب بيض، فهي لم تعد تلبس إلا الأسود، بعد وفاة والدي، ثم لم تخلعه بعد ذلك، ربما حفاظا على شيء من الوقار، الذي كانت دوما تتدثر به.
لم تكن أمي تقف وحيدة، بل كانت معها أختي الكبرى وأختي الوسطى. شابتان نضرتان، لا تبدو عليهما إلا أمارات الصبا، ورونقه ونعومته. والغريب أن أختيّ تلبسان أيضا فستانين من القماش نفسه الذي تلبسه أمي. وهذه هي عادة أمي، ألا تختص نفسها بشيء، بل تود دوما مشاركة بناتها وأولادها كلهم فيه. إنهما منهمكتان مع أمي فيما تعد، تروحان وتجيئان وهما فرحتان مبتسمتان.
الأمر الغريب الذي يدهشني، لا أمي، ولا أختاي يلتفتان إليّ، وكأنهن لا يرينني.
– أمي .. أمي،
ناديت عليها، لكن يبدو أنها لا تسمعني.
وعاودت توجيه النداء إلى أختيّ، لكنهما أيضا – فيما يظهر – لا تسمعانني.
ولكن لماذا يقفن هناك؟ وهل هذه هي ردهة بيتنا؟
الوقت فيما يبدو هو عند ميلاد الفجر، إذ لا تلوح تباشير الضوء بعدُ فضّاحة، بل تنسل منها خيوط بيضاء رقيقة تتولى كل واحدة منها سَحبَ خيوط الظلمة لتخيم مكانها.
ولذلك لم أستطع بالضبط تحديد المكان الذي يقفن فيه. لكنه – مع ذلك – لا يبدو غريبا عليّ.
– يا …، ناوليني هذه العصا.
نادت أمي على أختي الكبرى، التي اتجهت إلى خزانة أبي، وفتحتها ثم تناولت منها عصا أبي العاج التي تشع بريقا، كما هي دوما.
– ولكن لماذا العصا يا أمي؟
سألت أختي الوسطى، فاطمة.
– أبوك طلبها، فهو لا يحب أن تفارقه، وقد نسيها، حين سبقنا إلى هناك.
كنت دائما عندما أرى أبي، أعرف أنني سأرى العصا إلى جانبه، كانا متلازمين في كل حل، وفي كل رحلة. أما في المرة الأخيرة، فلا أدري لماذا تركها، وغادر البيت بدونها.
هدأت الحركة قليلا، ثم وقفت أمي برهة، والتفتت نحوي. عيناها مفعمتان بدفء وحنو وهدوء. وقسمات وجهها تنطق بسكينة، وترسم ابتسامة تبدو كأنها جزء من ملامح وجهها الأبيض الهادئ منذ عرفتها. وقالت:
– يا محمد، هيا، قم.
إنها تحدثني ! شعرت براحة ملأت أرجاء صدري بفرح طفولي، إذ انتبهت أمي إلى وجودي، والتفت إليّ، وتوجهت إليّ بالحديث.
– لكن، أين يا أمي؟ قلت لها.
ويبدو أنها لم تسمعني، فقد التفتت إلى أختي الكبرى، وقالت لها:
– يا …، جهزي ملابس محمد بسرعة حتى يأتي معنا.
– هل سنأخذه معنا يا أمي؟
سألت آمال في شيء من الدهشة.
– نعم، كيف نتركه ورحلتنا قد تستغرق فترة؟
– أمي، إلى أين نحن ذاهبات؟
سألت أختي في تخابث مبدية علامات دهشة مصطنعة.
التفتت إليها أمي وقالت وهي تضحك:
– ألا تعرفين؟ أم أنك تستحين؟ نحن ذاهبات إلى غزة، لنجهز لك جهاز عرسك.
لماذا تسأل أختي هذا السؤال؟ كدت أتضايق من سؤالها. فكيف يتركونني وحدي هنا؟ أبي فيما يبدو سافر، ولا أرى أخي ولا أختي الصغرى، وأنا الوحيد الموجود في البيت، فهل يعقل أن تسافر أمي وأختاي ويتركنني هنا؟
لكن أختي الكبرى، لا تأتي نحوي، لتلبسني ملابسي. ما زالت هناك في الردهة، تروح وتجيء، ولا تقترب تجاهي.
– يا أختي، يا أختي.
ولم تسمعني، فصرخت:
– أختي … ي .. ي .. ي !
فجأة أظلم المكان، ولم أعد أرى لا أمي ولا أختي الكبرى، ولا أختي الوسطى، ولا الردهة.
وسمعت صوتا آتيا من بعيد، يقترب شيئا فشيئا مني:
– محمد، باسم الله، محمد، استيقظ
– أختي؟ .. أختي؟
مالت زوجتي برأسها عليّ، ومسحت حبات عرق على جبيني. وقالت:
– أختك؟ هل أنت تحلم؟ اللهم اجعله خير.
– اللهم اجعله خير.